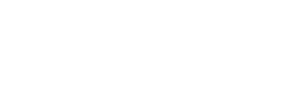تيري إيجلتون
ترجمة محمد خطابي
تقديم المترجم
تعد هذه الدراسة مدخل المؤلف الذي صدر سنة 1983 لصاحبه تيري إيجلتون، وعنوانه >مدخل إلى نظرية الأدب< ( منشورات بلاكويل، لندن). يتكون الكتاب من خمسة فصول هي على التوالي : 1) نهضةالأدب الانجليزي، 2) الظاهراتية والهرمينوطيقا ونظـرية التلقي، 3) البنيوية والســـميائيات، 4) ما بعــد البنيوية، 5) التحليل النفسي للأدب، ثم خاتمة عنوانها النقد السياسي. هو مؤلف ممتع ومفيد، ممتع لأن إيجلتون استعمل في كتابته لغة بسيطة على خلاف مؤلفاته السابقة، وكذا لأنه كتاب ذو طبيعة سجالية تخضع كل روافد نظرية الأدب المطروحة في الفصول الخمسة للمساءلة، ويقدم حججا مضادة تكشف الثغرات والعيوب من زاوية نظره. وهو مفيد لأنه يضع لكل رافد أرضية فلسفية وفكرية يتقاطع عندها الاجتماعي والتاريخي والمعرفي.
– شهدت نظرية الأدب الحديثة توسعا ملحوظا وثراء كبيرا من 1917 سنة نشر الشكلاني الروسي الشاب فيكتور شلوفسكي مقالته الرائدة >الفن باعتباره إجراء<.
– لحق تغير كبير مفاهيم مصطلحات من قبيل >الأدب< و>القراءة< و>النقد<، غير أن وقع هذه الثورة لم يتجاوز -حتى يومنا هذا- دوائر المختصين إلى التأثير في دارسي الأدب والقراء عامة.
– لهذين الاعتبارين وضع إيجلتون كتابه هذا سالكا فيه طريقة التبسيط لأنه موجه إلى من لم تسبق له معرفة بميدان نظرية الأدب، أو من يعرف نظرية الأدب معرفة مبهمة.
تلك مجمل النقط التي تضمنتها مقدمة الكتاب الذي نترجم منه هذا النص. وهي مقدمة بسيطة ووجيزة إلا أنها >خادعة<، ذلك أن قارئها قد يعرض عن الاطلاع على الكتاب ما دامت غايته القصوى لا تتعدى تقديم نظرية الأدب لنوعين من القراء، أولهما يجهلها لذا يرغب في معرفتها، والثاني يعرفها معرفة مشوشة وناقصة. وبعبارة موجزة نقول إن هذا الكتاب لا يعني المتخصصين.
لكني أدعوك إلى تأمل الفقرات اللاحقة المقتطفة من متن الكتاب حتى تدرك أن الأمر خلاف ما توحي به المقدمة. وأن التواضع الذي تمسك به إيجلتون في صياغتها من طينة لا يتسم به إلا من بلغ في العلم مبلغا.
1- >إن هي إلا أسطورة تلك الفكرة المدعية وجود أصناف من النقد “غير سياسية “، أسطورة تعزز استعمالات معينة للأدب تعزيزا فعالا. والفرق بين نقد أدبي”سياسي” ونقد أدبي ” غير سياسي” هو بالذات ذلك الفرق الموجود بين السلطان والوزير الأول؛ فالسلطان يعزز غايات سياسية معينة مدعيا العكس، أما الوزير الأول فلا يحرجه إعلان تلك الغايات. وفي مثل هذه الأمور من الأفضل أن يتصف الإنسان بالصدق. كما أن الفرق بين نقد أدبي تقليدي يتحدث عن “فوضى التجريب” في أعمال جوزيف كونراد وفرجينيا وولف والنقد الأدبي النسائي الذي يفحص صورة الجنس (الذكورة والأنوثة) في أعمالهما ما هو بالفرق بين نقد أدبي خال من السياسة ونقد سياسي. وإنما هو فرق بين أشكال مختلفة من السياسة، أي هو الفرق بين معتنقي مذهب يرى أن التاريخ والمجتمع والواقع البشري في شموليته يتصف بالجزئية والاعتباطية والتحرر من التوجيه وبين من لهم مصالح أخرى، أي أن لهم -ضمنيا- آراء مغايرة في الكيفية التي عليها العالم. لا توجد -في مجال النقد الأدبي- طريقة مثلى للإجابة عن سؤال ما هي السياسة الأفضل؟ وليس أمامك سوى المحاججة حول السياسة، وليس الأمر متعلقا بمناقشة ما إذا كان ينبغي الربط بين “الأدب” و”التاريخ” أم لا : إنه متعلق بقراءات مختلفة للتاريخ نفسه< (ص. 209 ).
2- >كل نظرية تعنى بالإنسان وقيمه ولغته وأحاسيسه وتجاربه لا محالة ملتزمة بقناعات شامـلة وعميقة تخص طبيعة الإنسان ومجتمعه ومشكلات السلطة والجنس (الذكورة والأنوثة) وتأويل التاريخ ماضيا وحاضرا وآمال المستقبل، ولا مجال للندم على كون واقع الحال هكذا، ولا لتقريع نظرية الأدب على كونها مشدودة إلى هذه المشكلات في مقابل نظرية أدب “خالصة” متحللة منها. ذلك أن نظرية الأدب “الخالصة” وهم أكاديمي لا غير : فالطبيعة الإيديولوجية لبعض نظريات الأدب التي عالجناها في كتابنا هذا أشد وضوحا من محاولاتها تجاهل التاريخ والسياسة معا. ولا ينبغي أن نوبخ نظريات الأدب بكونها سياسية، وإنما ينبغي توبيخ نظريات الأدب التي هي سياسية ومع ذلك لا تعي أنها كذلك أو تضع قناع اللاسياسة، لأن العمى الذي تبين عنه ، باعتبارها مذاهب “تقنية” و”بديهية في ذاتها” و”علمية” أو “كونية” حقة، يمكننا – بقليل من التفكير- من إدراك ارتباطه (وتعضيده ) بالمصالح الخاصة لمجموعات بعينها في زمن بعينه.<(ص. 195).
3- >أرى أن الأفيد هو النظر إلى “الأدب” إسما يطلقه الناس -لأسباب متعددة- من حين إلى آخر على أنواع معينة من الكتابة داخل حقل واسع سماه ميشيل فوكو “الممارسات الخطابية”. وإذا كان هناك من شيء يستحق الدرس فهو هذا الحقل الشامل من الممارسات، لا تلك الممارسات التي يلصق بها وحدها إسم “الأدب” على نحو غامض. إنني لا أواجه النظريات المطروقة هنا بنظرية الأدب، وإنما بنوع من الخطاب مختلف -ولنسمه ثقافة، أو “ممارسات دالة” أو ماشئت، فليس هذا هو مربط الفرس- يضم الموضوعات (الأدب) التي تعالجها تلك النظريات، لكن بعد إخضاعها لعملية تحويل، وذلك بوضعها في سياق أشمل.< (ص. 204).
أما نوع الدراسة الذي يفكر فيه إجلتون فأهم ما يميزه هو عنايته بأنواع “التأثير” التي تحدثها الخطابات وكيف تحدثها. إنها البلاغة التي كانت تدرك الإجراءات اللغوية إنجازات ملموسة -المرافعة، الإقناع، التحريض… وتنظر إلى استجابات الناس للخطاب باعتبار البنيات اللغوية الفعلية التي تشتغل فيها. كما أنها لم تكن تعتبر الكتابة والكلام موضوعين نصيين للتأمل أو التفكيك إلى ما لا نهاية، وإنما شكلين من الفاعلية لا ينفصلان عن العلاقات الاجتماعية بين الكتاب والقراء والخطباء والمستمعين، ولا يمكن فهمهما بمعزل عن المقاصد والشروط الاجتماعية… (ص. 206) (أتمني أن تساعدني الظروف على تفصيل القول في الطرح تفصيلا).
هذه الدعوة غايتها هي :
– تخليص النقد الأدبي من إسار طرق التفكير الراقصة على حبل الموضة و”البدعة”.
– إرجاعه إلى السبل الثرية القديمة التي أقام بينه وبينها سدا.
أما الذي ينطلق من معرفة موقع إيجلتون في خريطة النقد الأدبي البريطاني ليسقط معرفته هذه على الصوغ الذي سعى إجلتون إلى تطويره في هذا الكتاب فإليه نسوق قوله : >ليست نيتي (…) مواجهة نظرية الأدب التي تفحصتها فحصا نقديا، في هذا الكتاب، بنظرية أدب من عندي، (…) وكل قارئ ظل ينتظر أن يفسح له نظرية أدبية ماركسية فهو قارئ لم يوف هذا الكتاب حقه من القراءة.< (ص. 204).
لكن أدعوك إلى اتخاذ ما يلزم من الحيطة والحذر! فهو وإن كان لا يصرح بمعالم تلك النظرية لا يتوانى عن مجادلة ما يناقشه من خلفية نظرية الأدب الماركسية التي تجد معالمها الكبري في مؤلفه >النقد والإيديدلوجيا : دراسة في نظرية الأدب الماركسية< ( 1975 ). وكيف -وقد قرأت الفقرات السابقة- تصدق ما ذهب إليه من نفي مواجهة تلك بهذه، وإلا فتأمل الفقرة الأخيرة التي ختم بها الكتاب المترجم منه النص : >نحن نعلم أن الأسد أقوى من مروض الأسود، كما أن المروض يعلم هذا، لكن المشكلة هي عدم علم الأسد، وليس بالمستبعد أن موت الأدب قد يساعد الأسد على الاستيقاظ من غفلته (أو غفوته)< (ص. 217).
النص المترجم
إذا كان هناك شيء إسمه نظرية الأدب فمن نافلة القول الإشارة إلى وجود شيء إسمه الأدب تعد تلك نظريته، بإمكاننا إذن الشروع بطرح السؤال التالي : ما هو الأدب؟
لقد قيم بمحاولات عديدة لتعريف الأدب، ومن هذه التعريفات أنه كتابة >خيالية< بمعنى >المتخيل<، أي الكتابة غير الصادقة صدقا حرفيا. بيد أن التأمل السريع لما يدرجه الناس تحت عنوان الأدب يوحي بأن الأمر خلاف هذا. فالأدب الإنجليزي في القرن السابع عشر يتضمن شكسبير وويبستر ومارفيل وميلتون، ولكنه كان يتسع ليشمل أيضا مقالات فرانسيس بيكون ومواعظ جون دون والسيرة الذاتية الروحية لبونيان وكل ما كتبه السير طوماس براون. ويمكن أن يشمل عند اللزوم كتاب Leviathan لهوبز و History of rebellion لكلاريندون. كما أن الأدب الفرنسي في القرن السابع عشر يتضمن إضافة الي كورناي وراسين قواعد لاروشفوكو والخطب الجنائزية لبوسيي ومقالات بوالو عن الشعر، ورسائل مدام دوسيفيني إلى ابنتها، وفلسفة ديكارت وباسكال. وقد كان الأدب الإنجليزي في القرن التاسع عشر يشمل عادة لامب وماكولاي وميل (ولا يشمل بينطام وماركس وداروين أو هيربيرت سبنسر).
يبدو من ثم أن التمييز بين الواقع والخيال لن يصمد كثيرا لأنه قابل للمساءلة في غالب الأحيان. وقد اعتل، مثلا، بأن التعارض الذي نقيمه بين الحقيقة >التاريخية< والحقيقة >الفنية< لا ينطبق بتاتا على القصص البطولية الإيسلاندية القديمة(1). ويبدو أن كلمة >رواية< كانت تستعمل، في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر في إنجلترا، لوصف الأحداث الحقيقية والمتخيلة معا، كما أن التقارير الإخبارية نادرا ما كانت تعتبر واقعية، إذ لا الروايات ولا التقارير الإخبارية كانت ذات طابع واقعي أو تخييلي واضح. وهذا يعني أن تمييزنا الصارم بين هذه المقولات غير مجد(2). ولاشك في أن غيبون كان يؤمن بأنه يكتب الحقيقة التاريخية، ولربما كان الأمر كذلك بالنسبة لمؤلفي سفر التكوين، بيد أن بعض الناس اليوم يقرأ ما كتبوه باعتباره >واقعا< بينما يقرأه بعضهم باعتباره >خيالا<.
ومن المؤكد أن نيومان كان يؤمن بأن تأملاته اللاهوتية حقيقة، إلا أنها تعد اليوم >أدبا< في عرف عدد من القراء. وفضلا عن هذا، إذا كان >الأدب< يتضمن كتابات >واقعية< كثيرة فإنه يقصي أيضا كمّا هائلا من الكتابات التخييلية. إن السوبرمان الهزلي وروايات ميلس وبون تعد خيالية إلا أنها لا ينظر إليها عادة باعتبارها أدبا، وبالتأكيد ليس باعتبارها أدبا. وإذا كان الأدب كتابة إبداعية أو خيالية فهل معنى هذا أن التاريخ والفلسفة والعلوم الطبيعية ما هي بالإبداعية ولا بالخيالية.
ربما كنا في حاجة إلى مقاربة نوعية مختلفة إجمالا، وربما كان الأدب قابلا للتعريف لا من حيث هو خيالي أو كتخيل، وإنما من حيث استعماله اللغة بطريقة مخصوصة. ففي هذه النظرية يعتبر الأدب كتابة -بتعبير الروسي رومان ياكوبسون- تمثل >عنفا منظما يمارس على اللغة العادية< إذ يحولها الأدب ويكثفها وينحرف عنها على نحو مضطرد. هب أنك اقتربت مني، وأنا واقف في محطة من محطات حافلات النقل الحضري، وخاطبتني بقولك : >أنت يا عروس الصمت التي لما تغتصب<، فإنني أعي حينئذ أنني في حضرة الأدبية. أعرف هذا لأن تنظيم كلماتك وإيقاعها ورنتها جعل معناها يفوق ما يمكن أن يستخلص منها، أو بتعبير تقني هناك تفاوت بين الدوال والمدلولات، كما يقول علماء اللغة. فلغتك معتنية بنفسها، متباهية بكينونتها المادية، وذلك على عكس إقرار من قبيل قولنا : >ألا تعلم أن السائقين مضربون عن العمل<؟
كل هذا بالفعل هو التعريف الذي اقترحه الشكلانيون الروس >للأدبية<. وتتكون هذه الجماعة من : فكتور شلوفسكي ورومان ياكوبسون وأوزيب بريك ويوري تينيانوف وبوريس إيخنباوم وبوريس توماشيفسكي. وقد ظهروا في روسيا سنوات الثورة البلشفية سنة1917، وازدهرت حركتهم خلال العشريتين الأوليين من هذا القرن إلى أن قمعتهم الحركة الستالينية. ولأنهم كانوا جماعة من النقاد السجاليين المناضلين فقد رفضوا كل العقائد الصوفية التي أرخت بظلالها على النقد الأدبي قبل بروزهم. وبروح علمية وعملية اهتموا بالحقيقة المادية للنص الأدبي. وبناء على هذا ينبغي أن يخلص النقد الأدبي الفن من الغموض وأن يشتغل بكيفية اشتغال النصوص الأدبية : ليس الأدب ديانة زائفة أو علم نفس أو علم اجتماع ، إن هو إلا تنظيم مخصوص للغة له قوانينه وبنياته ووسائله الخاصة التي ينبغي أن تدرس في ذاتها بدل اختزالها في شيء آخر. هذا فضلا عن أن العمل الأدبي ليس وعاء للأفكار أو انعكاسا للواقع الاجتماعي، وليس تجسيما لحقيقة سامية. إنه بالأحرى واقع مادي يمكن أن تحلل طريقة اشتغاله مثلما تُفحص الآلة تماما. يتكون الأدب من كلمات لا من أشياء أو أحاسيس، ومن الخطل اعتباره تعبيرا عن فكر الكاتب. وبهذا الصدد أشار أزيب بريك إشارة مجازفة وهو يتحدث عن رواية بوشكين Eugene onegin – إلى أنها كانت ستكتب ولو لم يوجد بوشكين.
كانت الشكلانية من حيث الجوهر تطبيقا للسانيات في ميدان دراسة الأدب. ولما كانت اللسانيات المعنية شكلية تهتم ببنيات اللغة أساسا فقد تجاوزالشكلانيون تحليل >مضمون< الأدب (حيث قد يغري المرء علم النفس أو علم الاجتماع) قصد دراسة الشكل الأدبي، وبدل اعتبار الشكل تعبيرا عن المحتوى قلب الشكلانيون العلاقة رأسا على عقب، أي ذهبوا إلى أن المحتوى مجرد حافز للشكل، ومناسبة لنوع خاص من التمرين الشكلي. وتأسيسا على هذا ، فإن رواية >دون كيشوت< لا تدور >حول< الشخصية التي تحمل هذا الإسم، وذلك لأن هذه الشخصية مجرد إجراء لإنشاء أنواع مختلفة من التقنيات السردية، كما أن رواية جورج أورويل Animal Farm، في رأي الشكلانيين، ليست كتابة عن الستالينية، ذلك أن الستالينية مجرد فرصة مواتية لإنشاء الكناية. دفع هذا الإلحاح على المغايرة منافسي الشكلانيين إلى أن يطلقوا عليهم إسما قدحيا هو (الشكلانيون). وعلى الرغم من أن هؤلاء لا ينفون العلاقة بين الأدب والواقع الاجتماعي -كانت لبعضهم بالفعل صلات وثيقة مع البلشفيين- فإنهم يزعمون زعما مستفزا أن هذه العلاقة ليست من شؤون الناقد.
انطلق الشكلانيون من فكرة مفادها أن العمل الأدبي تجميع >لإجراءات< متفاوت الاعتباطية، وبعد وقت وجيز شرعوا في النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها >عناصر أو وظائف متعالقة داخل نظام نصي شامل<. وتتضمن هذه الإجراءات الصوت والصورة والإيقاع والتركيب والعروض والقافية والتقنيات السردية، وفي الحقيقة كل عناصر الشكل الأدبي. على أن الحد المشترك بين هذه العناصر جميعها هو أثرها >الإغرابي<. ذلك أن ما تختص به لغة الأدب، أي ما تمتاز به عن ضروب أخرى من الخطاب هو تحريفها اللغة العادية بطرق شتى. فتحت وطأة الإجراءات الأدبية تخضع اللغة العادية للتكثيف والتركيز والتحريف والتداخل والتمريغ والقلب رأسا على عقب، وبسبب هذا التغريب يصبح العالم اليومي -على حين غرة- بدوره غريبا، ويغدو إدراكنا للواقع واستجابتنا له بفعل مسكوكية الكلام اليومي- مبتذلين وثالمين، أو كما يقول الشكلانيون يصبح >آليا<. إن الأدب إذ يدفعنا إلى وعي اللغة وعيا خصبا يستثير هذه الاستجابات المعتادة ويجعل الأشياء قابلة >للإدراك< أكثر فأكثر. ولأن عليه أن يتصارع مع اللغة صراعا يتسم بوعي ذاتي جهيد فإن العالم الذي تحويه هذه اللغة يعاد تجديده بوضوح شديد، ويمكن أن نتخذ شعر مانلي هوبكينز مثالا متميزا على هذا الأمر. يجعل الخطاب الأدبي الكلام العادي غريبا أو مستلبا، بيد أنه بفعله هذا -وهنا موطن المفارقة- يدفعنا إلى امتلاك التجربة امتلاكا مفعما وحميميا. إننا نستنشق الهواء دون أن نعير اهتماما لذلك في معظم الأحيان، وفي هذا تشبه اللغة الهواء؛ فهي الوسيلة التي بها نتواصل. أما إذا كان الهواء-فجأة- ثخينا أو ملوثا فإننا نغدو مجبرين على الاعتناء بتنفسنا عناية بالغة وإلا نجمت عن ذلك مضاعفات خطيرة تسم حياتنا برمتها. وبالتصريح نقول قد ترد علينا من صديق مّا رسالة مكتوبة كتابة مشخبطة دون أن تلفت بنيتها السردية انتباهنا، لكن لو انقطع حبل الحكاية -ونحن مستغرقون في قراءة قصة مّا- ثم استؤنف ثانية، وانتقل بنا السرد من مستوى حكائي إلى آخر، وحيل بيننا وذروة الحكاية -بوساطة التأجيل- قصد إثارة فضولنا وتأجيجه، فإننا نصبح واعين وعيا يقظا بكيفية بناء تلك الحكاية، فضلا على توازي هذا كله مع اندماجنا فيها اندماجا قويا. وكما يقول الشكلانيون : تلجأ القصة إلى إجراءي >العرقلة< و>التأجيل< لإثارة اهتمامنا. ويعد هذان الإجراءان >جليين< في اللغة الأدبية. وهذا ما جعل فيكتور شلوفسكي يصوغ ملاحظة تقطر خبثا، وهو يتحدث عن رواية لاوْرنس ستيرن Tristram Shandy وهي رواية موغلة في عرقلة خطها الحكائي إلى درجة أنها تفصح بالكاد عن خلفيتها، قال : >إنها الرواية الأشد نموذجية في عالم الأدب<.
ومن ثم اعتبرالشكلانيون اللغة الشعرية سلسلة من الانحرافات عن المعيار وضربا من العنف اللغوي : الأدب نوع من اللغة >خاص< يختلف عن اللغة العادية التي نستعملها جميعا. غير أن التعرف على الانحراف يفترض القدرة على تحديد المعيار المنحرف عنه. وعلى الرغم من أن اللغة العادية مفهوم يعشقه بعض فلاسفة أوكسفورد، فإن الجامع بين ما يعنيه هؤلاء باللغة العادية ومدلول اللغة العادية في عرف عمال بناء گلاسگو جامع واه. فاللغة التي تستعملها كلتا الفئتين الاجتماعيتين في تحرير الرسائل الغرامية تختلف عادة عن طريقة مخاطبتها للقس المحلي. أما الفكرة الذاهبة الى أن هناك لغة >عادية< واحدة، لغة شائعة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، فمجرد وهم. ذلك أن كل لغة واقعية تتكون من مجموعة من الخطابات الشديدة التعقيد والتفاوت تبعا للانتماء الطبقي والجهوي والجنسي (الذكورة والأنوثة) والمنزلة، وقس على هذا. ولا يمكن أن تكون اللغة، بأي حال من الأحوال، موحدة داخل عشيرة لغوية واحدة متجانسة. ومرد ذلك إلى أن ما يعتبره شخص ما معيارا قد يعتبره غيره انحرافا. ومثال ذلك أن استعمال كلمة ginnel عوض >زقاق< قد يكون شاعريا في مدينة برايطون ولغة عادية في مدينة بارنسلي. بل إن نصا مغرقا في النثرية -وليكن نصا ينتمي إلى القرن الخامس عشر- قد يكون وقعه طقوسيا في رأينا اليوم بسبب عتاقته. وهب أننا عثرنا على قطعة مكتوبة فريدة خلفتها حضارة بادت، فهل تظن أن بوسعنا الحسم فيما إذا كانت >شعرا< أو لا، اعتمادا على تفحصها وحده؟ كلا! مادمنا مخفقين لا محالة في الوصول إلى ما اعتبر خطابات >عادية< في عرف ذلك المجتمع. بل لو قِيم بأبحاث عميقة انكشف على إثرها أن القطعة >منحرفة< ما قام ذلك دليلا كافيا على أنها شعر، إذ ليس كل انحراف لغوي شعرا، ومثال ذلك الرطانة العامية، فهي انحراف ولكنها مع ذلك ليست قطعة من الأدب >الواقعي< ما غابت معلومات إضافية حول الطريقة التي تشتغل بها فعليا قطعة تنتمي إلى الكتابة في إطارالمجتمع المعني.
لا يعني هذا أن الشكلانيين الروس يخفى عليهم هذا كله. فهم يعترفون بأن المعايير والانحرافات تتغير من سياق اجتماعي أو تاريخي إلى آخر، وبأن >الشعر< بهذا المعنى يتوقف على الحقبة الزمنية المعنية. إن حقيقة >غرابة< قطعة لغوية لا يعني أنها كذلك في كل زمان ومكان، وإنما يعني أنها غريبة إزاء خلفية لغوية معيارية فحسب. أما إذا تغيرت هذه الخلفية فلن تدرك القطعة أدبا. ولو كان كل الناس يستعملون جملا من قبيل >يا عروس الصمت التي لما تغتصب< وبعضهم يخاطب بعضا في الحال لفقد هذا الضرب من اللغة شعريته. وبعبارة أخرى، تعد الأدبية في نظرالشكلانيين الروس وظيفة علاقات خلافية بين صنف خطابي وآخر، وهي ليست خاصية أدبية. كما أن غايتهم لم تكن تحديد >الأدب< وإنما >الأدبية<، أي استعمالات خاصة للغة قد توجد في النصوص الأدبية، كما توجد في غيرها. وعلى كل من يظن أن >الأدب< يمكن أن يحدد بوساطة استعمالات لغوية مخصوصة شبيهة بهذه أن يواجه واقع وجود قسط كبير من الاستعمال الاستعاري في كلام سكان مدينة مانشيستر يفوق القسط الموجود في شعر مارفيل، وليس هناك من إجراء أدبي، كناية كان أم مجازا أم مقابلة عكسية أم إثباتا بالنفي، لا يقع توظيفه توظيفا كثيفا في الخطاب اليومي.
وعلى الرغم من ذلك ظل الشكلانيون يفترضون أن >الغرابة< هي جوهر الأدبي، خلا أنهم يجعلون هذا الاستعمال اللغوي نسبيا، ويعتبرونه تباينا بين نمط كلامي وآخر. لكن لو نطق شخص يجالسني في حانة بما يلي : >هذا خط يدوي رديء<، فهل أعتبر قوله هذا >لغة أدبية< أم لا؟ إنه في الواقع لغة أدبية لأنه مقتبس من رواية HUNGER للكاتب كنوت همسون. هذا القول جزء من نص أقرؤه باعتباره >متخيلا< يعلن عن نفسه >رواية< يمكن أن ترد ضمن برنامج أدبي يُقرر تدريسه في الجامعة، وهلم جرا. فالسياق يشعرني بأن الجملة أعلاه تنتمي إلى الأدب، إلا أن لغتها ذاتها لا تملك أية خاصية أو ميزة محايثة تمتاز بها عن خطابات أخرى، إذ يمكن أن يفوه بها شخص ما في الحانة دون أن تثير روعتها الأدبية أية حفاوة.
إن التفكير في الأدب على النحو الذي فعله الشكلانيون الروس يعني -في حقيقة الأمر- التفكير في الأدب كله شعرا، ذلك أنهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، حين يشرعون في معالجة الكتابة النثرية يجعلون أنواع التقنيات التي استخدموها في مقاربة الشعر تمتد لتشمل تلك الكتابة الواقعية أو الطبيعية التي ليست وعيا لغويا لافتا للنظر. وينعت الناس اللغة أحيانا بالجودة لأنها لا تفرط -بالذات- في الاهتمام بنفسها فهم إما يعجبون بإيجازها أو بعفويتها أو بوقارها أو بتواضعها. ثم ماذا عن النكت والأهازيج والشعارات التي يرددها أنصار الفرق أثناء مقابلات كرة القدم، وقل الشيء نفسه عن عناوين الصحف والإعلانات، وهي كلها غالبا ما تكون منمقة دون أن تصنف في خانة الأدب، في معظم الأحيان.
الأمر الثاني المتعلق >بالغرابة< هو انتفاء نوع من الكتابة -بالنظر إلى براعته الكافية- لا يقبل أن يقرأ إغرابا، وإلا فلنتأمل إعلانا نثريا لا لبس فيه كذلك الذي نصادفه في أنفاق ميترو لندن : >يجب أن تُحمل الكلاب أثناء استعمال السلم الآلي الحركة<. فهذه الجملة عارية من اللبس، كما قد يبدو للوهلة الأولى : هل يقصد الإعلان أنه يجب عليك أن تحمل كلبا وأنت على السلم؟ كما أن هناك عددا من الإعلانات مفهوم ظاهرها إلا أنها لا تخلو من بعض الالتباس، ومن ذلك مثلا : >أرفض أن توضع في هذه السلة !< أو علامة المرور >طريق منحرفة<، كما قرأها مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا. وعلى افتراض أننا تركنا هذه الالتباسات المربكة جانبا فالأكيد الجلي أن الاعلان السالف -حمل الكلاب… يمكن أن يقرأ قراءة الأدب. فقد يتأمل المرء النبرة التهديدية للمقاطع الأولى الثقيلة فينساق تفكيره -حين يصل إلى التلميح الغني للفعل >تحمل< – وراء الرنة الموحية بمساعدة الكلاب العرجاء على تحمل حياتها؛ وربما وجد في إيقاع كلمة >السلم< ونغمتها محاكاة لترنح السلم صعودا وهبوطا. قد نرى في هذا ضربا من المسايرة العبثية إلا أن عبثيتها لا تقل عن المطالبة بسماع قرع السيوف وطعناتها في أبيات شعرية تصف التسايف، غير أن لهذا- على الأقل- إيجابية الإيحاء بأن الأدب بقدر ما هو مسألة تتعلق بما يفعله الناس بالكتابة، هو أيضا مسألة ما تفعله الكتابة فيهم.
لكن حتى لو قرئ الإعلان على النحو السالف، فإن قراءته لم تتجاوز اعتبارات قراءة الشعر، وما الشعر إلا جزء مما هو مندرج في خانة الأدب. والآن هيا بنا نفحص طريقة أخرى لقراءة العلامة >قراءة مغرضة<. وهي طريقة ستبعدنا إلى حد ما عما كنا فيه : لنتخيل سكرانا ثملا، في الهزيع الأخير من الليل، على السلم يقرأ الإعلان بترو كبير لوقت معلوم، وبعدها خاطب نفسه قائلا : >هذا صحيح<، فمن أي طينة هو الخطأ المرتكب هنا؟ إن ما فعله السكران في الواقع هو أنه فهم العلامة خبرا ذا دلالة عامة، بل كونية. وهو إذ طبق مواضعات معينة، تخص القراءة، على الكلمات التي يتكون منها الإعلان اجتثها من سياقها وعممها بحيث جاوز مقصدها العملي إلى شيء ربما كان فحواه أعمق وأوسع من مقصدها. ومن المؤكد أن هذا التصرف يبدو عملية يتطلبها ما يسميه الناس أدبا، فحين يذهب الشاعر مثلا إلى أن محبوبته تشبه وردة حمراء، ولما كان قد أخرج هذا القول إخراجا شعريا، فإننا على بينة من أن الشاعر لا يفترض أننا سنسأله عما إذا كانت لديه محبوبة تبدو له، لأسباب عجيبة، شبيهة بوردة، إنه يخبرنا بشيء له صلة بالنساء وبالغرام جملة. ومن ثم فالأدب ليس خطابا >نفعيا<، عكس ما هي حال كتب علم الإحياء والملاحظات التوجيهية المرفقة بالحليب سلعة. معنى هذا أن الأدب لا يخدم غاية عملية مباشرة، أي ينبغي أن ننظر إليه باعتباره محيلا على أحوال عامة. وفي بعض الأحيان، وليس دوما، قد يوظف لغة خاصة كما لو كان يهدف إلى جعل هذه الحقيقة واضحة للعيان، أي الإشارة إلى أن الرهان هو طريقة الحديث عن امرأة ما، وليس امرأة بعينها من لحم ودم. إن هذا التشديد على طريقة الحديث بدل التشديد على واقعية المتحدث عنه يُتخذ أحيانا وسيلة للإشارة إلى أننا نعني بالأدب ضربا من الإحالة الذاتية، لغة تتحدث عن نفسها.
ومع ذلك تقف في طريق تحديد الأدب هاته حواجز منها : من المحتمل أن يفاجأ جورج أورويل بأن كتاباته ينبغي أن تقرأ كما لو كانت الموضوعات التي ناقشها أقل أهمية من الطريقة التي استخدمها في مناقشتها. وتعتبر قيمة الصدق والفائدة العملية لما يقال -في معظم ما يصنف في خانة الأدب- مهمة بالنسبة للتأثيرالشامل. لكن حتى إذا كان التعامل مع الخطاب تعاملا >غير نفعي< جزءا مما هو مقصود >بالأدب<، فإن ما يترتب من هذا >التحديد< هو أن الأدب في الواقع لا يمكن تحديده تحديدا >موضوعيا<؛ وذلك لأنه يجعل تحديد الأدب متوقفا على الكيفية التي يقرر بها المرء أن يقرأ، وليس على طبيعة ما كتب. هناك أصناف من الكتابة -الأشعار والروايات والمسرحيات- ينتظر أن تكون >غير نفعية< بهذا المعطى. غير أن هذا لا يضمن أنها ستقرأ فعلا بهذه الطريقة. ومن المؤكد أنني قد أقرأ رواية كيبتون للأحداث المتصلة بالأمبراطورية لا لأنني موجه توجيها خاطئا إلى حد الظن أنها ستخبرني – نسبيا- عن روما القديمة، وإنما لأنني من المعجبين بأسلوب كيبتون النثري أو لأنني أستلذ صور فساد أخلاق البشر، كائنا ما كان مصدرها التاريخي، بيد أنني قد أقرأ قصيدة روبيرت بارنس كي أعرف -باعتباري عالم بستنة ياباني- إن كانت سوق الوردة الحمراء مزدهرة بانجلترا في القرن الثامن عشر أو لا. على أن هذه القراءة لا تمت بسبب إلى قراءة القصيدة باعتبارها >أدبا<، لكن هل معنى هذا أنني لا أقرأ كتابات أورويل أدبا إلا إذا عممت ما قاله عن الحرب الأهلية الإسبانية وجعلته قولا كونيا عن الحياة البشرية؟ مما لا جدال فيه أن عددا من هذه الأعمال التي تدرس باعتبارها أدبا في المؤسسات الأكاديمية، قد تم إنشاؤها لتقرأ أدبا، لكن مما لا جدال فيه أيضا أن عددا من هذه الأعمال ليست كذلك. فقد تصنف في البداية قطعة فلسفية أو تاريخية، ثم بعد ذلك تصنف أدبا، والعكس صحيح. أي أنها قد تصنف في البداية أدبا ثم تكتسب قيمة لأهميتها الأركيولوجية. تولد بعض النصوص أدبا وينتهي بعضها إلى اكتساب صفة الأدب، وبعضها يعدم هذه الصفة. ومن هذا المنظور تستحق التربية عناية أقوى مما يستحقه الميلاد، ويكمن السر كله لا في : ما هو أصلك؟ وإنما : كيف يعاملك الناس؟ فإذا قرر هؤلاء أنك أدب فأنت فيما يبدو كما قالوا، بغض النظر عما تكونه، من زاوية نظرك.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن النظر إلى الأدب لا باعتباره خاصية محايثة أو مجموعة من الخصائص التي تبديها أنواع معينة من الكتابة بدءا من بوولف حتى فيرجينيا وولف، وذلك عوض النظر إليه باعتباره عددا من الكيفيات التي يخلق بها الناس صلات مع الكتابة، بيد أنه لم يكن سهلا استخراج بعض الخصائص الثابتة المحايثة من كل ما اعتبر اعتبارا واسعا >أدبا<. وفي الواقع ستكون محاولة من هذا القبيل أمرا مستحيلا شبيها بمحاولة التعرف على الخاصية المميزة والمشتركة بين الألعاب. لا جوهر >للأدب< بتاتا، وكل قطعة >مكتوبة< يمكن أن تقرأ قراءة غير >نفعية<، إذا كان هذا هو المقصود بقراءة نص ما باعتباره >أدبا<، وبالمثل يمكن أن تقرأ قطعة مكتوبة قراءة >شعرية<. ولنضرب مثالا على هذا أنني أمام سبورة مثبتة فيها مواقيت، وأنني أنعم فيها النظر لا قصد العثور على قطار رابط بين مكانين، وإنما لتنشيط تأملات عامة -في خلدي- حول السرعة ومدى تعقد الحياة المعاصرة أفلا يمكن القول إنني أقرأ ما كتب في السبورة قراءة الأدب؟ لقد ذهب جون إليس إلى أن مصطلح الأدب يشتغل بالأحرى مثل العبارة >عشب ضار ليست الأعشاب الضارة نوعا خاصا من النبات، وإنما هي بالذات ذلك النبات الذي يرغب عنه البستاني لسبب من الأسباب<(3) وربما كان >الأدب< شيئا مناقضا لما سلف، أي نوعا من الكتابة ينظر إليه المرء، لسبب ما، نظرة تبجيل وإجلال، وكما قد يقول الفلاسفة >فالأدب< و >العشب الضار< مصطلحان >وظيفيان< وليسا >أنطولوجيين< أي أنهما يخبراننا عما نفعله، لا عن الكينونة الثابتة للأشياء، إنهما يخبراننا عن الدور الذي يؤديه نص أو نبات شوكي في سياق اجتماعي، وعن علاقات ذلك الدور مع محيطه واختلافاته عنه، وعن طرق اشتغاله، وعن مراميه وعن الممارسات البشرية المحيطة به، وبهذا المعنى فالأدب ضرب من التعريف الشكلي المحض والفارغ، وحتى لو ادعينا أنه يتعامل مع اللغة تعاملا >غير نفعي< فإننا لما نصل إلى >جوهر< الأدب، لأن هذا التعامل يصدق أيضا بالنسبة لممارسات لغوية أخرى كالنكت مثلا، وعلى كل حال، من المستبعد أن نكون قادرين على التمييز الصارم بين الطرق >العملية< التي تصل بيننا وبين اللغة، وغنى عن البيان أن قراءة رواية طلبا للمتعة تختلف عن قراءة طرقية طلبا للإرشاد، لكن ما موقع قراءة كتاب في علم الأحياء، من أجل إغناء فكرك، من الإعراب؟ هل يعد هذا تعاملا ‘>نفعيا< مع اللغة أم لا؟ لقد أدى الأدب -في عدة مجتمعات- وظائف عملية، كالوظائف الدينية مثلا، على أن التمييز الدقيق بين >العملي< و>غير العلمي< تمييز ممكن في مجتمع مثل مجتمعنا حصرا، حيث لم تعد للأدب وظيفة عمليةبالمرة . ويمكن أن نقدم، كتحديد عام لما هو أدبي، معنى خاصا في حقيقته من الناحية التاريخية.
إننا لما نكتشف السر الكامن خلف اعتبار كتابات كل من لامب ماكولي وميل كتابات أدبية، وإقصاء كتابات كل من ماركس وبينثام وداروين من خانة الأدب على نحو عام، وربما كان الجواب، ببساطة، أن الثلاثة الأوائل يشكلون نماذج من >الكتابة الجيدة< بينما الثلاثة الأواخر ليسوا كذلك، ولهذا الجواب وجهان، أولهما سلبي يتمثل في عدم صحته عموما، وذلك في نظري على الأقل، وثانيهما إيجابي هو الإيحاء بأن معظم الناس يطلقون مصطلح الأدب على تلك الكتابة التي يؤمنون بجودتها. غير أن هناك اعتراضا مفاده لو كان ما سلف صحيحا، على الجملة، فإن يوجد على الإطلاق شيء إسمه >الأدب الرديء< قد نعتبر أن في تقديري للكاتبين لامب وماكولي مبالغة، دون أن يعني هذا أنني أكف عن النظر إلى كتاباتهما أدبا، وقد نذهب إلى أن رايموند شاندلو كاتب >جيد في نوعه<، إلا أن ما يكتبه ليس أدبا تماما. ومن ناحية ثانية إذا كان ماكولي كاتبا رديئا حقا -إن كان لا يعتني بالنحو، ولا يبدي اهتماما بشيء سوى الفئران البيضاء- فإن الناس لن يسموا عمله أدبا بالمرة، بل وحتى أدبا رديئا.
ويبدو في حكم المؤكد أن لأحكام القيمة علاقة مع ما يشهد له بأنه أدب وما لا يشهد له بذلك، وهذا لا يعني أن الأدب ينبغي أن يكون، بالضرورة، >جيدا< كي يعتبر أدبا، وإنما يعني أنه ينبغي أن يكون من النوع الذي يشهد له بالجودة، وقد يكون هذا المشهود له بالجودة مثالا رديئا من نمط عام مشهود له بالجودة. فعلى سبيل المثال ما من أحد يكلف نفسه عناء القول إن ورقة الباص مثال عن الأدب الرديء، إلا أننا قد نصادف من يذهب إلى أن شعر إرنست داوسن رديء. على أن اصطلاح >الكتابة الجيدة< أو الآداب الراقية، بهذا المعنى، اصطلاح ملتبس، إذ أنه يشير إلى ضرب من الكتابة يقدر، على العموم، تقديرا عاليا، دون أن يجعلك بالضرورة توافق على الرأي الذي مفاده أن عينة خاصة منه >جيدة<.
في ضوء هذا نعتقد أن الرأي الذاهب إلى أن >الأدب< نوع من الكتابة المشهود لها بالجودة العالية اقتراح مفيد بيد أن له أثرا تخريبيا إلى حد ما، إذ يعني أن بإمكاننا التخلي تخليا نهائيا عن وهم >موضوعية >مقولة< الأدب< بمعنى أن الأدب معطى أبدي لا يقبل التغيير. يمكن أن يعد أي شيء أدبا، وقد يتوقف عن اعتبار كل ما نظر إليه شيئا غير قابل للتغيير ولا لأن يوضع موضع استفهام -أدب شكسبير مثلا- أدبا. وكل اعتبار بأن دراسة الأدب هي دراسة كينونة قارة جيدة التحديد -كما الأنتمولوجيا دراسة الحشرات- يمكن أن يضرب عنه صفحا كالوهم. فبعض أنواع الأدب خيال، وبعضها الآخر ليس كذلك، كما أن بعض الأدب من حيث اللغة مختلف في ذاته، في حين أن بعض الكتابة الراقية رقيا بلاغيا ليست أدبا. وإذا كنا نقصد بالأدب مجموعة من الأعمال ذات القيمة الأكيدة، وغير القابلة للتغيير، والمميزة ببعض الخصائص الملازمة المشتركة فهو غير موجود. وحين أستعمل عبارتي >ماهو أدبي< و>الأدب< من الآن فصاعدا في هذا الكتاب فإنني أضعهما بين قوسين للدلالة على أن المصطلحين لا يبلغان ما نود قوله بالتمام، إلا أننا لا نملك ما هو أفضل منها حتى الآن.
إن أحكام القيمة شديدة الاختلاف، وهذا ما جعل تحديد الأدب باعتباره كتابة مشهودا لها بالجودة العالية ينجم عنه أن الأدب كينونة ثابتة. يقول إعلان في إحدى الجرائد : >الأزمنة تتبدل، والقيم ثابتة< كما لو أننا ما زلنا نؤمن بقتل الأطفال المعوقين أو بعرض مختلي العقل في الساحات العمومية. فكما أن الناس قد يتعاملون مع عمل أدبي باعتباره فلسفة في قرن، وباعتباره أدبا في قرن لاحق، فبإمكانهم تغيير تصورهم للكتابة التي يعتبرونها ذات قيمة، كما أن بإمكانهم تغييرتصورهم للخلفيات التي يستخدمونها في تعيين ما هو قيم، وما لا قيمة له. وهذا لا يعني بالضرورة -وقد أومأت إلى هذا فيما تقدم- أنهم سيرفضون إطلاق إسم الأدب على عمل سبق لهم أن نعتوه بالدونية : قد يحتفظون بتسميته أدبا، بمعنى أنه ينتمي على وجه التقريب إلى نوع الكتابة الذي يقدرونه عموما. لكن هذا يعني أيضا أن ما يسمى >القانون الأدبي< والتقليد العريق في >الأدب القومي<، غير القابل للمساءلة. ينبغي أن يعترف بأنه بناء صاغه أناس بعينهم لأسباب خاصة في زمن معين. وهكذا لا وجود لشيء إسمه عمل أدبي أو تقليد أدبي يقدر في ذاته بغض النظر عما يمكن أن يقوله أو أن يكون قاله عن أحد ما. هذا فضلا عن أن مصطلح >القيمة< ثلاثي الأبعاد : إنه يعني ما قومه أناس في مقامات خاصة، وفق مقاييس خاصة، وفي ضوء أغراض محددة. وهكذا من الممكن جدا أن ننتج في المستقبل -في ظل تحول عميق بما فيه الكفاية لتاريخنا- مجتمعا عاجزا عن استخلاص أي شيء على الإطلاق من أعمال شكسبير. وبكل بساطة قد تبدو أعماله، بشكل محبط، دخيلة ومليئة بالأساليب والأفكار والأحاسيس التي يعتبرها مجتمع من هذا الصنف محدودة وغير ملائمة. وفي هذه الحال لن تقدر أعمال شكسبير تقديرا أكبر من معظم الرسوم الجدارية المنتشرة في أيامنا هذه. وعلى الرغم من أن عددا من الناس سيعتبرون هذا الشرط التاريخي مفقرا إفقارا مأساويا، فإن عدم الاحتفاظ بإمكانية بروز هذا الشرط، من خلال غنى إنساني شامل، يبدو لي دوغمائيا.
ولقد كان كارل ماركس مشغول البال بسؤال مفاده، لماذا ظل الفن اليوناني محتفظا >بجاذبية< أبدية، على الرغم من أن الشروط الاجتماعية التي أنتجته انقضت؟ لكن من أين لنا بمعرفة أنه سيظل >جذابا إلى الأبد<، والحال أن التاريخ لما ينته. هب أننا اكتشفنا بفضل تنقيب أركيولوجي ماهر أشياء إضافية حول ما كانت تعنيه التراجيديا الإغريقية، فعلا، بالنسبة لجمهورها الأصلي، واكتشفنا من ثم أن هذه الانشغالات بعيدة تماما عن انشغالاتنا الراهنة، ثم شرعنا في قراءة هذه المسرحيات في ضوء هذه المعرفة المعمقة، فلربما كانت إحدى النتائج هي انتهاء إعجابنا بها، وقد نكتشف أننا كنا معجبين بها آنفا لأننا كنا نقرؤها -عن غير قصد- في ضوء انشغالاتنا؛ فبمجرد ما يغدو هذا ممكنا ستتوقف الدراما توقفا تاما عن مخاطبتنا.
إن واقع تأويلنا الأعمال الأدبية، إلى حد بعيد، في ضوء انشغالاتنا -وبالفعل فمن ضمن ما تعنيه انشغالاتنا أننا عاجزون عن فعل أي شيء آخر- قد يعد سببا يفسر كيف تبدو بعض الأعمال الأدبية محتفظة بقيمتها طوال قرون، وقد يعود ذلك، لاريب، إلى أننا ما زلنا نقتسم والعمل نفسه عددا من الانشغالات؛ وقد يعود إلى أن الناس لم يكونوا بالفعل يقومون بنفس العمل على الإطلاق، ولو كانوا يظنون أنهم يفعلون. فهوميروس كما نفهمه اليوم ليس مطابقا لهوميروس كما فهمته العصور الوسطى، وقل الشيء نفسه عن شكسبير >اليوم< وشكسبير عند معاصريه؛ بل الأحرى أن المراحل التاريخية المختلفة شيدت هوميروسا وشكسبيرا >مختلفين<، لأغراض خاصة، ووجدت في هذه النصوص عناصر تستحق التقدير أو لا تستحقه، ورغم أنها ليست هي هي بالضرورة. وبعبارة أخرى، كل الأعمال الأدبية >تعاد كتابتها<، وإن كان ذلك بطريقة واعية، من قبل المجتمعات التي تقرؤها. وبالفعل ما من قراءة للعمل الأدبي إلا وتتسم بأنها إعادة كتابة، ولا نكاد نعثر على عمل أدبي ولا على تقييم معاصر له، قابل لأن يوسع ببساطة نحو مجموعات جديدة من الناس دون أن يمسه التغيير، وربما تم ذلك بطريقة غير قابلة للتعرف خلال السيرورة، ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعل ما يعتبر أدبا شأنا غير قار.
أنا لا أعني أنه غير قار لأن أحكام القيمة تطبعها >الذاتية<. فبناء على هذا الرأي ينقسم العالم إلى وقائع قوية >بعيدة< مثل المحطة الرئيسية الكبرى، وإلى أحكام قيمة اعتباطية >قريبة< مثل حب الموز أو الشعور بأن نغمة إحدى قصائد ييتس تتراوح بين الدفاع المفزع والرضوخ المرن والقاسي. الوقائع في متناول العموم وهي فوق الشبهات، والقيم خاصة ومجانية. وهناك فرق واضح بين رواية واقعة مثل قولك : >بنيت هذه الكاتدرائية سنة 1612< وبين إصدار حكم قيمة من قبيل >تعد هذه الكاتدرائية عينة عجيبة من المعمار الباروكي<. لكن هب أنني أدليت بالواقعة الأولى وأنا أرى سائحة قدمت من وراء البحار لزيارة إنجلترا، أريها تلك الكتدرائية فإذا بها قد ألمت بها الحيرة فسألتني : لماذا تصر على إخباري بتواريخ تشييد البنايات؟ لماذا هذا الهوس بالأصول؟ وربما أضافت : لانحتفظ عندنا إطلاقا بسجل لمثل هذه الأحداث. نحن نصنف مبانينا، بالعكس، حسب مواجهتها الشمال الغربي أو الجنوب الشرقي. إن ما قد يعنيه هذا هو إبراز جزء من النسق اللاواعي لأحكام القيمة، وليس هناك من تصريح وقائعي أدلي به قادر على الإفلات منها. وفي نهاية المطاف، تعتبر التصريحات المرتبطة بالوقائع تصريحات تفترض عددا من أحكام القيمة القابلة للمساءلة؛ ومنها أن هذه التصريحات تستحق أن يدلى بها، وربما فاقت من حيث استحقاق الإدلاء تصريحات أخرى، لكن ما يبدو ذا أهمية في ذلك الحوار هو عنصر يسميه اللسانيون >اللغو< أي الاهتمام بفعل التخاطب نفسه. حين أدردش معك حول الطقس فإنني أشير أيضا إلى أنني أرى التخاطب معك مفيدا، وأنني اعتبرك شخصا جديرا بالحديث معه، وأنني لست شخصا أنانيا غير اجتماعي بصدد الخوض في الانتقاد المفصل لمظهرك.
بهذا المعنى لا توجد إمكانية للحديث عن تصريح غير مجد. ولا شك في أن التصريح بتاريخ إنشاءالكاتدرائية سيعد غير مجد في ثقافتنا أكثر مما هو تمرير رأي حول معمارها، لكن بإمكان المرء أن يخمن مقامات يكون فيها التصريح الأول >قيمة مشحونة< أكثر من التصريح الثاني، وربما أضحت الكلمتان >باروك< و>عجيب< شبه مترادفتين، بينما هناك شيء عنيد -في دواخلنا- يجعلنا نتمسك باعتقاد أن تاريخ إنشاء بناية مهم، وأن تصريحي اعتبر طريقة معقولة للإشارة إلى هذا الشيء. كل تصريحاتنا تتحرك في غالبيتها داخل شبكة مستترة من المقولات القيمية، وبالفعل فبدون مثل هذه المقولات لن يكون لدينا ما نقوله لبعضنا البعض بالمرة. وليس الأمر بالضبط كما لو أن لدينا شيئا يسمى المعرفة الفعلية التي قد تحرفها من ثم اهتمامات وأحكام خاصة، رغم أن هذا ممكن الحدوث بكل تأكيد؛ وبدون اهتمامات خاصة أيضا لن تكون لدينا أية معرفة على الإطلاق، لأننا لن ندرك الأهمية التي يكتسبها الانشغال بمعرفة شيء ما. فالاهتمامات من مكونات معرفتنا، وليست مجرد أحكام مسبقة تجعلها عرضة للخطر، والزعم الذاهب إلى أن المعرفة بنيغي أن تكون >قيمة حرة< هو بدوره حكم قيمة.
قد لا نشك في كون الإعجاب بالموز شأنا شخصيا ليس إلا، ولكن هذا الأمر في حقيقته قابل للمناقشة، إذ من المحتمل أن يكشف تحليل شامل لذوقي الغذائي عن مدى ارتباط هذا الأخير ارتباطا وثيقا ببعض تجارب التنشئة المتصلة بالطفولة المبكرة، وبعلاقاتي مع والدي وإخوتي، وهذا أمر يصدق إلى حد بعيد على ما يتعلق بالبنية الأسية للمعتقدات والاهتمامات التي ترعرعت فيها من حيث أنا عضو في مجتمع بعينه، ومنها الإيمان بأنني ينبغي أن أبذل كل ما في وسعي للحفاظ على صحة جيدة، وأن الفروق بين الذكر والأنثى متجذرة في بيولوجيا الإنسان، أو أن الكائنات البشرية أهم من التماسيح. قد نختلف حول هذا الأمر أو ذاك، ولكن ما يسمح لنا بهذا هو أننا تجمعنا طريقة معينة >عميقة< للفهم والتقويم وثيقة الصلة مع الحياة الاجتماعية، وهي لا يمكن أن تتغير ما لم تغير تلك الحياة. ليس باستطاعة أي كان معاتبتي عتابا شديدا إن كنت غير معجب بقصيدة من قصائد الشاعر دون (Donne)، ولكن الأمر سيختلف لو ادعيت أن ما يكتبه هذا الشاعر ليس أدبا بالمرة، إذ في ظل ظروف معينة قد يؤدي بي هذا الأمر إلى فقد منصبي. وشبيه بهذا واقع كوني حرا في التصويت لفائدة حزب العمال أو حزب المحافظين، ولكن إذا حاولت الادعاء -انطلاقا من اعتقادي- أن الاختيار نفسه يخفي حكما مسبقا أعمق يتمثل في أن معنى الديمقراطية محصور في وضع علامة على ورقة اقتراع كل بضع سنوات، فسيؤدي بي هذا -في ظروف غير عادية- إلى السجن.
إن بنية القيم الشديدة الخفاء التي تحكم تصرفاتنا الواقعية وتعد أساسها تعتبر جزءا مما نعنيه >بالإيديولوجيا<، وأعني >بالإيديولوجيا< على وجه التقريب، الطرق التي ترتبط بها أقوالنا ومعتقداتنا مع بنية السلطة وموازين القوة في المجتمع الذي نعيش فيه. يترتب من هذا التحديد التقريبي للإيديولوجيا أنه ليس من الممكن القول إن كل أحكامنا ومقولاتنا الأسية إيديولوجية. فمن الأشياء المتأصلة فينا تخيل أنفسنا متحركين إلى الأمام في اتجاه المستقبل (مالم ير مجتمع آخر أنه يتحرك إلى الخلف في اتجاه المستقبل)، لكن رغم أن طريقة التفكير هذه ترتبط ارتباطا قويا ببنية السلطة في مجتمعنا فإنها لا تحتاج دائما وفي كل مكان إلى أن تكون كذلك. لا أعني >بالإيديولوجيا< -ببساطة – ما يعتنقه الناس من معتقدات لا واعية في الغالب، ومتخندقة بعمق، وإنما أقصد على وجه الخصوص أشكال الإحساس والتقييم والإدراك والاعتقاد التي لها علاقة ما مع الحفاظ على سلطة المجتمع وإعادة إنتاجها. ويمكن أن يوضح مثال من الأدب أن هذه المعتقدات ليست، بأي شكل من الأشكال، مجرد تلاعبات خاصة.
لقد سعى الناقد الكامبريجي أ. أ. ريشاردس في دراسته المشهورة (1929) Practical criticism إلى البرهنة برهنة مضبوطة على أن أحكام القيمة الأدبية قد تكون شاذة وذاتية فعلا. ولتحقيق ذلك قدم لطلبته مجموعة من القصائد غفلا من العناوين وأسماء الشعراء طالبا منهم تقييمها. أما الأحكام الناتجة فقد كانت شديدة التفاوت، ذلك أن الشعراء المشهورين آنذاك صنفوا في مصف المغمورين، وصنف المغمورون في مصاف المشهورين. ومع ذلك لم ينتبه ريشاردس في نظرنا إلى أهم مظهر في هذا المشروع، ذلك بالذات هو أن إجماع التقييمات غير الواعي -وهو إجماع يخفي اختلافات الرأي الخاصة -إجماع مقيد، لعل ما يثير اهتمام المطلع على تقارير طلبة ريشاردس حول القصائد المعنية هو عادات الإدراك والتأويل المشترك بينهم اشتراكا عفويا، أي ما يتوقعون أن يكونه الأدب، وافتراضاتهم فيما يخص قصيدة ما، والتحققات التي يتوقعون استشفافها منها. وفي الحقيقة ثمة مفاجأة في كون جميع المشاركين في هذه التجربة -تخمينا- شبابا بيضا ينتمون إلى طبقة عليا أو عليا متوسطة، وتلاميذ تلقوا تعليمهم بالمؤسسات الخصوصية في عشرينات هذا القرن؛ ومن ثم فإن رد فعلهم إزاء قصيدة ما متعلق، في قسطه الأوفر، بشيء يتجاوز العوامل >الأدبية< المحضة. ذلك أن رد فعلهم مجدول جذلا مع أحكامهم المسبقة ومع معتقداتهم. ليس هذا من التوبيخ في شيء إذ لا يوجد رد فعل نقدي غير مجدول، وهكذا لا يوجد شيء إسمه حكم أو تأويل أدبي >خالص<، وإذا كان هناك من يستحق التوبيخ فهو ريشاردس نفسه الذي كان -باعتباره شابا أبيض ينتمي إلى طبقة عليا متوسطة، ومحاضرا في جامعة كامبريدج- عاجزا عن النظر نظرة موضوعية إلى سياق اهتمامات طلبته التي لا تختلف كثيرا عن اهتماماته، ومن ثم عاجزا عن الإقرار بأن الفروق >الذاتية< والمحلية لعملية التقييم المبنينة بنينة اجتماعية، تشتغل بطريقة خاصة لإدراك العالم.
إذا كان عدم النظر إلى الأدب باعتباره مقولة >موضوعية< وصفية أمرا محبذا، فينبغي القول إن الأدب هو بالذات ما خصه الناس، على نحو غير مفهوم، باسم الأدب. إذ ما وجه الغرابة في أحكام القيمة هذه إذا علمنا أن جذورها ضاربة في بنيات اعتقادية عميقة وراسخة، مظهريا كعمارة Empire state (أعلى ناطحة سحاب في مدينة نيويورك). إن ما لم نمط عنه اللثام بعد لا يتمثل فحسب في أن الأدب لا يوجد بالمعنى نفسه الذي توجد به الحشرات، وأن أحكام القيمة التي تكونه متغيرة من الزاوية التاريخية، وإنما يتمثل أيضا في أن أحكام القيمة هذه بذاتها لها علاقة وثيقة مع الإيديولوجيات الاجتماعية. إنها تحيل، في نهاية الأمر، لا إلى ذوق خاص فحسب، وإنما إلى المسلمات التي بها تحافظ بعض الفئات الاجتماعية على السلطة وتمارسها على الآخرين.
———————————————
الهوامش
1) انظر :
M.I. Steblin-Kamenskij :The saga Mind (Odense 1973)
2 ) انظر
Lennard J.Davis : ASocial History of Fact and fiction Authorial disavowal in the English Novel, In Edward W Said (ed) Literature and Society (Baltimore and London 1980)
3) The theoty of Literary Criticism : A Logican Analysis (Berkeley, 1974 ), pp. 37-42