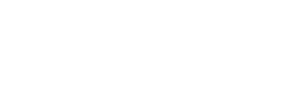كمال التومي
مدخل
ارتأينا أن نتوقف في هذه الورقة عند رأي المفكر عبد الله العروي من ظاهرة التجريد في الرسم المغربي، لما أثاره هذا الموقف من ردود فعل غالبا ما اتسمت بالتجاهل أو بسوء الفهم. ونحن إذ نتعرض لهذا الموقف دون أن نعتمد إطلاقا منطق المناظرة العقيمة – لأنه منطق غير مفيد – نرغب أن نتجاوز، بالحوار والتفكير، أحد الأسباب التي أجلت مناقشة أهم ظواهر الرسم المغربي مناقشة عميقة وهادفة.
قد يؤاخذنا القارئ بأننا سلكنا طريق الدفاع المطلق والكلي عن موقف العروي. ربما كان الأمر كذلك، إلا أننا نود توضيح أمرين إثنين :
1- لجأنا عمدا، في إعادة تركيب موقف العروي، إلى تقديم بعض الفقرات كاملة، ترجمنا بعضها عن الفرنسية وأخذنا البعض الآخر من مؤلفاته بالعربية، لا جهلا بقواعد الكتابة ولكن لتفادي التحريف والتشويه اللذين تتسبب فيهما عملية التلخيص المغرض أو عملية الاستشهاد بفقرات مفصولة عن سياقها العام.
2- لعله من المفيد أن نسلم بأن كل مناقشة عميقة وهادفة لظاهرة التجريد في الرسم المغربي تفرض ربط هذه الظاهرة بالمحيط الثقافي العام ( ذهنية، سياسة، تربية، تاريخ، التعبير عن الذات …) وإلا صارت مناقشة عقيمة للجزئيات لا للإشكاليات، و انحرفت نحو تركيز وعبادة المطلقات التي نضيع ونفنى فيها بدون وعي.
1- العروي : آفتنا الكبيرة هي التجريد
عندما خصصت مجلة Librement في عددها الأول ( والأخير !) سنة 1988 ملفها للثقافة المغربية ” نظرات على الثقافة المغربية “، أجرى عادل حجي حوارا مطولا مع عبد الله العروي وضعت له هيئة التحرير عنوان : “مديح اللا-طمأنينة” Eloge de l’in-quiétude كان السؤال الأخير الذي طرحه عادل حجي يتعلق بالرسم المغربي وكان جواب العروي كالتالي، نقدم نص ترجمته هنا كاملا ” :
يجب التمييز هنا بين مفهوم الحداثة ومفهوم ” الموضة ” أو مفهوم المعاصرة. يوجد خلف الفن التجريدي تاريخ طويل. إنه التاريخ الذهني والروحي للغرب المسيحي. ليس الجديد هوالحداثة أو على الأقل لا يتطابق بالضرورة معها. الفن التجريدي هو نتيجة تطور. في المغرب فهم هذا الفن باعتباره تقنية وليس قطعا باعتباره فلسفة.
ما ألاحظه بصدد الرسم التجريدي بالمغرب، هو ما كنت آسف له بخصوص الرواية. غياب تشخيص ( تمثيل ) مباشر للواقع. مانشاهده وما نتأمله هو مجموعة من التشخيصات ( التمثيلات ) الذهنية للواقع وهذا أمر مألوف في ثقافتنا. لقد كان لنا دائما موقف سلبي تجاه الطبيعة وذلك لأننا لا نرغب أن نرى فيها إلا أثر الخالق.
ما يحزنني، هو أنه إذا أردنا بعد خمسين أو مائة سنة أن نكون فكرة عما كان عليه المشهد الطبيعي المغربي، عما كانت عليه الطبيعة المغربية فلن نستطيع أن نطلب من الرسم أن يساعدنا على ذلك. كيف كانت الطبيعة في ضواحي الرباط أو الدار البيضاء؟ أمام هذا السؤال سيبقى الرسم صامتا.
إن هذا النوع من الضعف بالضبط هو ما أكدته عند حديثي عن الرواية. لا يوجد هناك عمق ولا تنوع ولا التقاء مباشر مع الواقع. أكنا في الخرطوم أو القاهرة أو بغداد أو الرباط، فإن المونولوغ هو الذي يهيمن دائما. أن تكون الشخصيات قليلة التماسك والسمك، هذا أمر عادي، ولهذا السبب نجد روايات عربية كثيرة تجريدية جدا بكيفية منفرة وسطحية جدا. أن لا تمنح أبدا جائزة نوبل في الأدب لأديب عربي ليس في هذا ظلم غير مبرر. إن آفتنا الكبيرة أتعلق الأمر بالفن أو الأدب أو الفلسفة أو التاريخ، هي التجريد والعجز عن ملامسة الواقع. إنها معضلة الثقافة العربية الكلاسيكية في مجملها، معضلة الإنسان العربي.
ليست الأفكار( المعاني ) إلا وسائل الغرض منها تسهيل استعادة الحاضر لاحقا. لكن يبدو ، بكيفية غريبة، أننا نبذل مجهودا كبيرا جدا كي لا يبقى شيء من آثار حاضرنا، أكان ذلك على مستوى الحياة الفردية أو على مستوى الحياة التاريخية. منذ الوهلة الأولى، نأخذ موقعنا داخل الخلود، وكأننا نريد أن نقول للآخرين > انتبهوا ! لا تحكموا علينا من زاوية التاريخ، لأننا نوجد خارجه <. أيمكن أن نتصور التهكم خارج الحداثة ؟ لا يوجد تهكم عند أفلاطون…الحكم المطلق والإطلاقية الفلسفية تنبذ التهكم في حين إنه بعث وتجديد للنسبية. رفض الحياة، هذا ما نفعله عندما نتموقع بالقوة في الخلود، ويحدث هذا حتى بدون أن ندخل الكون فيه. أيكون للفن موقع في مثل هذا التصور.(1)
2- م العروسي : العروي يتشبث بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء
في صيف 1990 خصصت مجلة الوحدة ( المجلس القومي للثقافة العربية ) عددها 70 – 71 لموضوع ” التأصيل والتحديث في الفنون التشكيلية “، وقد أسهم فيه موليم العروسي بمقالة تحمل عنوان ” من الرسم إلى فلسفة الفن ” ( ص ص 17 – 23 ) وأعاد نشرها سنة 1996كما هي في كتابه ” الفضاء والجسد ” . في هذه المقالة التي تتناول، من زاوية فلسفية، بعض المفاهيم الجمالية ( الجمال ، الجميل ، الفنان ، النقد الفني) يمكن اعتبارها ردا مباشرا على ما صرح به عبد الله العروي لمجلة Librement. كتب موليم العروسي :
إذا كان الفن الإسلامي قد تشبث بانتهاك المحرم في بلاد الهند وفارس ( حسب الروايات التاريخية والوثائق المتوفرة) من خلال الصورة التشخيصية، ثم في بلاد المشرق العربي في الشام وبلاد ما بين النهرين بنفس الطريقة، فكيف كان الأمر في بلاد المغرب العربي ؟
لأجيب على هذا السؤال سأقتصر على الفن بمفهومه العام أو ما يسميه البعض بالفن الرسمي بحكم أنه كان إما مدنيا (حضريا ) أو يمارس في البلاطات.
لقد انتظرنا طويلا في بلدان المغرب العربي لنفهم هذه المشكلة ونفهم في ضوئها مشكلة الفن في العالم الإسلامي، وحتى الآن لازال جل الباحثين، إن لم يكن كلهم يصرون على إقصائنا من تاريخ الفن الكوني بدعوى أننا لم نتوفرعلى تقليد تشخيصي، وهو في نظرهم ممر مفروض للفن التجريدي. هل يعني هذا أننا كنا الأكثر تطبيقا للإسلام بشكل تبسيطي ؟ في هذه النقطة بالذات يمكن لتدخل الفلسفة، وفلسفة الفن بالخصوص، أن يكون حاسما، وأن يكون سؤالها مركزيا.
هل من الضروري لشعب معين أن يتلمس طلعته في مشاهد طبيعية أو في صور تشخيصية حتى يكون فنانا ؟ ( أقول هذا دون أن أشير إلى التقاليد الشعبية التشخيصية التي تفيض بها بوادينا وقرانا من الخليج إلى المحيط ) ألا نكون قد اكتشفنا، ومبكرا، الطريق الصحيح والعميق للفن ؟
في هامش هذه الفقرة المقتطفة، يستطرد موليم العروسي قائلا :
من بين هذه المواقف التي تعتبر مقاومة نفسية بشكل آخر، موقف الأستاذ عبد الله العروي في استجواب له مع مجلة Librement العدد الأول 1988 بالفرنسية. يقول : > ما ألاحظه بصدد الرسم التجريدي بالمغرب هو ما كنت أرثي له بالنسبة للرواية : غياب تمثل مباشر للواقع ( …) لقد كنا دائما سلبيين تجاه الطبيعة بمعنى أننا لا نريد أن نرى فيها سوى أثر الخالق. ما يحزنني هو أنه إذا أردنا بعد خمسين أو مائة سنة أن نكون فكرة عن المشهد المغربي، عن الطبيعة المغربية ، فلن نستطيع أن نطلب من الرسم أن يساعدنا على ذلك : كيف كانت الطبيعة في محيط الدار البيضاء أو الرباط؟ أمام هذا السؤال سوف يبقى فن الرسم أبكم. بكم الرسم هذا مأخوذ مباشرة من فيدروس، كتاب أفلاطون؛ لا يهم ! ما يهمني هنا في موقف العروي هو تشبثه بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، إنه هوس لا يفهم ربما إلا من جهة التحليل النفسي، وكأنني به في مسحه للأشياء القديمة من ذاكرته لأنها تخذش وجهه في المرآة يطالب الفنانين أن يؤسسوا له ماضيا في مستقبل وهمي حتى يتوافق ( أو يتدوزن بلغة الموسيقى ) مع تاريخ أوروبا. أرجو القارئ حتى يفهم ما أقوله عن > خدش الوجه في المرآة < أن يرجع إلى البحث الذي قدمته في نوفمبر 1988 بجرجيس بتونس خلال ندوة >الثقافة والمقاومة بالمغرب العربي <، وفيه أتعرض بصفة خاصة إلى موقف الأستاذ العروي من التمظهرات الثقافية الشعبية بالمغرب.(2)
3 – إضاءة أولى
ما يهمنا بدورنا من حديث عبد الله العروي ورد موليم العروسي عليه هو سوء التفاهم حول ظاهرة التجريد في الرسم المغربي . مرد سوء التفاهم هذا هو أن مؤلف “مفهوم العقل” ينطلق من التاريخ ومن تصور خاص لدور المثقف والثقافة في المجتمع بما هي سيرورة تربوية شاملة وعميقة وواعية غايتها تدارك التأخر التاريخي؛ بينما ينطلق مؤلف “الفضاء والجسد” من أرضية فلسفة الفن ( علم الجمال ) ومن تصور خاص للفنان والفن بما هو تحرير للجسد من الكبت الذي مورس عليه، بهذا المعنى يغدو الفن انتشارا للرغبة المقموعة.
قد يبدو أن سوء التفاهم هذا اختلاف ظاهري وسطحي يتعلق بقضية لطالما شكلت موضوع العديد من المتابعات والأحاديث التي تدور حول ثنائية التجريد/التشخيص في الفن العربي الإسلامي.كما لو أن الفنان هو الذي يقرر ويختار التجريد أو التشخيص أو هما معا بمحض إرادته، بمعنى أن الأمر يتلخص في اختيارات فنية تقنية أسلوبية مؤقتة أو نهائية ، محسوم في أمرها على صعيد التصورالذاتي ومتجلية في أعمال فنية مكتملة فردية أو جماعية.
– حين يلاحظ عبد الله العروي ويستنتج أن “آفتنا الكبيرة هي التجريد والعجز عن ملامسة الواقع”، أيتشبث حقا بـ “إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء” ؟
– أنكون تقدمنا في ممارستنا الثقافية وإنجازاتنا الفكرية والفنية قليلا إلى “الأمام” حتى نعود القهقرى إلى الوراء “؟
– أفي الإسقاط المستقبلي للعروي ما يدل على أنه فعلا ” يطالب الفنانين بأن يؤسسوا له ماضيا في مستقبل وهمي حتى يتوافق مع تاريخ أوروبا” ؟
الظاهر أن حكم موليم العروسي على ع العروي يوحي بأن هذا الأخير صاحب نزعة “سلفية” تحكمها إرادة التقليد والاتباع، إرادة تجعله يعتبر التقدم – الذي قد يكون حققه رسامونا التجريديون – بدعة وبالتالي تجعله يقاوم هذا “الضلال المبين “.
من الواضح أن فهم الموقف الفكري لعبد الله العروي من ظاهرة التجريد في الرسم المغربي يتطلب منا استجلاء وإعادة بناء هذا الموقف. ولا سبيل إلى ذلك سوى العودة إلى بعض ما كتبه سابقا أو لاحقا أو ما تحدث به هنا وهناك. فرغم أننا لن نورد كل الإشارات ونسوق كل التنبيهات ، سيتضح أن العروي لم يتنكر أبدا لملاحظاته وتحليلاته وتأملاته أكنا نوافقه على نتائجها أم لا .
يجب التأكيد أن تحليل العروي لظاهرة التجريد في الرسم المغربي يأتي في سياق/سياقات مقاربته لأزمة الثقافة العربية في تجلياتها ومظاهرها، في نتائجها وإفرازاتها المادية والرمزية والفكرية والسلوكية. ومعلوم أن مقاربة أزمة الثقافة العربية وأزمة المثقف العربي ( والمثقف هنا قد يكون فيلسوفا أو عالم اجتماع أو قصاصا أو مؤرخا أو رساما …) تتم لدى العروي في نطاق تحليل للايديولوجيا العربية المعاصرة. لهذا السبب، فتحليل العروي لظاهرة التجريد يندرج ضمن مشروع تفكيك جزء من ذهنية المثقف العربي التي يحكم عليها بأنها تستند إلى فكر لاتاريخي منفصلة عن الواقع وعاجزة عن إدراكه، نمت وتطورت في ظل إخفاقات الماضي وانحرافات الحاضر.
تغدو صورة الواقع في هذه الذهنية صورة معكوسة ، مشتتة وغير واضحة مهما تعدد وتغير وتطور هذا الواقع. ولأن هذه الذهنية تستوحي ، على صعيد التعبير الفني، أدوات وأشكال تعبيرية دون التعمق في جذورها وأصولها ، فإنها تنتج تعبيرا غير مطابق للتجربة الإنسانية والوجدانية بل مفارقا لها. نكتفي هنا بالإشارة إلى أن العروي يتعرض لهذه القضية بتفصيل وإسهاب في كتابه “الأيديولوجية العربية المعاصرة” وخصوصا في الفصل الأخير منه ” العرب والتعبير عن الذات “( 3 ).
4 – إضاءة ثانية
يتعرض عبد الله العروي في كتابه ” ثقافتنا في ضوء التاريخ ” لثلاثة مجالات : التاريخ والعقل والثقافة. وفي هذاالمجال الأخير يتعرض في الفصل الثالث لأزمة المثقف العربي. فبعد التمهيد المنهجي الذي يؤكد فيه الطابع الإشكالي والمركب للموضوع، وبعد تعريف مفهوم المثقف ورصد نشأته، يخلص العروي إلى سمتين تميزان المثقف العربي الذي يعيش أكثر من أزمة وعلى أكثر من صعيد :
1- سمة البؤس التي تدفع المثقف ( كان عصريا أم تقليديا ) إلى اليأس من إصلاح شؤون المجتمع، يأس يقوده إلى الانعزال.
2- سمة الجهل بالمحيط الطبيعي والتاريخي، وهذا الجهل يساعد على نمو وتكريس ذهنية التجريد، ذهنية منفصلة عن الواقع. وحيث إن هذا الواقع مفكك ومتناثر ومهدد بانقسامات ، فإن هذه الذهنية التجريدية تغدو ذهنية نسيان وتناسي، تسطيح وانتقاء. لا سبيل إلى إنكار أن الأعمال الناتجة عن هذه الذهنية أعمال مسطحة وأحادية الجانب، تصير وسيلة للتحريف والتشويه (مثال توظيف الحرف العربي عند بعض الفنانين بدعوى تأصيل فنهم). >إن المثقف العربي، نظرا لتكوينه المجرد يميل، يقول العروي، إلى اعتناق أي مذهب يظهر في السوق. وهذا ما عبرت عنه بالانتقائية التي لا تمثل ظاهرة انفتاح وتوازن بقدر ما تشير إلى استقلال المثقف عن مجتمعه وعدم تأثيره فيه<. (4) ليست الانتقائية المظهر الوحيد لانفصال المثقف عن الواقع ، بل هناك مظهر آخر يعززه ويعمقه يتمثل في السلفية. الانتقائية والسلفية تنفيان التاريخ هروبا من التغير ولا سبيل إلى تجاوزهما سوى التسلح بالوعي التاريخي الذي بفضله >سنكتشف حالا أو سنعي لأول مرة ذوانا الحقيقية، المطابقة لمركزها في الوقت الراهن، في الآن والمكان”(5)
5 -إضاءة ثالثة
ماذا يحصل عندما يفكر المثقف في كسر طوق العزلة، وطوق أزمته الذاتية فينخرط، عبرالبحث والإبداع، في بناء ثقافة ذات مضمون قومي (مستندا إلى المضامين والتعابير التي تشكل ما نطلق عليه الثقافة الشعبية) ظنا منه أن هذه الثقافة هي التي تعبر عن كنه وخصوصية المجموعة البشرية التي ينتمي إليها وعن نظرتها إلى الحياة؟
من المفيد هنا الرجوع – وبتأني – إلى “العرب والفكر التاريخي” في مجمله، وبالخصوص إلى فصله الثالث المعنون بـ : “المضمون القومي للثقافة”(6). إن الجواب المركب للعروي على هذا السؤال قد يبدو جوابا قاسيا وعنيفا يضع كل مثقف غير مسلح بالوعي التاريخي في مأزق تاريخي لا يحتمل. فبعد تأطيره النظري للإشكالية التي يطرحها كل ربط بين “القومية” و”الثقافة” وبعد تقديم ومناقشة النموذجين الألماني والروسي اللذين نجحا تاريخيا إلى حد بعيد في إعطاء مضمون قومي حقيقي وعميق للثقافة، يخلص العروي إلى أن كل تجديد ثقافي عن طريق الفنون الشعبية يعني :
1- السقوط في أسر المنظور الإثنولوجي للثقافة سينتج عنه خلط بين الفولكلور والثقافة
2 – إنتاج ثقافة منعزلة وخاصة جدا تنعدم فيها خاصية الحياة والعمق والغزارة ولا تعبر نتيجة لذلك عن تجربتنا الإنسانية العميقة وعلاقتها بالتجارب الإنسانية الأخرى.
لا يكتفي العروي بالوقوف عند النتائج التي يؤدي إليها هذا التصور الإثنولوجي للثقافة بل يذهب إلى مطالبة المثقفين بنهج طريق جديد بعيدا عن إرادة الاستعادة التكرارية.
إن خلق ثقافة منا وإلينا وحدنا، هو في الواقع خلق فلكلور جديد لا أقل ولا أكثر. إن موقفنا اليوم يتلخص في رفض تراثين : تراث الثقافة المسيطرة على عالمنا الحاضر التي تدعي العالمية والإلمامية وتعرض نفسها علينا إلى حد الإلزام والضغط ولا تفتح لنا سوى باب التقليد أو الاعتراف بالقصور، وتراث ثقافة الماضي الذي اخترناه تعبيرا لنا في عهودنا السابقة لكنه لم يعد اليوم يعبر عن جميع جوانب نفسياتنا ….]
لا بد إذا من إبداع اتجاهه ثالث مبني على التجربة والمخاطرة. لكن يجب ألا ينحصر هذا الاتجاه في البحث عن خاصيات قوميتنا والتعبير عنها لأن ذلك انزواء وفلكلورية. الخاصية ليس معناها حتما الرفض والمغايرة. قد تكون أيضا، كما رأينا، في القبول والإتمام. ليس من الضروري أن نبدأ برفض أشكال الثقافة المعاصرة، بل يمكن ويجب أن ننطلق منها، محاولين تعميقها وتوسيع نطاقها، مظهرين أن هذه الثقافة التي تدعي العالمية ليست عالمية تماما، تنقصها تجربة، هي تجربتنا التي، إن نجحنا في تشكيلها، ستكسب مدلولا عاما. وهذه التجربة يجب أن تتبلور في شخصية جديدة، في موقف جديد وفي تعبير جديد ( التشديد من عندنا ) ( 7) .
يضع العروي ثلاثة شروط لنجاح هذا الاتجاه الجديد المبني على التجربة والمخاطرة .
أ- معرفة معطيات الثقافة الحديثة.
ب- معرفة تجربتنا التاريخية في كل مظاهرها
ت- إذكاء الوعي .
6- إضاءة رابعة: أزمة التشخيص
قد يكون من الواجب الوقوف عند تأملات العروي في السينما وقد يكون من المفيد أيضا أن نقف عند بعض الإنجازات التي تحققت على صعيد الفوتوغرافيا بالمغرب، لكن المجال لا يسعف. لهذا السبب سنقتصر على حقل الرواية لنسجل أن تحليل العروي يتقاطع، بهذا الشكل أو ذاك، مع أقوال وكتابات بعض الروائيين المغاربة. ونخص بالذكر أولئك الذين جاءت كتاباتهم الروائية مقاربة وملامسة بكيفية تجريبية (8) لبعض مظاهرالأزمة التي يعرفها المجتمع المغربي والكائن المغربي (الحب، والمودة، والفن، واللغة، والطفولة، والإسم …) هؤلاء الروائيين. وهم يحاولون تلمس طريقهم للعقدة التاريخية للشعب المغربي،(9) نادوا بضرورة التشخيص أو على الأقل وعوا بأن من بين الأزمات التي يعرفها المجتمع المغربي على صعيد الثقافة والتعبير أزمة التشخيص. وإذا لم يتبلور هذا الوعي ليتجلى في أعمال فنية كثيرة، فإنه سيظل مع ذلك علامة من العلامات المميزة للثقافة المغربية في التسعينات.
قبل وبعد صدور روايتيه “شجر الخلاطة” ( 1995) و”خميل المضاجع” ( 1997) ما فتئ الميلودي شغموم يتحدث عن ضرورة التصالح مع النفس وعن ضرورة كتابة رواية التفاصيل.
يؤكد محمد برادة من جانبه عندما تحدث عن روايته الثانية وعندما فتر انشغاله بمصر :
وجدت أن وراء “الضوء الهارب” ( 1993) إحساسا طاغيا وقويا لما يشكل في نظر الآخرين بالأزمة التي أعيشها شخصيا ويعيشها آخرون في المغرب منذ الثمانينات على الأقل. كيف أعبر عن هذه الأزمة ؟ ضمن هذا التفكيرالسريع خطر لي أن مصدر الأزمة هو انعدام التشخيص، ذلك الذي يحيل على الإنسان وعلى بيئته وتفكيره وإيديولوجيته انطلاقا من الملبس وكل الأشياء التي تشخص وجوده داخل بيئته ومجتمعه، بهذا المعنى هناك غياب وتغييب للتشخيص في مجتمعنا(10)
ومن جهته يجزم عبد الفتاح كيليطو أن العرب لا كتاب لهم حتى يتعرفوا فيه على أنفسهم :
فمن جهة لا يقبل العرب صورتهم الماضية التي يقدمها لهم الحريري (باعتباره صورة رمزية لكتابة بالية ) لكنهم من جهة أخرى، ينقادون بصعوبة إلى التسليم بأن إنتاجهم الأدبي لم يعد سوى انعكاس باهت للأدب الغربي. لذلك لا يتبنون نموذجا لهم “ألف ليلة وليلة” ولا المقامات ولا الأدب الغربي. وفي نهاية المطاف، فإن غياب كتاب نموذجي يتطابق مع غياب نموذج. بالنسبة لعرب اليوم الكتاب هو ما لم يعد موجودا وما لم يوجد بعد. (11)
الظاهرأن العرب لا كتاب لهم، والظاهر أن العرب لا صورة لهم. في مقدمة روايته La querelle des images يؤكد كيليطو أن أجدادنا لم يكن لهم وجه (صورة) والسبب هو أنهم استطاعوا الاستغناء عن الصورة:
كل ما أرغب في معرفته – يقول كيليطو- هو الكسب الذي حققه العرب بامتناعهم عن التشخيص في ميدان الرسم” و”وربما سيكون ضروريا في يوم ما أن نتساءل عما خسره عرب اليوم بدخولهم عصر الصورة.الشيء المهم هو أن الصورة فرضت نفسها عليهم بالضبط في الوقت الذي التقوا فيه بالآخر، في الوقت الذي نضبت فيه صورتهم بمجرد احتكاكهم بصورة هذا الآخر. (12)
خلاصتان
1- أيكون بمقدورنا أن ندعي أن تأسيس علم جمال ممكن أو محتمل على أرض المغرب ونحن نصوغ أسئلتنا ونحاول الإجابة عنها، انطلاقا من إشكالية ثقافة بصرية تنزيهية شرقية؟ نميل إلى القول إن هذه الثقافة هي التي تفرض اليوم علينا لغتها الصوفية وتفرض أسئلتها الخادعة وجزئياتها المغرية (الغيب، المغرب، غروب الشمس، العين الحميئة، المقدس، المدنس، السواد، النور، الظلام، الضوء، الظل، القبض على الله، تكليم الله، تكتيب الله، الحجاب، التجلي، تشخيص النور، التشبيه، التنزيه، التصوير، التحوير، الخ ).
يستسلم رسامونا بفرح وطمأنينة أحيانا وبحماس وقدرية أحيانا أخرى لأحكام ومنطق هذه الثقافة في إطار تراض وتوافق جماعي على تعبير تجريدي – مهما تعدد وتنوع – وعلى مواضيع تجريدية -مهما اختلفت وتباينت- ويواجه النقد هذا التعبير وهذه المواضيع بأسئلة تجريدية ويرد عليها بأجوبة تجريدية.
هذه النظرة السكونية (إبداعا ونقدا، إنتاجا ومتابعة) لا تعرف التناقض بل، إنها عين التوافق والتعايش، لن ترسم للفن على أرض المغرب طريق المغامرة والتجريب، بل ستكرس رفضه للحياة ومناقضته للواقع، بل ستكرس انكفاءه وانعزاله ولن تضمن له لا الخلود ولا العالمية اللذان يتوق إليهما.
2- الوعي بحاجتنا التاريخية إلى التشخيص ما زال وعيا في طور التشكل والتبلور. من الواضح أنه إذا لم يكن هذا الوعي مقرونا ومتبوعا بالتجريب الدائم والمفتوح والهادف، فسيظل ناقصا وستظل معه الدعوة إلى التشخيص دعوة مطروحة على جدول أعمال ثقافتنا، دعوة تبحث عن مناداها ومداها، وتبحث عمن يعطيها صدقيتها التاريخية، فكرا وممارسة، بعد أن تكون قد عبرت لمدة تقصر أو تطول، قنوات الوعي الشقي.
—————————————
الهوامش
1-Laroui , A ; ” Eloge de l’in-quiétude ” ( Entretien ) , in Librement , Regards sur la culture Marocaine, no 1 , 1988 , 97 – 100
2 -موليم العروسي : الفضاء والجسد، منشورات الرابطة ، الدار البيضاء 1996، ص ص 59-60 وص 173
3- في سنة 95 أصدر علبد الله العروي صياغة جديدة لكتابه الإديولوجيا العربية المعاصرة ، وبعيد ا عن التفسيرات التي يسوقها العروي في مقدمة الكتاب، ألا يكون إصداره من جديد دليلا على أن راهنيته مازالت قائمة وأن ماما كان من شأن ومصير ثقافتنا، يفرضان حاجتنا إليه اليوم قبل غد رغم العناد والتجاهل.
4- عبد الله العروي ، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركزالثقافي لعربي ، ط 3 ، الدار البيضاء ، 92، ص 208
6- نفسه صص 99 – 116
7- نفسه ، صص 113 – 114
8- بصدد تحديد العروي لمفهوم التجريب انظر : محمد الداهي ، العروي منالتاريخ إلى الحب ( حوار )، منشورات الفنك ، الدار البيضاء ، 1996 ، ص 44
9- سيجد القارئ تحديدا للعقدة التاريخية في ص 46 من المرجع السابق.
محمد برادة ” الكتابة والتشخيص .. والأزمة ” ضمن وقائع ندوة رهانات المتابة عند محمد برادة ، منشورات مختبر السرديات، كلية الآداب بنمسيك 1995 ، صص 25 – 56
11- عبد الفتاح كيليطو ، لسان آدم ، ترجمة عبدالكبير الشرقاوي، منشورات ، توبقال ، المحمدية ، 1995 ، 76.
12- Kilito , A : La querelle des images , Ed Eddif , Casa , 1995 , pp 9 -12