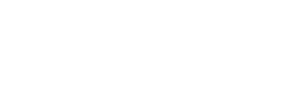سعيد بنگراد
في نهاية الستينيات من هذا القرن أبدى بنفنيست ( E . Benveniste ) استغرابا كبيرا – وهو يقدم بورس إلى الباحثين الفرنسيين – من وجود نسق سميائي متسيب لا تحكمه حدود ولا ضفاف ولا تخوم. فهذا النسق الذي يرى في العلامة أساس الكون كله، في التصنيف والتعريف والاشتغال، لا يمكن أن يكون منطلقا صلبا لسيرورة التدليل التي تعد الغاية النهائية من وجود أي نسق. فمادام ” الأول ” يحيل على ” الثاني” عبر ” ثالث” هو نفسه قابل لأن يتحول إلى ” أول” يحيل على ” ثان” عبر ” ثالث” جديد، فإن إمكانية اكتفاء العلامة بذاتها أمر مستحيل. والخلاصة أن هذا > الصرح السميائي الذي شيده بورس لا يمكن أن يستوعب نفسه بنفسه. فلكي لا تندثر العلامة داخل هذا التوالد اللامتناهي، يجب الإقرار، في لحظة ما، بوجود اختلاف بين العلامة والمدلول< (1) .
إن استغراب بنفنيست من غياب هذا الاختلاف، ومن وجود كيان علامي يتطور بشكل لولبي في اتجاه آفاق دائمة التجدد ضمن نسق “يوضح نفسه بنفسه” كما يقول إيكو، يعد، عكس ما تصور بنفنيست، دليلا على أصالة هذا الصرح السميائي وغناه. فما يبدو وكأنه سلسلة من الإحالات التي لا يحكمها ضابط ولا رادع، هو ما يشكل الإضافة الحقيقية التي تضمنها تعريف العلامة عند بورس. فمقولة المؤول – الحجر الأساس في أي تعريف للتدليل – يشكل نقطة الارتكاز الأولى في تعريف العلامة وفي وجودها وفي أشكال تجلياتها. فما دام التوسط (الأشكال الرمزية على حد تعبير كاسيرير)، هو المبدأ المركزي في إدراك العلاقة بين الذات وما يوجد خارجها، فإن المؤول هو المصفاة التي يتم عبرها تسريب الصور المتنوعة التي تتزيي بها الموجودات “الواقعية منها والمتخيلة، أوالقابلة للتخيل أو غير القابلة للتخيل ” كما كان يحلو لبورس أن يقول.
1- المقولات واللامتناهي والعلامة
إن هذا التصورالخاص للعلامة هو مدخلنا الرئيس للحديث عن مفهوم غني للتأويل انطلاقا – بالتحديد – مما أثار استغراب بنفنيست واندهاشه. وهو نفسه الذي سيتيح لنا فرصة استحضار نمط آخر للتدليل عبر إقامة رابط بين مفهوم المؤول هذا وبين آليات إنتاج الدلالة كصلة وصل دائمة بين مادة منظمة للأكوان القيمية العامة، وبين أشكال التجلي التي تعد أفقا دائم التجدد. ومن أجل توضيح ذلك سنعمل على تحديد مفهوم العلامة ضمن السيروة التي يطلق عليها بورس السميوزيس ( sémiosis )، أي السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالة وتداولها.
بدءا تجدر الإشارة إلى أن تكوين العلامة الثلاثي ( ماثول – موضوع – مؤول) هو بالتحديد استعادة للتقسيم الثلاثي الذي يحكم عملية إدراك الكون وضبط قوانينه. والأمر هنا يخص المقولات الفينومينولوجية التي يحددها بورس في أولانية وثانيانية وثالثانية. وبناء على هذا، فإن استيعاب كنه العلامة وطرق اشتغالها ونمط الإحالات داخلها مشروط بفهم إواليات الإدراك الذي يستند، عند بورس، إلى النوعية والأحاسيس ( أول )، وإلى الموجودات الفعلية ( ثان )، وإلى رابط الضرورة والفكر والقانون ( ثالث). ومن السهل جدا وضع هذا الترابط ضمن منطق الإحالات الخاصة بالعلامة : فالأول يحيل على الثاني عبر أداة التوسط التي يمثلها الثالث. وبعبارة أخرى، فإن الأحاسيس والنوعيات هي معطيات عامة ( أول) تُصب في الموجودات الفعلية ( ثان ) وذلك عبر قانون يضمن دوام الإحالة وتحديد وجودها استقبالا (ثالث).
إن هذا النمط الثلاثي في الإحالة هو أساس وجود العلامة. فالماثول (représentamen) يحيل على موضوع ( objet) عبر مؤول (interprétant) وفق شروط الفعل المركب للإدراك. وهذا معناه النظر إلى الدلالة باعتبارها سيرورة في الوجود وفي الاشتغال، وليس معطى جاهزا يوجد خارج الفعل الإنساني.
ودون أن نقف طويلا عند نظرية المقولات وأسسها المعرفية (2)، يمكن القول، انطلاقا مما توفره هذه النظرية ذاتها، إن العلامة هي نمط خاص للتركيب يتم انطلاقا منه تنظيم الواقع وفق وجود أقسام من التمثيلات العلامية الذي يغطي مناطق من المعيش والمحسوس والمتخيل. وإذا كان هذا التركيب، استنادا إلى ما قلناه سابقا، كيانا ثلاثيا هو الآخر، فما هو الشكل البنائي المؤسس للعلامة باعتبارها أداة مركزية في إنتاج الفكر والخروج من الذات للدخول في حوار مع “عالم الأشياء” ؟.
إن أول تعريف يخص به بورس العلامة هو تعريف مستوحى، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، من الترابط الثلاثي بين عناصر الإدراك الأساسية. فـ” الفكر ( الذي هو من نظام الثالثانية) يستحوذ على الموجودات ( التي هي من نظام الثانيانية ) عبر الممكنات ( التي هي من نظام الأولانية ) (3). وانطلاقا من هذا التوزيع، فإن > العلامة أوالماثول ( 4) هي شيء يعوض بالنسبة لشخص ما شيئا ما بأية صفة وبأية طريقة. إنه يخلق عنده علامة موازية أو علامة أكثر تطورا. إن العلامة التي يخلقها أطلق عليها مؤولا للعلامة الأولى، وهذه العلامة تحل محل شيء يعد موضوعها. وهذا الحلول لا يستوعب مجموع مكونات الموضوع، بل يتم عبر فكرة أطلقت عليها أحيانا “عماد ” (fondement ) الماثول< (5). يضعنا هذا التعريف أمام هرم يتكون من ثلاثة عناصر تحكمها غاية واحدة، وتتوزع في التمثيل والتدليل وفق نفس الغاية ووفق قوانينها، أي التمثيل لشيء يمكن استحضاره من خلال شكل أو أشكال رمزية. فـ “الماثول” هو الأداة التي نستعملها في التمثيل لشيء آخر يطلق عليه بورس “الموضوع” وفق ظروف خاصة في الإحالة يوفرها “المؤول” باعتباره الشرط الضروري للحديث عن بناء علامي قادر على الاكتفاء بنفسه والتخلص من مقتضيات الـ”أنا” والـ “هنا” والـ”الآن”. والمؤول داخل هذه البنية هو الفكر الذي يحول التجربة الصافية المحصل عليها عبر إحالة ماثول على موضوع، إلى نموذج تجريدي تستعاد عبره كل التجارب المشابهة. ويمكن أن نمثل لهذا الترابط بين العناصر الثلاثة للعلامة من خلال الشكل التالي :
مؤول
ماثول موضوع
وكما هو واضح من تعريف بورس للعلامة، فإن > الماثول مرتبط بثلاثة عناصر : عماد وموضوع ومؤول ” (6). ويعد إدراك هذا الترابط بين أداة التمثيل وبين ما يوجد خارجها، المفتاح الرئيسي لفهم نمط إنتاج الدلالة وفهم آليات التوالد التأويلي الناتج عن تصور سيرورة تدليلية يعتبرها بورس، نظريا على الأقل، غير قابلة للانكفاء على نفسها، وغير محصورة بحد بعينه.
وعوض أن يكون هذا الترابط مرادفا لحركة تعيينية ممتدة في أشياء تعد نقطة نهائية لفعل العلامة: “هذه الكلمة تدل على هذه الواقعة هنا والآن فحسب”، فإنها تحول، وتتحول عبرها ” الأشياء ” إلى علامات تقوم، وفق نفس شروط الإحالة الأولى، بخلق سلسلة من الإحالات داخل الدائرة الخاصة التي تحتوي العنصر مصدر التدليل. وهكذا، فكل عنصر من عناصر العلامة قابل لأن يتحول إلى علامة، أي إلى عنصر استقطاب دلالي يثير حوله مسيرات متنوعة في الإحالة والتدليل، > فالعالم الذي تحيل عليه العلامات عالم يتشكل ويتحلل داخل نسيج السميوزيس< (7)
2- المؤول وإنتاج الدلالة
إلى هنا، نكون قد حاولنا رسم الخطاطة العامة التي تَمْثُل عبرها العلامة أمامنا باعتبارها كيانا ممتدا في نفسه أولا، فما دام كل عنصر قابلا لأن يتحول إلى نقطة ارتكاز تتجسد فيها الوقائع التدليلية، فإن النسق العلامي يتحول إلى آلة ضبط ذاتي منتجة لرقابة داخلية تتحكم في مجموع الدلالات الناتجة عن حركة دلالية ما. وهي كيان ممتد في ما هو خارجه ثانيا، فالعلامة تموت لحظة تجسدها في واقعة بعينها، فهي > تولد وتكبر وتموت في الأشياء (…) إنها تترك آثارا تسمى عادة عندما يتعلق الأمر بالإنسان، وقانونا عندما يتعلق الأمر بالمجتمع أو بعلوم الإنسان<.(8) وبعبارة أخرى، فإن فعل العلامة مدرج ضمن >سيرورتين متقابلتين ومتكاملتين في نفس الآن. سيرورة أولي منبثقة من القوانين الداخلية للغة. ومن هذه القوانين تستقي اللغة معاييرها في الممارسة. وأخرى منبثقة من الشروط التاريخية الملموسة الحاضنة للممارسة الدالة، وهي التي تبلور – على المستوى اللغوي- مجموع الإرغامات والتناقضات والمعايير الخاصة بهذه الممارسة <. (9)
وسنحتاج، لتوضيح كل هذه القضايا، إلى العودة من جديد إلى تحديد مفهوم المؤول في أفق تحديد الغايات التدليلية المرتبطة به أولا، ثم تحديد موقعه من نظرية تأويلية ممكنة ثانيا، ثم تحديد موقعه كجسر رابط بين مادة مضمونية ما وأشكال تجسدها في نسخ خاصة ثالثا. وسنحاول القيام بذلك من زاوية قراءة موجهة تحديدا إلى النظر إلى المؤول باعتباره يشكل منطلقا لأي تحليل دلالي.
لقد أشرنا في الفقرة السابقة إلى أن عملية التمثيل العلامي التي تقود إلى خلق كيان رمزي يستعاض به عن “تجربة إنسانية ما “، تستدعي ماثولا ( أداة للتمثيل )، ويرتبط هذا الماثول- لحظة قيامه بالإحالة على موضوع معين- بما يسميه بورس بالعماد. ومفهوم العماد هذا يشير إلى أن تمثيل واقعة ما هو تمثيل جزئي. فـ >العلامة تحل محل شيء يعد موضوعا لها. وهذا الحلول لا يستوعب مجموع مكونات الموضوع، بل يتم عبر فكرة أطلقت عليها أحيانا ” عماد ” (fondement ) الماثول <( بورس). ووفق هذه النظرة، فإن كل تمثيل ليس سوى انتقاء خاص يتم وفق جهة نظر معينة. إنه، بعبارة أخرى، > صفة للموضوع باعتباره منتقى بطريقة معينة في أفق خلق موضوع مباشر < ( 10).
إن مردودية هذا المفهوم لا تتحدد إلا لحظة التمثيل، أي لحظة انتقاء موضوع ما عبر إحالة خاصة، فالقول مثلا : “إن الشجرة مثمرة” ،ليس سوى انتقاء لخصائص بعينها واستبعاد لأخرى، فلا يمكن القول إن هذا التمثيل قد استوعب، من خلال حركته تلك، مجموع الخصائص المميزة للشجرة في كليتها ( الطول، الظلال، الأغصان الوارفة أو غير الوارفة، طبيعة الفاكهة، أو كل الإحالات الاستعارية التي يمكن أن تحيل عليها كلمة شجرة …). ولعل هذا التحديد هو الذي يجعل من الموضوع، أي ما يوجد خارج أداة التمثيل، كيانا أشمل وأعم من العلامة، بل إن العلامة، في محاولاتها الدائمة لاستيعابه، لا تقوم إلا بالكشف عن غناه وتطوره الدائم.
إن الإشارة إلى ” جهة ما ” يتم عبرها التمثيل، سيقود بورس إلى التمييز بين الفعل الخاص للعلامة مجسدا في واقعة قد تؤول وفق ما تخصنا به التجربة المشتركة. وفي هذه الحالة تتوقف عملية إدراك الواقعة عند حدود ما هو معطى بشكل مباشر من خلال العلامة ذاتها، وبين الفعل الضمني لهذه العلامة، وهو ما يمكن أن ينتج عن هذا التحيين الخاص من افتراض لمعارف أخرى قد لا يستطيع الشخص الذي يقوم بالتأويل استيعابها ضمن مسير تأويلي واحد محدود في الزمان وفي المكان.
إن هذا التمييز سيقودنا إلى الفصل، في ميدان المعارف الممثلة داخل العلامة، بين الشيء الموصوف وبين الفعل الواصف ( وبعبارة أكثر دقة الفصل بين الخطاب الواصف والخطاب الموصوف )، أي الفصل بين ما يوجد كمادة وضعت أصلا للتأويل ( وكل تمثيل هو بصيغة من الصيغ تأويل )، وبين الفعل الذي يفصل بين المستويات والمراتب وزوايا النظر. في الحالة الأولى يدرك الموضوع باعتباره معرفة ( بأنماطها المتعددة ) تخص واقعة ما ( معرفة تشير إلى حجم هذه الواقعة ومكانها وتاريخها …) وبين المؤول باعتباره الفعل الذي يكشف عن هذه المعرفة ويحدد طبيعتها والمستويات داخلها.
وبالتأكيد، فإن المؤول ليس تأويلا، إنه مرتبط بالتأويل ويعد منطلقا له، إلا أنه أكثر عموما ويقتضي فعلا يختلف عما يمكن أن يحيل عليه التأويل. فالمؤول يقتضي وضعا لا يتطلب سياقا خاصا، ولا يتطلب شخصا يقوم بالتأويل. في حين يمكن اعتبار التأويل محاولة للإمساك بخيوط دلالة ما والدفع بها إلى نقطة نهائية تعد خاتمة لمسير تأويلي. ومع ذلك، فإن المؤول وأنواعه هو المدخل الرئيس إلى تحديد فعل التأويل، وعلى هذا الأساس يمكن تناول المؤول باعتباره ما يشكل نقطة إرساء أولى للمعنى.
واستنادا إلى هذا التمييز أيضا، سيعمد بورس إلى الفصل بين المباشر وغير المباشر في العلامة، أي بين موضوع معطى عبر فعل التحيين نفسه، وبين ما يمكن أن يدرك بشكل غير مباشر من خلال ما هو متحقق. ولأن الوضوع هو الذي يحدد العلامة ( فهو أشمل وأعم منها )، فإن التفكير في موضوع ما، هو بالتأكيد تفكير في شيء نملك عنه معرفة سابقة. > فإذا قلتم إن هذا الموضوع موجود هنا في استقلال عن كوننا نفكر فيه، فإن كلامكم هذا لا معنى له<.(11) والخلاصة أن الموضوع لا يحضر في أذهاننا إلا عبر تلك المعرفة، كما لا يمكن الحديث عنه إلا من خلال هذه المعرفة. فـ > الموضوع هو المعرفة المفترضة التي تسمح لنا بالإتيان بمعلومات إضافية تخصه … فإذا كان هناك شيء ما يشير إلى معلومة دون أن يكون لهذه المعلومة أية علاقة – مباشرة أو غير مباشرة – بما يعرفه الشخص الذي يتلقاها، فإن الحامل لهذه المعلومة لا يسمى، في هذا الكتاب، علامة <. (12) ولعل هذا ما دفع بورس إلى التمييز بين نوعين من الموضوعات ( الأمر يتعلق في واقع الأمر بالتمييز بين نوعن من المعرفة ) : يطلق على الأول الموضوع المباشر، وهو كذلك من حيث إن فعل الإدراك الذي يستدعيه لا يتطلب سوى عناصر التجربة المشتركة. والثاني ديناميكي، وهو كذلك من حيث إنه يستدعي فعلا موازيا للأول لأنه حصيلة ما يسميه بورس بـ “التجربة الضمنية ” (expérience collatéralle )، أي تجربة تعد حصيلة لسيرورة سميائية سابقة عن الفعل الذي يحقق الموضوع المباشر. وما يقوم بربط العلامة إلى هذا الموضوع أو ذاك هو السياق الخاص الذي تولد العلامة ضمنه وتنمو.
ولكي لا نتيه في المزيد من التحديدات التي تخص هذه المعرفة وزوايا النظر الكاشفة عنها، يمكن القول إن السر وراء هذا التوزيع المنهجي الدقيق يكمن في التصريح – وبورس لا يكف عن ذلك – بأن الموضوع يتجاوز العلامة، وأن التمثيل، بحكم الطبيعة الخاصة للممارسة الإنسانية، قاصر عن استيعاب مجموع ما يوفره الموضوع ضمن دائرة تمثيلية واحدة، نتيجة لما يسميه بورس بـ “قصور العــــــلامة”(l’imperfection du signe). فبما أننا مجبرون دائما، من أجل تحديد موضوع علامة، على استحضار علامة أخرى، فإن الموضوع لا يشكل حدا نهائيا لمتوالية إبلاغية ما. إن ما يمكن أن يحدد هوية العلامة – أي ربط ماثول بموضوع ضمن سياق خاص – هوالمؤول باعتبار وظيفته في الكشف عن المراتب والمستويات، فـ > نحن لا نستطيع أبدا معرفة الشيء في ذاته، إننا نعرف فقط العلامة التي هي دليل عليه، والعلامة على هذا الأساس كيان فضفاض في علاقتها بمؤولها، وهذا المؤول هو ما يحددها < (13) . ذلك أن > موضوع العلامة لا يمكن أن يكون إلا علامة أخرى. والسبب في ذلك أن العلامة لا يمكن أن تكون موضوعا لنفسها، إنها علامة لموضوعها من خلال بعض مظاهره( 14).
وفي جميع الحالات، يمكن القول، استنادا إلى التحديدات السابقة، إننا أمام معرفة تنتشر في جميع الاتجاهات، ووجود العلامة هو وجود العنصرالمنظم والمعد لهذه المعرفة. إن العلامة تقوم بمهمتها تلك في مرحلة أولى عبر إعداد موضوعات قابلة لاستيعاب وتنظيم هذه المعرفة ( وهذا دليل آخر على أن الموضوع يتجاوز العلامة ). وتقوم بذلك في مرحلة ثانية من خلال إدراج فعل للتأويل (مؤول) يقوم بالكشف عن هذه المعرفة ويحدد مستوياتها. فـ > القانون وحده هو الضامن لواقعية الواقع : فالبعد المستقبلي ليس شيئا آخر سوى تعريف للثالثانية، ذلك ” النمط الذي يكمن في كون الوقائع المستقبلية للثانيانية تتخذ طابعا عاما ومحددا، وهو ما أطلق عليه الثالثانية ” ( Peirce collecteds papers 1 . 25 ) < (15). وهذا معناه أن الدلالة، باعتبارها سيرورة في الوجود وفي الاشتغال وفي التلقي، لا يمكن أن تدرك إلا عبر مستوياتها، أي أنماطها في التدليل وفي معرفة العالم وهو ما يحدد نمط إدراك الذات لعالم الأشياء.
إن “المعارف” المتولدة عن الإحالة ” الصافية ” ( ماثول يحيل على موضوع خارج أي قانون أو فكر )، هي معارف تتيمز بالهشاشة والغموض والتسيب، فهي بلا “ذاكرة” وغير قادرة على التحول إلى معرفة عامة. إنها مرتبطة بواقعة بعينها، وستختفي باختفاء الشروط التي أنتجتها. أما في الحالة الثانية، فإن الإحالة تتم وفق قانون أو فكر يجعل من الواقعة ذاكرة قابلة للتعميم. مثال ذلك أنك إذا قلت أو نطقت أمام شخص ما بكلمة ” شجرة ” ولم يكن هذا الشخص قد سمع بهذه الكلمة أو رأى الشجرة، فإنه لن يدرك من هذه الواقعة سوى مجموعة من الأصوات التي قد تثير لديه بعض الانفعالات أوالأحاسيس ولكنها لن تقوده قطعا إلى إدراك أي شيء. لحظتها سيكون بإمكانك أن تأخذ بيديه لتريه شجرة على الورق أو في الواقع. وفي هذه الحالة فإنك لا تقوم إلا بربط ماثول ( صورة أو شجرة فعلية ) بموضوع ( ما تتضمنه الصورة أو الواقع ) لأن هذا الربط هو ربط “محلي” و”مؤقت”. فما دام هذا الرجل لا “يمتلك الشجرة فكريا”، فإنه لن ينظر إلى الواقعة إلا باعتبارها تجربة صافية خالية من الفكر. ولكن إذا “بررت” هذه العلاقة من خلال “تجريد ” الواقعة وتحويلها إلى مضمون معرفي يتجاوز الواقعة العينية (النسخة بتعبير بورس )، فإنك تكون قد أمددت هذا الشخص بـ ” فكر” ( أو قانون في لغة بورس) يسمح له باستحضار كل ما يشبه هذه الواقعة، أي أن الشجرة التي رآها منذ قليل تتحول عنده إلى نموذج عام، يستطيع من خلاله استحضار كل “الأشجار الممكنة” كيفما كانت الصور التي تحضر بها إلى الواقع. وهذا ما يقوم به المؤول، وتلك وظيفته داخل العلامة. وعلى هذا الأساس فإن “التدليل” لا يمكن أن يستقيم من خلال حركة إحالة ثنائية التكوين، إن التدليل فعل ثلاثي يستدعي وجود ثلاثة عناصر مرتبطة فيما بينها : ماثول وموضوع ومؤول. وهذا هو الشرط الأولي للحديث عن تجربة فكرية ( تجربة إدراكية).
إن نمط البناء هذا هو تأكيد للطابع المركب للفعل الإدراكي الذي يقود الذات المدركة إلى التخلص من العالم الخارجي عبر استيعابه كقوانين، أي تمثله كسلسلة من النماذج المؤدية إلى استحضار التجربة عبر وجهها المجرد. وبعبارة أخرى، فإن المؤول يقوم – من خلال موقعه كأداة للتوسط الإلزامي- بخلق حالة إدراك تسمح للذات بالانفلات من ربقة كل الإرغامات التي يفرضها الزمان والمكان عبر الامتلاك الرمزي للكون ( أو الامتلاك الفكري للكون كما كان يقول كاسيرير ). فلقد > استطاع الإنسان، من خلال الرمز وداخله، أن ينظم تجربته في انفصال عن العالم. وهذا ما جنبه التيه في اللحظة، وحماه من الانغماس في مباشرية الـ “الهنا” والـ” الآن” داخل عالم بلا أفق ولا ماضي ولا مستقبل. فكما أن الأداة ( outil) هي انفصال عن الموضوع، فإن الرمز هو انفصال عن الواقع < (16). وليست الدلالة وطرق إنتاجها وسبل تداولها سوى حصيلة حركة ” ترميزية” قادت الإنسان إلى التخلص من عبء الأشياء والتجارب والزمان والفضاء.
3- المؤول ومستويات الدلالة
إن الطبيعة التركيبية الخاصة بالفعل الإدراكي، تمتد لتشمل في مرحلة ثانية مستويات إنتاج الدلالة وتداولها. وإنتاج الدلالة، باعتباره نشاطا رمزيا في المقام الأول، لا ينفصل عن السبل الخاصة في تنظيم ” أشياء الكون ووقائعه ” وتوزيعها على خانات وأقسام. فإذا كانت الأشياء لا تدرك إلا باعتبار موقعها ضمن ” قسم خاص” نطلق عليه أحيانا “النسق” وأحيانا أخرى “النموذج”، فإن الدلالة المرتبطة بهذه الأشياء ( إنها في واقع الأمر السبيل الوحيد لإدراكها) لا تستقيم إلا من خلال تحديد موقع هذا الشيء أو ذاك ضمن هذا النسق أو ذاك. وكما أشرنا إلى ذلك سابقا، فإن العلامة هي الوسيلة الأساس وربما الوحيدة ) في إعداد الموضوعات وتنظيمها والقذف بها إلى ساحة التداول. إن هذا التداول يكشف عن المظاهر المتنوعة للشيء ولأنماط وجوده. وإذا كان تغيير موقع الشيء من نسق إلى آخر يؤدي حتما إلى تغيير في دلالته، فهذا معناه أن الدلالة ليست معطى جاهزا بل هي سيرورة، وليست كلا بل مستويات.
من هنا، إذا كانت الواقعة ( كيفما كانت طبيعتها ) تحتفظ في جميع السياقات بنواة معنوية قارة، فإنها معرضة دائما لاستعمالات متنوعة تغني هذه النواة وتتجاوزها في الآن نفسه : إن “مدخل الكلمة” و”معنى الواقعة الاجتماعية” و”معنى الشيء” كلها عناصر تشكل أنوية قارة تنسج منها وعبرها مجمل الدلالات المرافقة لعملية تغيير السياقات. إن هذه المداخل تشكل ما يشبه الجذر المشترك لمجموع الدلالات التي يمكن أن تمنح لواقعة ما. بل يمكننا القول إن التواصل البيئنساني مرهون بوجود هذه الأنوية التي تعد تعميما لتجربة إنسانية قارة.
ويبدو أنه لا يمكن فهم مجمل التصنيفات (17) التي يقدمها بورس لفعل التأويل إلا من هذه الزاوية. فرغم الحضور المكثف للطابع المنطقي المرافق لهذه التصنيفات، فإن ما يجب الانتباه إليه، بل والتركيز عليه، هو وجود سيرورة تأويلية تتحرك ضمن مسير يحدد لها منطلقاتها، كما يحدد لها إرغاماتها وقوانينها. ومن نافلة القول، إن كل الحقول تنتظم في سيرورات دلالية خاصة ووفق أنماط محددة في التجلي. وهكذا يمكن الحديث عن تقسيم عام يخترق السيرورة التأويلية ويحددها في أشكال ثلاثة، وكل شكل من هذه الأشكال محكوم بوظيفة معينة داخل عملية إنتاج الدلالة.
وعلى هذا الأساس، فإن ذاك > المعطى الصريح داخل العلامة، المنفصل عن أي سياق وكذا عن شروط التعبير عنه< (18) هو زاوية نظر تلتقط ما توفره العلامة في بعدها المباشر، أي كما تبدو وكما يدركها المتلقي دونما اعتماد على شيء آخر غير عناصرها الذاتية. إن التقاط هذه المعرفة، بهذه الروح، هو ما يسميه بورس بالمؤول المباشر، أي > ما يتم الكشف عنه من خلال إدراك العلامة ذاتها، ما نسميه عادة بمعنى العلامة (…) إنه يتحدد باعتباره ممثلا ومعبرا عنه داخل العلامة < ( 19).
إننا أمام حالة أولية للإدراك تتمثل في إنتاج دلالة لا تتجاوز حدود تعيين تجربة ما كما تقدمها العلامة من خلال مظهرها المباشر. إن حدود هذه الدلالة هي وصف هذه التجربة بالاعتماد فقط على العناصرالأولية التي تشتمل عليها العلامة دونما اعتماد على شيء آخر . > فما تحيل عليه العلامة في بدايتها هو الإحساس بأن هذه العلامة تنتج وقعا معينا. فهناك دائما إحساس نؤوله باعتباره دليلا على أننا قد فهمنا ما تدل عليه هذه العلامة < (20). إن الأمر يتعلق بوقع فقط، أو بإحساس ما يشير إلى أن الذي يتلقى العلامة قد فهم ما تود العلامة قوله. فما هو هذا المضمون الذي ينظر إليه كإحساس فقط ؟ وما ذا نعني بالإحساس ثانيا؟.> إن المؤول المباشر لا يقترح، في واقع الأمر، أية معرفة، إلا أنه يقوم بإدراج الماثول ضمن حركة تأويلية < (21)، إنها طريقة أخرى للقول بأن هذا المؤول يشكل لحظة بدئية داخل سيرورة لا نرى منها سوى بدايتها، أما نهايتها فموكولة إلى الشخص الذي يقوم بالتأويل. وبعبارة أخرى، فإن ما نعينه من خلال هذا التمثيل هو مستوى دلالي أول مرتبط بحركة تأويلية يتحدد مضمونها من خلال مجمل المسيرات التأويلية التي يعلن عن ولادتها.
وبما أن التأويل هو دائما زحزحة للعلاقات، وتغيير للمواقع، وإعادة لترتيب عناصر العلامات، فإن ما يضمن سلامة التأويل ودوامه واستمراره في إنتاج الدلالات المتنوعة هو وجود هذا الحد الأدنى المعنوي المرتبط بتجربة حياتية لا تتجاوز حدود الاستجابة للبعد النفعي فيها. من هنا كان النظر إلى المؤول المباشر باعتباره قراءة أولية في معطيات ظاهرة في أفق فتح آفاق متنوعة أمام مستوى آخر من مستويات التدليل. ولأن المؤول هو” علامة موازية أو أكثر تطورا “من الأولى، فإنه في ضمانه للإحالة من ماثول إلى موضوع، يؤكد هشاشتها، فتصور البحث من جديد عن إحالة أخرى أمر وارد في كل لحظة ومع كل سياق ( مع أي فعل تأويلي ). ذلك أن الإحالة تخضع لتراتبية ولا يشكل المؤول المباشر داخلها سوى إمكان ضمن إمكانات أخرى.
ولأن كل واقعة، سواء تعلق الأمر بـ “الكلمة” أو بـ “الشيء” أو بـ “طقس من الطقوس الاجتماعية”، تستدعي دائما، لكي تدرك، السيرورة التاريخية التي نشأت في أحضانها، وتحولت عبرها إلى ذاكرة للفعل الإنساني، فإن الجنوح إلى تجاوز ما هو معطى بشكل مباشر داخل العلامة والبحث عن معان ثانية أمر طبيعي، ويستجيب للطابع المتنوع للحاجات التي تنتجها الممارسة الإنسانية. وعلى هذا الأساس، نعثر في تصور بورس على نوع ثان من المؤولات قد يستجيب لهذه الحاجات، يطلق عليه بورس المؤول الديناميكي. وهذا المؤول مرتبط في الوجود بالمؤول الأول، إلا أنه يختلف عنه من حيث الطبيعة ( فهو متجدد باستمرار ) ومن حيث الاشتغال ( فهو قراءة في السياق الذي يوجد خارج العلامة، أي مجمل المضامين الثقافية التي تشير إليها العلامة ). وبعبارة أخرى، إنه العنصر الذي يدل على أن معنى العلامة ليس “استجابة لحاجة أولية ومباشرة”، بل هو نقش في ذاكرة غير مرئية من خلال الفعل التمثيلي الأول. وهكذا، فإن بورس يرى فيه >الأثرالذي تنتجه العلامة فعليا في الذهن< أو > هو كل تأويل يعطيه الذهن فعليا للعلامة < (22).
وإذا تغاضينا – في هذا التعريف – عن تحديد رد فعل المتلقي للعلامة، فإن المؤول الديناميكي يحيلنا على حركية التأويل المتولدة عن قراءة متجاوزة للمعطى المباشرللعلامة. إنه تحديد لسلسلة من المسيرات التأويلية التي تعد أصل السميوزيس وطبيعتها الفعلية. والسميوزيس، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هي حركة تأويلية غير محددة بأي أفق وغير محكومة بأية غاية. إنها سلسلة الإحالات المتولدة عن حركة تمثيل أولى ومنتشرة في كل الآفاق. وعلى هذا الأساس، فإن ما يطلق العنان لهذه الحركة وما يمدها بعناصر التأويل هو هذا المؤول الذي يغرف عناصر تأويله من مصادر متعددة : الثقافي والإيديولوجي والخرافي والأسطوري والديني، وكل ما يمكن أن يسهم في إغناءالتأويل وتنويعه. ومن خلال هذا، فإنه يدرج السميوزيس – وتلك وظيفته- ضمن دائرة اللامتناهي، أي ضمن دائرة تأويلية يفترض بورس أنها غير محكومة بنهاية أو غاية بعينها.
> إلا أنها تعد في الممارسة سيرورة محدودة ونهائية. إنها تقع تحت طائلة العادة التي نملكها في إسناد هذه الدلالة إلى تلك العلامة داخل سياق مألوف لدينا < (23). إنها كذلك لأن أي تدليل إنما يقوم آنطلاقا من سياق خاص يحدد للدلالات حجمها ومصادرها وامتداداتها. وفي كل الأحوال، فإن السياق ليس سوى محاولة لعزل واقعة ما ، وإدراجها ضمن منطق خاص للتدليل. وهذا معناه تخليص الواقعة من كل ما لا يستقيم داخل هذا السياق. والخلاصة >إذا كانت سلسلة التأويلات غير محدودة كما بين ذلك بورس، فإن الكون الخطابي يتدخل من أجل تحديد حجم الموسوعة (24).
إن القوة ” المدمرة ” التي يطلق عنانها المؤول الديناميكي ( من حيث إنه مرتبط بمعرفة واسعة)، لا يمكن أن تتوقف من تلقاء نفسها، ولا يوجد داخل هذا المؤول ما يوحي بإمكانية التوقف عند دلالة بعينها. إن إيقاف هذه الحركة لا يتم إلا من خلال الاستعانة بمنطق آخر للتدليل، أو إن شئنا القول، إرساء دعائم سياق خاص يستدعي الانتقاء والحذف والتحجيم. وتلك هي مهمة المؤول النهائي كما يرى ذلك بورس. فهو> الوقع الذي تولده العلامة في الذهن بعد تطور كاف للفكر <. ( 25) فما كان يبدو لا محدودا يتحول من خلال المؤول النهائي إلى حركة محكومة بقوانين محددة تجعل كل إحالة مندرجة ضمن منطق خاص للإحالة. فداخل سيرورة تأويلية معينة يجنح الفعل التأويلي إلى تثبيت هذه السيرورة داخل نقطة معينة يمكن النظر إليها باعتبارها أفقا نهائيا داخل مسير تأويلي ما يقود من تحديد معطيات دلالية أولية ( مؤول مباشر )، إلى إثارة سلسلة من الدلالات المتنوعة ( مؤول ديناميكي )، ليصل في نهاية الأمر إلى تحديد نقطة إرساء دلالية ( مؤول نهائي ). ويعد هذا الأفق شكلا نهائيا ستستقر عليه هذه السيرورة. إن الأمر يتعلق بما يسميه بورس بالعادة، > فالعادة تجمد مؤقتا الإحالة اللامتناهية من علامة إلى علامة أخرى لكي يتسنى للمتكلمين الاتفاق على واقع سياق إبلاغي معين، إن العادة تشل السيرورة السميائية، فهي عالم “الأفكار الجاهزة “. ولكن العادة هي وليدة علامات سابقة، ولهذا فإن العلامات هي التي تؤدي إلى تدعيم أو تغيير العادات <(26).
ولعل هذا ما لا يجعل من “النهائية” مضمونا زمنيا يتحدد داخله المؤول النهائي باعتباره مصدرا لإنتاج دلالات لا سلطة للزمان عليها. إن “النهائية” هنا تتعلق ببداية ونهاية مسير تدليلي ما، وما يبدو كنهاية منطقية لمسير، سيتحول إلى نقطة بدئية داخل مسير آخر. إنه الرغبة الدفينة واللاشعورية التي تستشعرها الذات المؤولة في الوصول إلى دلالة بعينها انطلاقا من سيرورة تدليلية بعينها. أو هو محاولة الذات لخلق ” محميات دلالية ” تريحها من عبء واللامحدود واللاقار من خلال الرسو على موقف دلالي بعينه.
وربما سيكون من السهل جدا القول بأن الغاية من وجود مؤول من هذا النوع هي تحديد معنى كخلاصة لمجهود تدليلي، أي استقرار ماثول على موضوع. إلا أن الأمر أعقد بكثير من ذلك. فهذه السيرورة هي سيرورة افتراضية أملتها غايات منهجية فحسب. فالتدليل ومراحله وخاناته ليس شيئا شفافا يمكن المسك به بسهولة. إنه مركب ومتنوع ومتعدد التجليات، وليس من السهل الفصل داخله بين نقطة بدئية وأخرى نهائية وثالثة تتوسطهما. فهو إلى جانب استناده إلى العناصر الأساسية التي توفرها العلامة كمادة للتأويل، يفترض ذاتا خاصة تقوم بإنجازه، وهذا يعني استحضار مخزون ثقافي آخر تأتي به هذه الذات في أفق تحقيق تأويلها الخاص.
ولقد حاول جيرار دولودال (27)، انطلاقا، من نصوص بورس نفسها، أن يصنف مجمل الدلالات الناتجة عن توقف السيرورة التي يكشف عنها المؤول الديناميكي، انطلاقا من قواعد منطقية تلخص عملية برهانية خاصة. إن بورس يدرج فعل هذا المؤول أولا ضمن عادات عامة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي، أي مرتبطة بكل ما يخص الأحكام الاجتماعية القيمية. وهذا أمر في غاية البساطة، فالممارسة الإنسانية تنتج أشكالا سلوكية عامة وقارة تحتكم إليها وتقيس عليها نسخها المتحققة. وهذه الأشكال هي ذاتها نتاج سيرورة سميائية سابقة اقتضت الحاجة الحياتية ( والدلالية ) إدراجها ضمن القوالب التي تشكل غطاء لكل ممارسة فردية خاصة. وفي هذه الحالة ينظر بورس إلى هذا المؤول باعتباره ” افتراضا ” ( abduction). ذلك أن الافتراض- في الجهاز المفهومي الذي يقترحه بورس – لا ينتج معرفة مع مستلزماتها الدلالية. > إنه منهجية للخروج بتكهن عام دون وجود ضمانة موضوعية على أنه سيصدق على حالة خاصة أو حالة اعتيادية. إن ما يبرر هذا التكهن هو أنه يشكل الأمل الوحيد في تنظيم سلوكنا المستقبلي تنظيما عقلانيا < (28). إن مهمته هي أن يقوم فقط بقياس حالة غير معروفة على ما تعرفه الذات المؤولة بشكل سابق. فـ > السيرورة الافتراضية تقتضي التعامل مع التجربة التي أواجهها انطلاقا من معرفة سابقة، ويتعلق الأمر بالتطبيق الميكانيكي لحالة خاصة على مقولة سابقة < (29) .
إنها قواعد برهانية “مستترة” نحتكم إليها كل يوم، ونستند إليها من أجل تفسير وقراءة مجمل ما يعود إلى التجربة العادية. وبعبارة أخرى، فإن الأمر يتعلق بطريقة خاصة في تنظيم مجمل المعارف التي تعود إلى حقل سلوكي معين. فالتعرف على التجربة الجديدة يقتضي إلماما بعناصرالنسق الذي تنتج داخله هذه التجربة. و> يجب أن تكون هذه التجربة الجديدة قادرة على إنتاج مقولات جديدة ستعمل استقبالا على إغناء المقولات السابقة عنها <(30).
ومن جهة ثانية، فإن هذا المؤول قد يحدد نشاطا معرفيا من طبيعة أخرى. والأمر يخص ما يسميه بورس بـ “العادة المخصوصة “. وهي عادة لا تهم سوى قطاع معرفي بعينه يتميز بدقته المعرفية وبإمكانية خضوعه للمراقبة العلمية. وهكذا يرى بورس أن المؤول النهائي في هذه الحالة يعين طريقة في الكشف عن حكم عام من خلال حالة خاصة. وتلك عادة الخبير الفني الذي يقوم برد لوحة مجهولة إلى فنان بعينه، ومدرسة فنية بعينها أيضا…؛ وهي أيضا عادة عالم الحفريات الذي يقوم بتحديد تاريخ حجر ما استنادا إلى المعرفة التي يملكها عن تعدد العصور الجيولوجية مثلا. ويدرج هذا المؤول ضمن الأحكام القياسيةة ( induction). والقياس في لغة بورس هو > طريقة خاصة في بلورة رموز قضوية ( dicisignes) خاصة بقضية محددة. ولا يستند المؤول، عبر طريقة الحكم هاته، إلى مقدمات صحيحة، فهذه الطريقة تصل إلى نتائجها الصحيحة في جل الحالات وعلى مدى بعيد. إنها تشير إلى أنه إذا تم الحفاظ على هذا النهج ، فإنه سينتج استقبالا الحقيقة أو ما يقرب منها فيما يخص مجمل القضايا<(31).
وبعبارة أخرى، فإن الأمر يتعلق بالوصول إلى قاعدة عامة انطلاقا من حالة خاصة. وتلك هي العادة المخصوصة التي تصنف معلومة جديدة ضمن معرفة عامة. ويشكل هذاالحكم – داخل هذه النهائية – حركة ثانية داخل السيرورات التي يطلق عنانها فعل التأويل الناتج عن دخول المؤول الديناميكي ساحة التأويل.
ونصل في نهاية هذه الفقرة إلى تحديد سيرورة ثالثة تقود هذه المرة عبر -نمط إحالاتها- إلى أحكام ذات طبيعة استنباطية. ويوصف المؤول في هذه الحالة بـ “الاستنباطي” لأنه يستند – من أجل تحديد الدلالات الخاصة بمسير ما – إلى معرفة عامة منفصلة عن الفعل المباشر ( النسخ الخاصة للفعل ). ويصف بورس هذه العلاقة بقوله: > إن الاستنباط حجة يتحدد المؤول داخلها من خلال انتمائه إلى قسم عام من الحجج الممكنة والمشابهة. وهذه الحجج هي من العمومية لدرجة أن كل المقدمات الصحيحة داخلها ستؤدي، عبر التجربة، إلى نتائج صحيحة. < (32). ولعل هذه العمومية هي التي تجعل من هذا المؤول نسقيا وخارج أي سياق. فهو كذلك لأن المعرفة التي يستند إليها في عملية تأويله، معرفة عامة وتخص القضايا الكبرى التي تشكل مقدمات برهانية لتحديد الحالات الدلالية الخاصة، أي تلك التي تنتجها سياقات بعينها.
إن ما يمكن استنتاحه من هذه التصنيفات وغيرها هو أن المؤول النهائي ليس آلة لإنتاج الدلالات والمعاني، كما أنه ليس صياغة نهائية لدلالات بعينها تعد إثباتا لمعرفة قارة. إنه على العكس من ذلك، ورغم مظهره الانغلاقي، يشير إلى أن الدلالات متعددة تعدد السياقات التأويلية، وأن التعدد لا يوجد في الواقعة، إن كل تعدد إنما يعود إلى الذات التي تقوم بالتأويل.
وبطبيعة الحال فإن هناك العديد من التقسيمات والتصنيفات الفرعية المتولدة عن هذه الآلة التأويلية، لكننا لم نشأ إيرادها لاقتناعنا العميق بأن كل نظرية تولد محملة بالكثير من التمييزات الدقيقة التي تحددها في جزئياتها الصغيرة، ولكنها كلما تقدمت في الزمن تخلصت من الكثير من عناصرها في أفق خلق صيغة معرفية قادرة على استيعاب ما توفره الوقائع الجديدة التي تحتاج إلى تغيير في الرؤية من أجل خلق حوار وتواصل بين نظريات أخرى.
ولم نفعل ذلك، من جهة ثانية، لأن مقالنا محكوم بغاية معرفية نطمح من ورائها إلى خلق تواصل بين ما يقدمه بورس كتصور نظري مغرق في التجريد والعمومية، وبين الممارسة النصية التي تقتضي الحذف والتعديل والتحوير. وهذا ممكن من خلال إدراج ما يقدمه بورس ضمن تصورات عرفت بانشغالها الكبير بقضايا المعنى، كالسميائيات السردية وما تفرع عنها. فالمنهج ليس أدوات ومفاهيم معزولة ومفصولة عن بعضها البعض، إن المنهج – من خلال هذه الأدوات والمفاهيم – هو في المقام الأول تساؤل حول المعنى وتساؤل حول طرق إنتاجه، وكل > مفهوم مرتبط بقضية، بل بقضايا وبدونها لن يكون له أي معنى< (33).
4- الممكنات الدلالية وسيرورة التأويل.
إن ما انتهينا إليه في الفقرة السابقة ( ماقلناه عن نهائية التأويل ) هو الذي يدفعنا الآن إلى طرح تساؤل محرج : من أين تأتي هذه القوة المنطقية الأصيلة التي ينبثق منها التصنيف الدلالي النهائي المشار إليه ؟. وبعبارة أخرى، هل نحن أمام مستوى سميائي خاص يُكثف فيه المنتوج السلوكي المنبعث من الممارسة الإنسانية في أفق تحولها إلى قوة ضابطة لكل الأوجه المحسوسة؟. ستقودنا هذه الاسئلة الآن إلى تحديد زاوية نظر أخرى يمكن أن يتحول عبرها المؤول النهائي إلى سند رئيسي لتحديد أشكال التحقق المنبثقة عن أصل مجرد. فكل ما هو متحقق يمتلك بهذا الشكل أو ذاك، أو في هذا الأفق أو ذاك، سقفا فوقيا يبرره ويفسره ويضمن تداوله ومعقوليته. إن هذه الخاصية تصدق على جميع الوقائع دون استثناء. فالسلوك الإنساني مصنوع من سلسلة من الأفعال البسيطة التي تتحول مع الزمن إلى أشكال سلوكية عامة هي ما نطلق عليه “العادة ” أحيانا، وهو ما ندرجه ضمن القيم أحيانا أخرى.
ويجب ألا يؤول هذا الكلام على أنه نفي لمرجعية مادية للفعل، والاستعاضة عنها بسقف مضموني تمدنا به قوة توجد خارج الممارسة الإنسانية. إن الحديث عن تنظيم مجرد للقيم هو صيغة أخرى للقول بأن القانون ينبثق من الواقعة الخاصة، والقانون ( الفكر أو الضرورة في لغة بورس ) هو صيغة أخرى للقول إن الواقعة تطمح، باستمرار، إلى امتلاك وجود استقبالي دائم. فمقولة “الشر” مثلا، باعتبارها قيمة دلالية، ليست مرتبطة في وجودها المجرد بأي سياق، إنها هنا لكي تشير إلى أن مجمل الأفعال الدالة على “شيء يمكن أن يؤول باعتباره إساءة للآخر” يجب أن تصنف ضمن خانة الشر. وبناء عليه، فإن مقولة ” الشر” تشتمل على مجمل إمكانات التحقق، أي تقوم بتحديد مجمل الأوجه التي يتجسد من خلالها كل ما يمكن أن يدل على الشر في سياق خاص. إنها “متصل” ( continuum) غير دال من خلال خصائصه الذاتية. ولتكون لها قدرة التدليل لا بد من ردها إلى ما يكونها، ولحظتها تتحول عناصرها الداخلية إلى مسيرات دلالية.
يمكن القول إذا إننا أمام مستويين يصنف ويؤول ضمنهما الفعل الإنساني : مستوى “خارج -سميائي” ويتضمن مجمل التصنيفات القيمية المجردة والقارة. إن هذه القيم توجد خارج الممارسة السميائية لأنها انفصلت عن الفعل الخاص، وهو ما يحدد هويتها المتميزة. ومن جهة أخرى هناك ما ينتمي إلى السميائي بحصر المعنى، ويعين هذا المستوى كل ما يدرك كتحقق محسوس ضمن سياق خاص. إن التفاعل بين المستويين هو ما يضمن استمرارية الحياة ومعقوليتها. فبدون سقف مجرد لا يمكن تصور فعل خاص، كما أن كل فعل خاص لا بد وأن يصنف – عاجلا أو آجلا- ضمن خانة تبرر وجوده واستمراره.
ويمكن صياغة هذه الإشكالية بطريقة أخرى. لنفرض أننا أمام ” عادة ” معينة كما تبدو من خلال السلوك الفردي أوالجماعي. فما هو وضع هذه العادة وما هو مضمونها ؟. إن الحس السليم يدلنا على أن كل عادة هي في الأصل فعل صادر عن شخص ما في زمن ما وفضاء ما. ولأن هذا الفعل قد يتكرر مرات عديدة، فإنه قابل لأن يتحول -عندما يتخلص من العناصر التي تشده إلى خصوصية غير مميزة – إلى شكل عام تراقب عبره الأفعال المشابهة. إن هذا الأمر يثير ثلاث ملاحظات على الأقل :
– أولا يجب التعامل مع كل عادة باعتبارها سلوكا بمضمون زمني، حولته الممارسة الإنسانية إلى صيغة مجردة. إن التخلص من الزمنية عبر التجريد لا يكون إلا بهدف التحكم في كل المضامين الزمنية.
– ثانيا إن هذه الصيغة المجردة، بحكم ارتباطها الدائم بالسلوك الخاص، تغتني وتتطور وقد تولد صيغا جديدة تبنى على أنقاض الصيغ القديمة.
– وثالثا، وهذا هو الأهم، فإن كل الأشكال التي استقرت عليها الممارسة الإنسانية في مرحلة تاريخية ما، تتضمن بالضرورة رؤية الإنسان للعالم وطبيعة علاقته بالأشياء، وكذا طريقته في التقطيع المفهومي الذي ينقل العالم الخارجي إلى ميدان الفكر.
وفي هذه الحالات، فإن الفعل الخاص هو المدخل الأساس لتحديد المضامين المجردة ورسم حجم تطورها. فهو، بحكم ارتباطه بالممارسة الإنسانية وبوجهها المرئي بالتحديد، يعد وحده العنصر القابل للوصف والتحديد والتحليل.
إن هذا المستوي السميائي السابق على التجلي الخاص للفعل ( وعن النص أيضا )، هو نقطة الارتكاز الرئيسية نحو فهم كنه المؤول النهائي وطريقة عمله وفق موقعه الجديد. إنه هنا لا يعين ” معنى” أي جوهرا معنويا مجردا ومستقل الوجود، إنه يشير فقط إلى إجراء يتم عبره الحصول على قيمة دلالية لا تفهم ولا تدرك إلا باعتبارها خلاصة لهذا الإجراء، وستختفي حتما باختفائه. فما يُكَوِّن المؤول النهائي ليس مادة بل علاقات، وهو ليس وجودا ساكنا بل إجراء. فالمادة المضمونية ليست قدرا، إنها موجودة في حدود أن هناك إجراء يعمل على إغنائها، وهي موجودة أيضا في حدود أنها تقوم بتغذية الأشكال المتحققة في وقائع خاصة. من هنا، فإن هذا المضمون الدلالي الأولي هو مصدر الأشكال الدلالية التي تحتضنها السياقات الخاصة.
إن ما ينظم التجربة الإنسانية في كليتها هو نفسه ما يحكم بزوغ الدلالة. فإذا كانت الدلالة لا تعبأ بمادة تجليها ( گريماص)- فالمعاني لا تستأذن أي شيء لكي تولد وتمارس نشاطها- فهذا معناه أن التجربة الإنسانية كلية وتحتاج، لكي تكشف عن نفسها، إلى مواد تعبيرية بالغة التنوع. وعلى هذا الأساس التقط بورس مفهوم المؤول باعتباره الأداة التي توصل بين مجموع الصيغ التعبيرية. فالتعيين ليس حالة نهائية، إنه تثبيت لسيرورة في واقعة، هي نفسها ستؤول باعتبارها نقطة بدئية لسيرورة جديدة. ولعل هذا ما دفع ر وبير مارتي ( R. Marty) إلى الاعتقاد بأن مفهوم “حقل المؤولات” شبيه بمفهوم ” السنن الثقافي “، غير أنهما مختلفان. فالأول أكثر شمولية وأشد جدلية من حيث إنه ” كوني محسوس” ( un universel concret) في حين يتميز الثاني بأنه ” كوني مجرد” (un universel abstrait)، أي مفصول عن لحظات تشكله. (34)
إن سلسلة التحديدات هذه تضعنا مباشرة في قلب إشكالية تناول المعنى والإمساك به وتحديد سبل تجسده في وحدات سياقية > تجعل منه كيانا قادرا على التدليل <(35). فما يتم تكثيفه عبر الفعل الخاص هو نفسه الذي يتحول إلى مادة، أي إلى كون قيمي، يغذي السلوك الخاص، وكل قيمة ليست سوى حكم خاص بالفعل المتحقق. من هنا، فإن التدليل لا يوجد خارج الفعل وخارج مداراته، إنه هو التدليل؛ وتصور مسير تدليلي يحتاج إلى تحويل ما يَمْثُل كعلاقات لازمنية وغير موجهة، إلى عمليات تُسَرِّب السياق كشرط أساس للإمساك بالدلالة. وتلك هي القاعدة الأساسية التي انطلق منها گريماص لتحويل عالم المعنى إلى سيرورة ” إنتاجية ” دائمة التحول : أصلها معلق في أشكال مجردة ( البنية الدلالية الأولية ) (36)، ووجهها المحسوس يتحقق في سيرورات عبر نصوص بجميع الأحجام والأشكال والأنواع. فمن قلب “المجرد الساكن” ينبعث المتحرك الفعلي، ولن يقود المتحرك الفعلي إلا إلى إعادة صياغة المضامين وتنويعها وفق مستجدات الممارسة الإنسانية. إن سلسلة الإحالات كما يتصورها بورس تجد هنا صداها ومردوديتها.
وبما أن الوقائع الخاصة ( الوقائع اللسانية وغيرها ) هي سبيلنا الوحيد للتعرف على المضامين القيمية المجردة، فإن تحقق هذه الوقائع لا يمكن أن يكون إلا جزئيا. فالسيرورة التدليلية المنبثقة من هذه الواقعة تعد اقتطاعا لجزئية دلالية معينة وإدراجها ضمن مسير تأويلي يضمن لها الاستقلالية في الوجود المعنوي، ويضمن لها، في الآن نفسه، ارتباطها مع أصلها المولد، أي علاقتها بالوحدة التي تحتضنها. ذلك أن تنظيم المعنى عبر أشكال خطابية متنوعة يفترض التحول من التصور الاستبدالي للوحدات إلى وجهها التوزيعي. وبناء على هذا، إذا كانت الكلمة هي بالتحديد سلسلة من الممكنات الدلالية، ( كل كلمة تشتمل على معاني متعددة ) فإن اندراجها ضمن خطاب خاص يقلص من هذه الممكنات عبر تحديد سقف دلالي موحد للخطاب وتناظراته. والخلاصة أن كل وحدة من الوحدات التعبيرية تحتضن داخلها سلسلة من القيم المودعة في مؤولات تقوم بتنظيمها. إنها وحدات مضمونية لا تتحقق إلا عبر مسير دلالي خاص، وكل مسير قد يولد آخر فرعيا وهكذا دواليك. ذلك أن كل إمكان دلالي هو في واقع الأمر استعمال خاص للكلمة.
ذاك هو الأساس الذي انطلقت منه مدرسة باريس السميائية في تصورها للدلالة والسردية وأشكال تجليهما. وهو الأساس الذي عابه بول ريكور(P . Ricoeur) ولم يستسغه أيضا. فلا يمكن، في رأيه، الحديث عن مستوى سميائي سابق على التجلي اللساني. صحيح قد يكون بالإمكان أن نقرأ الأول انطلاقا من الثاني، إلا أننا لا يمكن أن نتحدث عن مستوى سميائي سابق في الوجود على التجلي اللساني.( 37) وستسعفنا في هذه الحالة مقولة المؤول النهائي لتجاوز هذا التعارض الذي يقيمه ريكور بين المستويين. فالأمر، انطلاقا من مقولة المؤول، لا يتعلق بأسبقية هذا المستوى على ذاك، بل يعود إلى سيرورة من طبيعة واحدة وبنتائج مختلفة. ففي البداية تُوَلِّد السيرورة أشكالا عامة تعد تكثيفا تجريديا للفعل الخاص. وفي الحالة الثانية فإن إدراك المعنى وشروط إنتاجه وتداوله يمر عبر الممارسة الدلالية بوجهها اللساني في حالة النصوص، وبوجهها الفعلي في حالة اللغات غير اللسانية. فكل تأويل يستند في إنجازه إلى تحديد موقع العنصر الموضوع للتأويل ضمن خانة سابقة. وهذا ما يفسر توزيع بورس للممارسة الإنسانية على مستويين : أحدهما سميائي والثاني خارج- سميائي، الأول يرصد الفعل ضمن لحظة التحقق الخاصة والثاني يكثفه ويمنحه وجها مجردا.
—————————————————–
الهوامش
1 – Benveniste ( Emile) : Problèmes de liguistique générale II , éd Gallimard 1974, p 45
2- للمزيد من الاطلاع على نظرية المقولات يمكن للقارئ العودة إلى :
– Peirce : Ecrits sur le signe
– Deledalle ( G) : Théorie et pratique du signe
– Carontini ( Enrico ) : Action du signe
– سعيد بنگراد : سميائيات بورس ، مجلة علامات ، العدد الأول ، 1994
– حنون مبارك : دروس في السميائيات، توبقال ، 1987.
3-فكرة لروبير مارتي توردها جويل ريتوري في Langages n 58 ص 34 ، وهو عدد خاص بسميائيات بورس
R Marty : La théorie des interprétants , in Langages n 58
4- رغم أن بورس يستعمل عبارة “العلامة أوالماثول ” فإن هناك فرقا واضحا بينهما. > فالعلامة هي الشيء المعطى كما هو، بينما يعين الماثول الشيء /علامة منظورا إليه داخل التحليل الثلاثي كعنصر داخل سيرورة التأويل < انظر Nicole Everart- Desmedt : Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de C S Peirce , ed Mardaga Editeur p 39 .
5- p 121 Peirce : Ecrits sur le signe
6- نفسه ص 121 Peirce : Ecrits sur le signe
7- David Savan : La mémiosis et son monde , in Langages n 58, p 71. ولا يتسع المجال هنا لتقديم التوزيع الثلاثي الذي يقدمه بــــــــــورس للعلامة. ونكتفي بالإحالة على التوزيع الثلاثي العام الذي يحكم مجمل التوزيعات الفرعية الأخرى. وهكذا، فإن الماثول يتوزع ثلاثيا على الشكل التالي: أولانية الأولانية ( علامة نوعية )، وثانيانية الأولانية ( علامة مفردة )، وثالثانية الأولانية ( علامة قانون)، والموضوع يتوزع بنفس الطريقة على: أولانية الثانيانية ( أيقون )، ثانيانية الثانيانية ( أمارة)، ثالثانية الثانيانية ( رمز )، ويتوزع المؤول على : أولانية الثالثانية ( حملي )، وثانيانية الثالثانية ( تصديق ) وثالثانية الثالثانية ( حجة ).
8- جيرار دولودال : “تنبيه لقراء بورس” ، ترجمة عبد العلي اليزمي ، مجلة علاما ت، العدد 8 ، ص 113.
9- Carontini ( Enrico ) : Action du signe p. 29
10- Eco , Umberto : Lector in fabula , ed Grasset , 1985 , p 36
11- 67 Eliseo Veron : La sémiosis et son monde ,in Langages n 58 , p عبارة لبورس وردت في أحد المخطوطات ويستشهد بها الكاتب لتوضيح تعريف بورس “للواقع”.
12- Peirce : Ecrits sur le signe p 123
13 – Theresa Calvet de MAGALHAES : Signe ou symbole , ed Louvain-Laneuve et Madrid , 1981, p 162
14 – Peirce : Ecrits sur le signe p
15- Eliseo Veron : La sémiosis et son monde , in Langages n 58 , p 73
16- Molino ( Jean) : Intrpréter , in l’interprétation des textes , ed minuit , 1989 , p 32
17- يشير بورس في معرض حديثه عن المؤول الديناميكي مثلا إلى وجود مؤول انفعالي وأخر طاقوي وثالث منطقي Peirce : Ecrits sur le signe p130. واستنادا إلى سلسلة الشروح التي يقدمها، يمكن القول أن بورس في هذه اللحظة كان ينظر إلى المؤول الديناميكي من زاوية التلقي، أي من زاوية وجود وضعية إبلاغية تستدعي باثا يلقي كلاما ومتلقيا تصدر عنه ردود أفعال ما. ولعل هذا التصور هو الذي دفع كرانتيني Carontini إلى محاولة تطوير نظرية في القدرة الإبلاغية انطلاقا من هذاالتقسيم الذي يقدمه بورس. انظر:
II ,Cabay , Bruxelles 1983 Carontini ( Enrico ) : Action du signe
18- 128 Peirce : Ecrits sur le signe p
19- نفسه ص 189
20- p 130 Peirce : Ecrits sur le signe
21 – Carontini ( Enrico ) : Action du signe p 30
22- 189 Peirce : Ecrits sur le signe p
23- Nicole Everart- Desmedt : Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de C S Peirce , ed Mardaga Editeur , p 42
24- Eco , Umberto : Lector in fabula , ed Grasset , 1985 , p . 77
25- 189 Peirce : Ecrits sur le signe p
26- Nicole Everart- Desmedt : Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de C S Peirce , ed Mardaga Editeur , p 42 -43
27 – Deledalle , Gerard : Théorie et pratique du signe
28- p188 Peirce : Ecrits sur le signe,
29-Carontini ( Enrico ) : Action du signe p. 33
30 – نفسه ص 33
31- p187 Peirce : Ecrits sur le signe,
32- p186 Peirce : Ecrits sur le signe,
33- Gilles Deleuz , Fellix Guattari : Qu’est ce que la philosophie , Ed Minuit , 1991 , p 22
34- R Marty : La théorie des interprétants , in Langages n 58 , p 37
35 – Greimas , Du sens , p 162 يقول: >mettre le sens en état de signifier<
36 – للمزيد من الاطلاع على هذا التصور انظر: -Greimas , Du sens وخاصة :
– elément d’une grammaire narrative
– les jeux des contraintes sémiotiques
37- Ricoeur , Paul : La grammaire narrative de Greimas , Actes sémiotiques ,1980 , p