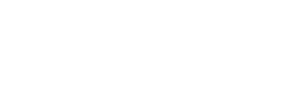أنطوان كومبانيون
ترجمة: محمد الولي
لقد أصبحت التأويلية، وهي فن تأويل النصوص القديمة والعلم المساعد للاهوت والتي كانت تطبق على النصوص المقدسة، خلال القرن 19، واحتذاء باللاهوتيين البروتستانت الألمان في القرن 18 وبفضل تطور الوعي التاريخي الأوروبي، علمَ تأويل كل النصوص وأساس الفيلولوجيا نفسها والدراسات الأدبية. واعتماداً على فريدريك شلاييرماخر (1768 ــ 1834) الذي أرسى أسس التأويلية الفيلولوجية في نهاية القرن 18 فإن التراث الفني والأدبي، ونظراً لأنه لم يعد تربطه علاقة مباشرة مع عالمه الخاص، قد أًصبح غريباً عن أصله (ونفس المشكل يطرح على الأليكورية الهومرية التي عالجت المسألة بكيفية أخرى). إنها تعين هدفها في استعادة الدلالة الأولى لأثر ما، ما دام الأدب، والفن عموماً، مجردا من عالمه الأصلي: إن الأثر الفني، حسب تعبير شلاييرماخير >يكتسب جزءاً من قابلية فهمه من قصده الأول<. ويترتب على هذا >أن الأثر الفني يفقد، حينما ينتزع من سياقه الأول، جزءاً] من دلالته، إذا لم يتمكن التاريخ من الاحتفاظ بهذا السياق< (نقلا عن كادامير ص. 185) . وحسب هذا المذهب الرومانسي والتاريخاني، فإن الدلالة الحقيقية لأثر ما هي تلك التي كانت له في أصله: إن فهمها يعني مراعاة هذا التباعد الزمني وتجنب التأويل الأليكوري.
يقول هانس جورج گادامير: >إن إعادة بناء >العالم< الذي ينتسب إليه الأثر واستعادة الحالة الأصلية التي >قصد إليها المبدع<، وإنجاز الأثر في أسلوبه الأصلي، كل هذه الوسائل المتوخية إعادة البناء التاريخي قد يكون لها مطمح شرعي هو جعل الدلالة الحقيقية لأثر فني ما قابلة للفهم وتحصين هذه الدلالة من عدم الفهم وعن تحيين زائف. …] إن المعرفة التاريخية تفتح إمكانية استعادة ما هو مفقود واسترجاع التراث، وذلك في حدود ما تُكسب من جديد الحياة للعرضي وللأصلي. يكمن كل مجهود التأويلية في العثور من جديد على >نقطة رسو< في ذهن الفنان الذي يجعلنا، هو وحده، نفهم فهماً كاملاً دلالة الأثرِ. (كدامير ص. 186).
يمثل فكر شلايير ماخير، المختصر بهذه الكيفية، الموقف الفيلولوجي (أو اللانظري) الأكثر يقينية، وهو الموقف الذي يطابق بصرامة بين دلالة أثر ما والشروط التي استجاب لها في أصلها، وبين فهمه وإعادة بناء إنتاجه الأصلي. وتبعاً لهذا المبدإ فإن التاريخ يمكنه وينبغي له أن يستعيد السياق الأصلي، واستعادة قصد المؤلف هي الشرط الضروري والكافي لتحديد معنى الأثر.
ومن وجهة نظر الفيلولوجي فإن نصاً ما لا يمكنه أن يقول لاحقاً ما لم يتمكن من قوله في الأصل. وتبعاً للمبدإ الأول الذي وضعه للتأويل شلاييرماخيرفي مختصره سنة 1819 فإن >كل ما يتطلب في خطاب معطى تحديده بكيفية أدق لا يمكن أن يحصل إلا انطلاقاً من المجال اللغوي المشترك بين المؤلف وجمهوره الأصلي< (شلاييرماخير ص. 127). ولهذا فإن اللسانيات التاريخية التي يعود إليها أمر تحديد اللغة المشتركة بين المؤلف وجمهوره الأول بكيفية غير ملتبسة تحتل مركز المشروع الفيلولوجي. ولكن لا ينبغي، مع ذلك، اعتبار المفسرين في العصور الوسيطة مغفلين أو سذجاً : لقد كانوا على علم جيد، شأنهم شأن رَابلِي، بأن هوميروس وبِيرجِيلْ وأُوبِيدْ لم يكونوا مسيحيين وأن نواياهم لم يكن لها أن تنتج ولا أن توحي بمعان مسيحية. ومع ذلك فقد كانوا يقدمون فرضية قصد أعلى من قصد المؤلف الفردي، أو إنهم لم يكونوا يفترضون بأن كل ما يوجد في نص ما ينبغي تفسيره بالسياق التاريخي وحده، المشترك بين المؤلف وقرائه الأُوَل. إلا أن هذا المبدأ الأليكوري هو أقوى من المبدإ الفيلولوجي الذي يخص بالامتياز المطلق السياق الأصلي، يعود لكي ينكر أن نصاً يدل على ما قرأناه فيه، أى يدل على دل عليه خلال التاريخ. إن الفيلولوجية تنكر، باسم التاريخ وبشكل مفارق، التاريخ، كما تنكر بديهة كون النص يمكن أن يدل على ما دل عليه.
هذا المبدأ الفيلولوجي ــ معيارا واختيارا أخلاقيا، لا قضية استنباطية استنباطاً ضرورياً ــ هو الذي كان ينبغي للتأويلية أن تكسره تدريجياً. كيف كانت إعادة البناء للقصد الأصلي ممكناً واقعياً؟ لقد وصف شلاييرماخير ـ وهنا تكمن رومانتيكيته ـ منهج التعاطف أو الاستشراف الذي دعي لاحقاً الحلقة التأويلية، التي يعمد بموجبها المؤول وهو يواجه نصاً ما إلى طرح فرضية حول معناه باعتباره الكلي، ثم يحلل بعد ذلك تفاصيل الأجزاء ثم يعود إلى فهم مُعَدَّلٍ للكل. يفترض هذا المنهج وجود تعالق بين الأجزاء والكل: إننا لا نستطيع أن نعْرِفَ الأجزاء دون معرفة الكل الذي يحدد وظائفها. هذه الفرضية إشكال (إن النصوص ليست كلها منسجمة، والنصوص الحديثة هي أقل انسجاماً بشكل متزايد) إلا أن هذا ليس هو المفارقة الأكثر إزعاجاً. إن المنهج الفيلولوجي يفترض في الحقيقة كون الحلقة التأويلية يمكن أن تردم الهوة التاريخية بين الحاضر (المؤول) والماضي (النص) وتصحيح فعل التطابق التكهني البدءي عبر مواجهة الأجزاء مع الكل، والتوصل بهذا إلى إعادة البناء التاريخي للماضي. إن الحلقة التأويلية تُتَصَوَّرُ هنا بوصفها جدل الكل والأجزاء وبوصفها حوار الماضي والحاضر، وكأن هذين النزاعين وهاتين المفارقتين ينبغي أن تنحلا دفعة واحدة متصاحبتين ومتماثلتين. إن الفهم يربط بفضل الحلقة التأويلية بين ذات وموضوع، وهذه الحلقة التي هي حلقة >منهجية< شأنها شأن الشك الدكارتي، تذوب بمجرد ما تدرك الذات فهم الموضوع فهما تاماً.
بعد شلاييرماخير يأتي ديلتي. (1833 ــ 1911) الذي سيخفف من الادعاء الفيلولوجي الشامل وذلك بمعارضة التفسير، الذي هو وحده ما يمكن أن يتملكه المنهج العلمي المطبق على ظواهر الطبيعة، والفهم الذي قد يكون غاية أشد تواضعاً لتأويلية التجربة الإنسانية. إن نصاً يمكن أن يُفْهَمَ لا يمكن أن يُفَسَّرَ، مثلا، بِنِيَّةٍ ما.
إن فينومينولوجية هُوسِيرْلْ المتعالية ثم فينومينولوجية هيدجر التأويلية قد قوضتا بقدر أكبر هذا الطموح الفيلولوجي ومهدتا الطريق لتقويض الفيلولوجية. فمع إيدموند هوسيرل (1859 ــ 1938)، فإن استبدال الكوجيتو الديكارتي، بوصفه وعياً تأملياً وحضوراً للذات وإهمالاً للآخر، بالقصدية بوصفها فعل الوعي الذي هو دوماً وعي بشيء ما يربك تطابق (empathie) المؤول الذي كانت التأويلية تفترضه. وبعبارة أخرى فإن الحلقة التأويلية لم تعد >منهاجية<، ولكنها تشرط الفهم. فإذا كان كل فهم يفترض استباق معنى (الفهم الأولي) فإن أي أحد يريد فهم نص ما، يتوفر دوماً على مشروع حول هذا النص؛ والتأويل يتكئ هنا على فكرة مسبقة. ومع مارتن هايدجر (1889 ــ1976) اعتبرت هذه القصدية الظاهراتية تاريخية : إن فهمنا الأولي، غير المستقل عن وجودنا أو عن كينونتنا هنا (Dasein) يمنعنا من الانفلات من وضعنا التاريخي الخاص لفهم الآخر. إن ظاهراتية هايدجر ما تزال قائمة على المبدإ التأويلي الذي هو مبدأ الدورية والفهم المسبق، أو استباق المعنى، إلا أن الحجة التي تجعل من شرطنا التاريخي فكرة مسبقة عن كل تجربة يقتضي أن إعادة بناء الماضي قد أًضحت مستحيلة. يؤكد هايدجر > أن المعنى هو ذلك الذي ينفتح عليه الإسقاط المبنْيَنُ بمسبقات المكتسب والمقصود والمحصل التي يصبح، في علاقة معها جميعاً، شيءٌ ما قابلاً للفهم باعتباره شيئاً< (هايدجر ص. 197). لقد تم الانتقال من التطابق إلى المشروع، ثم إلى المسبق وهكذا أصبحت التأويلية حلقة، إذا لم تكن مفرغة أو قدرية، إذ إن هايدغر قد تفادى قصداً هذه التمييزات في الوجود والزمن : > إن الرؤىة في هذه الحلقة حلقة مفرغة وتفادي وسائل تجنبها …] يعني التجاهل العميق والممتلئ لما هو الفهم<، نفسه ص. 198)، فإنها على الأقل غير اختيارية ولا يمكن تخطيها، إذ أن الفهم نفسه لا يعود ينفلت من إسار المسبقات التاريخية. إن الحلقة لا تنحل مع ذلك حينما يغدو النص مفهوماً؛ إنها لا تعود >شكاً تاماً<(5) ولكنها تصبح منتمية إلى بنية فعل الفهم نفسها: ويضيف هايدجر: >وعلى العكس، من ذلك، إنها التعبير عن البنية الوجودية المستندة على مسبقات الوجود هنا< (نفسه، ص. 199). بهذا ستصبح الفيلولوجية كائناً خرافياً إذا لم نتمكن من الأمل في الخروج من عالمها الخاص الذي انحبسنا فيه كما في فقاعة هواء مائية.
لم يعالج هوسرل ولا هايدجر تأويل النصوص الأدبية بشكل أساسي إلا أنهما وضعا سؤال الحلقة الفيلولوجية. لقد أعاد هانس جورج گادامير في كتابه الحقيقة والمنهج (1960)، وفي ضوء أطروحتيهما، المشاكل التقليدية للتأويلية منذ شلاييرماخير. ما معنى نص ما؟ ما هي تمييزية نية المؤلف بالنسبة إلى المعنى؟ هل نستطيع أن نفهم نصوصاً هي غريبة عنا تاريخياً أو ثقافياً؟ هل يعتبر الفهم تابعاً لوضعنا التاريخي؟
يقول جورج گادمير: >إن إعادة بناء الشروط الأصلية، كما هو الأمر بالنسبة إلى أىة استعادة، لهي محاولة تدفع بها تاريخية وجودنا إلى الفشل. إن ما أعيد بناؤه، أي الانبعاث من السلب، ليس هو الحياة الأصلية …] إن نشاطاً تأويلياً يعتبر الفهم استعادة للأصل لهو مجرد نقل لمعنى أصبح الآن ميتا (كادمير ص. 186)
لم يعد هناك إذن، بالنسبة لتأويلية ما بعد الهيدجرية، من أسبقية الإدراك أو >إرادة قول< المؤلف، ومهما كان تصور إرادة القول هذه عريضا. إن إرادة القول هذه وهذا التلقي الأول لن يستعيدا بالنسبة إلينا وفي أي حال أي شيء واقعي.
وتبعاً لگادامير، فإن دلالة نص لا تستهلكها نيات مؤلفه. فحينما ينتقل نص من سياق تاريخي أو ثقافي إلى سياق آخر، فإن دلالات جديدة تلحق به، وهي الدلالات التي لم يتوقعها المؤلف ولا القراء الأول. إن أي تأويل لهو تأويل سياقي تابع لمعايير عالقة بالسياق الذي يحدث فيه هذا التأويل، ولا يمكن معرفة النص أو فهمه كما هو في ذاته. وهكذا فبعد هايدغر نكون قد انتهينا من التأويلية التي بدأت مع شلاييرماخير. إن أي تأويل قد أصبح متصوراًحواراً بين ماض وحاضر أو جدل سؤال وجواب. إن الهوة الزمنية بين المؤول والنص لا يمكن سدها كما لا يمكن تفسيرها أو فهمها، ولكنها تصبح تحت تسمية ذوبان اختلاط الآفاق سمة لا يمكن تفاديها وهي سمة التأويل المنتجة : إن هذه التأويلية، بوصفها فعلاً، تجعل المؤول يدرك، من جهة، أفكاره المسبقة، ويحتفظ بالماضي في الحاضر، من الجهة الأخرى. إن الجواب الذي يقدمه النص تابع للسؤال الذي نطرحه عليه إنطلاقاً من وجهة نظرنا التاريخية، وكفاءتنا على إعادة بناء السؤال الذي يجيب عليه النص، أي أن النص يحاور هو أىضاً تاريخه الخاص.
لقد ترجم كتاب گادامير إلى الفرنسية ترجمة جزئية، وبشكل متأخر جداً، وذلك سنة 1976. وكان الكتاب، وهو يستخلص النتائج من ميتافزيقا هيدجر لتأويل النصوص، مسايراً للنقاش الذي عرفته فرنسا خلال الستينات والسبعينات حول الأدب، والأكثر من هذا فإن الكتاب انتهى بربط تأويلية السؤال والجواب بتصور للغة باعتبارها وسيلة للتعبير عن إرادة القول المسبق. وفي هذه الحدود لم تكن التأويلية الفينومينولوجية قد جعلت اللغة إشكالا، ولكنها دافعت عن كون الدلالة، الكامنة وراء اللغة، يعبر عنها بواسطتها وتعكسها. ولهذا فإن مفهوم هوسيرل >إرادة القول< كان يعاني من إثم >المركزية اللوغوسية< للميتافزيقا الغربية التي انتقدها ديريدا في >الصوت والظاهرة< سنة 1967، إذ لم يكن معنى النص مستهلكاً بالنوايا كما لم يكن متطابقاً معها ـ فلا يمكن اختزاله إلى المعنى الذي رامه المؤلف ومعاصروه ـ ولكن ينبغي له أكثر من ذلك أن يضمن تاريخ نقد كل قراء كل الأجيال، تلقيه الماضي الحاضر والمستقبل.
النص الذي قمنا بترجمته مأخوذ من كتاب