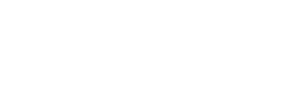سعيد بنگراد
إن الغاية من تقديم هذه المجموعة من الملاحظات هي رفع بعض الالتباس الذي علق بالدراسات الأدبية الحديثة. وهو التباس يتجلى عادة في الخلط بين الأدوات الإجرائية باعتبارها ظاهر التصور النظري وآليات تحققه، وبين النظرية باعتبارها رؤية خاصة بنمط إنتاج الدلالة وتداولها. وعلى أساس هذه الملاحظات العامة يمكن ملامسة بعض القضايا الخاصة بطبيعة المعنى وشروط إنتاجه وبنائه.
فالمعنى لا يمكن أن يصاغ وأن يوجد بشكل مرئي إلا في حدود انبثاقه من عمليات تخص بناء النص وأشكال تلقيه وتداوله. ومن نافلة القول إن عمليات التنصيص متنوعة تنوع الممارسة الإنسانية وغناها،. وعلى هذا الأساس فإن الكشف عن الترابط الموجود بين هذه المادة المضمونية غير المرئية وبين أشكال التحقق هو السبيل إلى تحديد بؤرة التدليل وأشكال التأويل المرتبطة به.
إن ما نحاول الإجابة عنه في الصفحات الآتية يتعلق بأسئلة من نوع :
– كيف تتشكل الواقعة، وتتحول إلى كيان مستقل بحدود وقواعد خاصة للاشتغال؟
– كيف يأتي المعنى إلى الواقعة؟
– كيف يمكن الفصل بين الواقعة المتحققة والنسق المولد لها ؟ وهل الواقعة مجرد تحقق شبيه بكل التحققات الأخرى، أم أن كل تحقق يقوم بإغناء المادة المضمونية وينوع من أشكال حضورها؟
I – المعنى بين المحايثة(1) والتحقق
في البداية يمكن التأكيد أن كل إنتاج للمعنى مرتبط بمادة مضمونية سابقة في الوجود على التحقق من جهة، ومرتبط من جهة ثانية بسيرورة معينة للتعرف والإدراك. إن العمليتين معا تشكلان سيرورة التدليل، وفي غياب هذه السيرورة ( السميوزيس ) يستحيل الحديث عن بناء نصي. ولن تكون هذه السيرورة سوى الطريقة التي يتم بها تنظيم الوحدات المقتطعة من النسق الدلالي الشامل وفق استراتيجية محددة للآثار المعنوية المراد إنتاجها.
من هنا، فإن أي تساؤل حول المعنى سيثير حوله، دفعة واحدة ، سلسلة من الأسئلة الخاصة بعمليات مثل : “الإنتاج” و”التداول” و”الاستهلاك” و”القراءة” و”التأويل” و”الموضوعية” و”الذاتية” و”الإمساك الحدسي أو الانطباعي بالوقائع”، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تؤكد من جهة الطابع المركب لظاهرة المعنى وأنماط وجوده؛ فالمعنى لا يوجد خارج هذه العمليات، إنه ينبثق من الإنتاج والاستهلاك والتداول. وتؤكد من جهة ثانية البعد التداولي للمعنى، فالمعنى لا يوجد إلا ضمن سياق وضمن شروط خاصة للتلقي تحدد له أبعاده وامتداداته.
ورغم كل الصعوبات التي تثيرها القضايا المرتبطة بالمعنى – وربما بسبب كل هذه الصعوبات- فإن المحلل لا يستطيع التخلص من المعنى ولا تجنب الخوض فيه، فالواقعة موجودة في حدود أنها تحيل على بناء كون دلالي ما، والممارسات الإنسانية ذاتها هي كما هي في حدود أنها تنتج سيلا من الدلالات التي تعد أساس الإدراك والقراءة والتأويل.
إن الخلاصة المباشرة لهذه المسلمة أن تعاملنا مع التجربة المعنوية يتم من خلال وسائط محسوسة، فلا وجود للمعنى إلا من خلال استثماره في وقائع مادية قابلة للإدراك والمعاينة : قد يتعلق الأمر بالنصوص المكتوبة أو الشفهية، كما قد يتعلق الأمر بما ينتجه الإنسان من وقائع عبر جسده وطقوسه، كما قد يكون ذلك باديا من خلال الأشياء التي يودعها الإنسان قيما دلالية تسجل امتداده في ما يوجد خارجه. إن الدلالة لا تكترث للمادة الحاملة لها، وهذا معناه أن التجربة الإنسانية كلية وتحتاج، لكي تكشف عن نفسها، إلى مواد تعبيرية بالغة التنوع.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن المعنى ليس محايثا للشيء وليس منبثقا من مادته، إنه وليد ما تضيفه الممارسة الإنسانية إلى ما يشكل المظهر الطبيعي للواقعة. وبعبارة أخرى، فإن الشيء لا يدل من خلال كيانه الخاص، كما لا يحيل على أي شيء آخر سوى ذاته : هذا الشيء هنا لا أقل ولا أكثر. وهذا يعني القول بأن التعرف على الواقعة شيء وأن التدليل شيء آخر. فالتعرف على الشيء باعتبار حجمه وامتداده وأبعاده ولونه وصفته لا يقود إلى إنتاج دلالة ما، فالتدليل مرتبط بموقع هذا الشيء ضمن العلاقات الإنسانية : فهو خزان للقيم وبؤرة للحالات الوجدانية وذاكرة للأحداث. ولعل هذا ما يبرر التمييز بين الأنساق الدالة، وهو ما يبرر أيضا نظرتنا إلى اللسان باعتباره أرقى هذه الأنساق وأشملها. إن اللسان هو مؤول كل الأنساق الأخرى وهوالكاشف عن عناصر تكونها.
والحاصل أننا أمام نوعين من التدليل : تدليل مرتبط بأنساق غير لسانية ومجالها الكون كله بأشيائه وأحداثه وطقوسه، وآخر لصيق باللسان ووحداته. إن التدليل في الأنساق الأولى يأتي إلى الوقائع من خارجها، فالمؤلف > يبثه في عمله، أما في الحالة الثانية فيكون فيها التدليل معبرا عنه من خلال العناصر الأولية في استقلال عن العلاقات التي يمكن أن تنسجها هذه العناصر فيما بينها < (2). وحسب هذا التمييز، فإن طريقة الكشف عن الدلالة ستختلف من هذا النسق إلى ذاك. > ففي الحالة الأولى يستخرج التدليل من العناصر المنظمة لعالم مغلق، وفي الحالة الثانية فإن التدليل ملازم للعلامات ذاتها<.(3)
ويعد هذا التمييز الذي يقيمه بنفنيست بين الأنساق من جهة، وبين طرق إنتاج الدلالة داخلها من جهة ثانية، أمرا في غاية الأهمية. فإذا كان المعنى يأتي إلى الشيء من خارجه، فإن أمر الكشف عنه لا يمكن أن يتم إلا عبر اللسان. فاللسان هو النسق المؤول والأكثر قدرة على الكشف عن مجمل التسنينات التي تبلورها الممارسة الإنسانية باستمرار.
ولنا في الصورة خير مثال على ذلك. فأن تكون الصورة حاملة لدلالة ما، فإن هذه الدلالة لا توجد في عناصرالصورة ذاتها بل تعود إلى كون آخر. فإذا تركنا جانبا كون أن إدراك الصورة يقتضي رد فعل ناتج عن مثير فيزيقي يقود إلى العمل على التعرف على ماهية هذا ” الشيء ” الموجود أمامي، فإن التدليل داخلها يقتضي العمل انطلاقا من أسنن سابقة. أسنن ستكون هي الأصل في إنتاج الدلالة ومصدرا للإدراك.
وبناء عليه، فأن تكون الصورة تمثيلا لامرأة أو رجل، أو لشيخ أو صبي، فتلك تمييزات لا تخص الدلالة، بل تعود إلى إدراك يقود إلى التمييز بين الأشياء والكائنات، وبين الكائنات عامة والإنسان خاصة. صحيح أن إدراكي سيتطلب سلسلة من العمليات اللامرئية : وجود أقسام متنوعة يتحدد عبرها القسم الذي تحيل عليه الصورة ( الحيوان، الأشياء الطبيعية منها والمصنوعة)، وجود سمات مظهرية (الحجم، الامتداد، اللون، الضوء). إلا أن هذه العناصر في ذاتها لن تقودني إلى توليد دلالة تخص الصورة، بل ستقود فقط إلى إدراك الصورة. ذلك أن الإدراك مبني – منذ اللحظات الأولى- على الاختلاف لا على التشابه. إن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالحديث عن قيم دلالية تعد الصورة مهدا لها، أي تقديم الصورة من أجل التمثيل لقيمة أو قيم ما ( صور الدعاية السياسية مثلا ).
وهكذا فإن إحالة الصورة على ” الحنان ” أو ” القسوة ” ، أو على ” الغموض أو الشفافية “، أو على “الاعتداد بالنفس ” أو “الانطواء “، أمر يعود إلى سجل من طبيعة غير طبيعة التعرف. فالتدليل هو ما يتم الحصول عليه انطلاقا من عملية تسنين ليست مرئية من خلال المادة التعبيرية. إن الأمر يتعلق بسجل التسنينات التي بلورتها الممارسة الإنسانية وقدرة هذه الممارسة على منح الأعضاء والأشكال والألوان دلالات إضافية تتجاوز من خلالها الوظيفي والاستعمالي. فالعين مثلا لا ترى فقط، إنها “تحدق” و”تقسو” و”تحن”، وهي “ترفض” و”تقبل” أيضا. وليست اليد لحمل الأشياء فقط، إنها “تصد” و”تستجدي” و”تقمع” و”تمنح”…
وفي هذه الحالة، واستنادا إلى ما سبق، يمكن النظر إلى القضايا التي يحيل عليها الطابع المركب للمعنى من زاويتين لا يمكن الفصل بينهما :
1- الزاوية الأولى تتعلق بتشكل الواقعة ذاتها. فلا وجود للواقعة إلا باعتبارها اختراقا لمتصل لا يحمل دلالته في ذاته. وهو أمر يخص جميع مكونات الحياة نفسها. فإذا كان الكون كيانا متصلا يحضر في الواقع وفي الذهن من خلال سلسلة من الأشكال، فإن إمكانية التدليل داخله لا تتم إلا من خلال هذه الشكلنة ذاتها. > فكل نشاط لا يدرك ولا يتحدد إلا من خلال مثوله عبر شكل ما داخل الزمان وداخل الفضاء، فالحياة ذاتها لا تتحدد إلا باعتبارها خالقة للأشكال. إنها شكل والشكل هو نمط الحياة<(4). ومن هذه الزاوية يجب النظر إلى اشتغال الدلالة. إن الدلالة لا يمكن أن تتحدد إلا باعتبارها إجراء يقود من المتصل المحروم من أي شكل إلى النسخة المتحققة. >فالروابط التي تجمع، داخل الطبيعة، بين الأشكال لا يمكن أن تكون روابط عرضية، فما نطلق عليه الحياة الطبيعية هو كذلك باعتباره رابطا ضروريا بين الأشكال، وبدون هذا الرابط لا يمكن الحديث عن حياة طبيعية.<(5)
وما يصدق على الحياة الطبيعية يصدق أيضا على الأكوان الدلالية. فما يجعل من الصوت وحدة دالة هو الصمت الذي يسبقه وكذا الصمت الذي يليه، وما يجعل من الإيماءة فعلا دالا، أي عنصرا داخل دائرة إبلاغية ما، هو السكون الذي يسبقها والسكون الذي يليها. إن الواقعة على هذا الأساس تدل لأنها قابلة للفصل والعزل وقابلة، تبعا لذلك، للقراءة بوصفها وحدة معنوية تامة. ويعد هذا الفصل وليد الشروخ التي يحدثها فعل التحقق في المتصل غير الدال : فأن يصنع الطفل لعبة من عجين، فهذا معناه أنه يعطي شكلا لمادة تفتقر إلى الشكل، أو هي مادة قابلة لأن تصاغ في كل الأشكال.
2- أما الزاوية الثانية فتعود إلى طبيعة المعنى و” جوهره”. فالمعنى هنا مبدأ للتنظيم، فلا يمكن الحديث عن العلامة إلا باعتبارها أداتنا الرئيسة، إن لم تكن الوحيدة، لتنظيم التجربة الإنسانية. ولهذا فإن الواقعة ليست كذلك إلا في حدود إحالتها على معنى ( معاني) يجعل منها كيانا قابلا للإدراك والمعاينة ضمن سياقات بالغة التنوع. فهذا السياق قد يكون خاصا أو عاما، مفتوحا أو مغلقا، كليا أو جزئيا. إن حدود المعنى هي حدود الواقعة، وحدود الواقعة هي ما يسمح به امتداد المعنى عبر العناصر المشكلة للواقعة.
وعلى هذا الأساس فإن أي تجل للواقعة سيحيل، في الآن نفسه، على مظهرين منفصلين ومتداخلين للمعنى :
– أحدهما مرئي من خلال نسخة. والنسخة في لغتنا ( لغة بورس في واقع الأمر) هي الواقعة المتحققة، في تقابلها مع النموذج الذي يفسرها ويجعل من إدراكها أمرا ممكنا وسهلا. فلا وجود لواقعة تمتلك خصوصية مطلقة في الوجود والاشتغال والأصل. فكل ما يتحقق، إنما يتم انطلاقا من نموذج عام يشتمل على كل النسخ الممكنة، أو على كيان يمكن أن ننظر إليه باعتباره “التحقق الأمثل “. من هنا فإن المظهر الأول للمعنى هو ما يَمْثُل مباشرة من خلال الوجه المرئي للواقعة، أو من خلال ما تقدمه الواقعة في شكلها الظاهري.
– والثاني مستتر ومفترض من خلال النسخة المتحققة. ذلك أن أي تحقق ليس سوى انتقاء يؤدي إلى تحيين عناصر وإقصاء أخرى. إنه يدفع بمجموعة كبيرة من الوحدات الدلالية إلى التراجع لكي يستقيم وجود الواقعة. إن خلق كيان مستقل ومنسجم يفترض القيام بتهذيب الوحدات الدلالية وتشذيبها. وبعبارة أخرى، يجب إرساء قاعدة يتم وفقها التحيين وبناء كيان الواقعة. وفي هذه الحالة، فإن التأويل- باعتباره نشاطا يتكفل بإعادة تنظيم العناصر وفق منطلقات دلالية خاصة – هو العودة بالعناصر إلى أصلها الأول والبحث داخلها عما يخلق انسجاما جديدا للواقعة. والمثال التالي يوضح هذا التباين بين المظهرين :
“أكلت من ثمار هذه الشجرة”
إن هذه الواقعة تشتمل على ما نسميه عادة بالمعنى المباشر، أو المعنى الذي لا يستدعي أي جهد للكشف عنه. ويحيل المعنى المباشر في لغتنا على ما هو معطى من خلال عناصر الواقعة ذاتها دون أن يتجاوز حدود ما تقتضيه التجربة المشتركة. فهو من هذه الزاوية يشكل نقطة انطلاق لدلالة قد لا تتوقف عند حد بعينه، إلا أنه يعد أمرا أساسا في كل عملية تأويل لاحقة. ويمكن إجمال هذا المعنى المباشر في وجود ذات ( أنا ) تقوم بفعل يتلخص في قطف فاكهة من شجرة من فصيلة الأشجار المثمرة.
وكما هو واضح، فإننا نستبعد، في محاولتنا للحصول على هذا المعنى، كل استعمال استعاري أو إيحائي للواقعة محتفظين فقط بما يحيل على التجربة الإنسانية في بعدها المادي لمحسوس، أ ي الاستجابة للوظيفة النفعية المباشرة.
انطلاقا من هذا الأساس ” المباشر” و” الأصلي” و” التقريري” يمكن تصور مسيرات تدليلية تحين – من خلال كل تحقق- دلالة بعينها :
– فقد تكون الشجرة وطنا، وفي هذه الحالة سيتم استحضار كل ما له علاقة بالوطن والمواطن والاستغلال وطبيعة توزيع خيرات الوطن، والفوارق الطبقية …
– وقد تكون الشجرة امرأة أحبها هذا الرجل، وهو هنا يعبر عن استمتاعه بـ ” خيراتها”.
– وقد يتعلق الأمر بامرأة أحبها الكثيرون واستمتع بها الكثيرون، والذات هنا تعبر عن استمتاعها، هي الأخرى، بثمار هذه المرأة، كما لو أن لسان حالها يقول : أنا أيضا مرررت من هناك …
– وقد يكون الأمر خاصا بالتعبير عن ألم وحسرة من خديعة أوفعل مشين ارتكبته امرأة ما في حق هذا الرجل. وفي هذه الحالة، فإن الخطاب موجه إلى كل من وقع فريسة خديعة من هذا النوع، والثمار ستكون تعبيرا عن مضمون نقيض قد يكون السموم أو الهموم.
– وقد يكون الاهتمام منصبا على الإغراء الذي تحدثت عنه الديانات، فقد أغرت حواء آدم فأكل التفاحة فخرجا من الجنة إلى الأرض…
– كما قد تشير هذه الجملة إلى الواقعة التاريخية الشهيرة التي انتهت بصلح الحديبية. فكما هو ثابت في النص القرآني، فإن المسلمين سيبايعون الرسول تحت الشجرة. وبإمكان القارئ أن يستحضر عمق الواقعة وأبعادها التجريدية لا في الإسلام فحسب بل في كل المواقف التاريخية المشابهة.
– وقد يتعلق الأمر، ضمن سياق غريب عنا ( الهند مثلا ) ، بالشجرة التي تغرسها العروس يوم زفافها انتظارا لإثمار مزدوج : ثمرة الشجرة وخصوبة المرأة . – الخ …..
إن كل هذه المسيرات التأويلية تنطلق، من أجل بناء كونها الدلالي، من أساس مرئي هو ما تقدمه الواقعة في مظهرها المباشر. فإذا كان التأويل ممكنا، فإن ذلك يعود إلى قدرتنا على إسقاط مبادئ جديدة لتنظيم هذه التجربة المعطاة من خلال الحدود الظاهرة للعلامة وفق أنماط متنوعة للتدليل. وهو ما يعني، بعبارة أخرى، إعادة بناء قصدية النص وفق مقتضيات السياقات التي تقتضيها القراءات المتنوعة.
انطلاقا مما سبق ذكره، يمكن النظر إلى المعنى باعتباره إجراء مرتبطا بنسق. فالمبدأ المنظم (والمعنى مبدأ للتنظيم كما سبق أن رأينا) يتحكم في الإجراء( التحقق) ويحدد له مجمل تحققاته، ويرسم له، في الآن نفسه، مجموع إرغاماته. وعلى هذا الأساس، فإن كل واقعة تشتمل، بشكل ضمني أو صريح، على سلسلة من الإرغامات التي تحدد، بهذا الشكل أو ذاك، قراءاتها الممكنة. من هنا، فإن ما ينظم الواقعة في كليتها هو نفسه ما يحكم التدليل، أي ما يسهم في بزوغ الدلالة وانتشارها.
ولهذا السبب يجب ألا نبحث عن الدلالات خارج أسوار الواقعة. فما يوجد خارج الأسوار يحضر في الواقعة على شكل إحالات رمزية واستعارية وإيحائية تشير إلى الوجود الكموني لعوالم تحتاج، في تحققها، إلى تنشيط ذاكرة الواقعة وصنع سياقاتها الممكنة لكي تمثل أمامنا كتجارب بالغة الغنى والتنوع. حينها سينتفي الحديث عما يوجد داخل الواقعة وعما يوجد خارجها ( انظرالمثال السابق). فما يوجد في “الداخل” يوحي ويتضمن ما هو موجود في ” الخارج”.
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن المعنى لا يمكن أن يصبح مرئيا إلا في علاقته بالنسق المولدله.(6) والنسق في هذا السياق هو سلسلة من الإرغامات التي نقوم من خلالها بإنتاج وتداول واستهلاك الواقعة. ذلك أن > كل نسق يشتمل على مجموعة من القواعد. وهذه القواعد تتحدد إيجابا من خلال خصائصها الذاتية ] وتتحدد سلبا من خلال إحالتها على ما ليس هي < (7). فالنسق باعتباره نموذجا للفعل ( قد يتعلق الأمر بالسلوك الإنساني في مفهومه العام، وقد يتعلق الأمر بإنجاز فعل مخصوص، وقد يتعلق الأمر بعقيدة يُنظم السلوك داخلها وفق قواعد خاصة ) يشتمل على سلسلة من القواعد التي يقوم الفرد وفقها بتنظيم سلوكه الخاص والعام، كما يحيل سلبا على قواعد محددة “للمحرم “و”المحظور” و”المكروه” …
إن التسليم بوجود نسق تقاس عليه النسخ المتحققة يضعنا مباشرة في قلب إشكالية الإمساك بالمعنى وتداوله وتحديد سبل انتشاره الاستقبالي ضمن مسيرات تتحقق عبرها ” أكوان دلالية” متنوعة العدد والأشكال، وسيكون لكل كون من هذه الأكوان قوانينه التي تحدد طريقته في الكشف عن المعنى.
II – المعنى بين “الذاتية” و”الموضوعية”
من البديهي القول إننا لا نتواصل إلا من خلال النماذج. فالنسخ المتحققة مثيرات ومحفزات للذاكرة تقودنا إلى صب المتحقق فيما يشكل وجهه المجرد. فأمام ” عرس ” أو ” مأتم” أو أي سلوك ما، لا تجهد العين نفسها من أجل التعرف على ” ما يجري” ، فهي تمتلك “العرس” و”المأتم” على شكل صورة مجردة تتحين بأشكال متنوعة ضمن نسخ خاصة. تلك قاعدة إدراكية مركزية في السلوك الإنساني.
وبناء على هذا، علينا، لكي “نجعل من المعنى كيانا قادرا على التدليل ” ( mettre le sens en état de signifier على حد تعبير گريماص) أن نسلم، مبدئيا، بوجود سقف مجرد للقيم الدلالية لا نرى منه سوى وجوهه المتحققة، ويشتغل بصفته بنية حاضنة لأساس قيمي مجرد. إن هذا السقف المجرد وغير المرئي يشكل الأساس الذي تتحقق انطلاقا منه كل الوقائع الخاصة.
فهذه النصوص التي نعاين ( وكل واقعة كيفما كانت طبيعة مادة تجليها تعد نصا ) ليست سوى تحقق خاص يتم عبر المفصلة التي يتطلبها الخروج من دائرة المتصل السديمي إلى اللامتصل المتمفصل في وحدات مرئية.
وتلك مسألة تخص الإدراك في كليته. فنحن في حالة المتصل غير قادرين على إنتاج أي دلالة ولا يمكن أن نتصور وجود معنى. إن “السديمي” و”الهيولي” و”عديم الشكل” حالات لا تؤدي إلى إدراك أي شيء. فلكي تكون هناك “علامة” لابد من تصور عالم تخترقه الأشكال، ولكي يكون هناك معنى لابد من التحول من الجواهر إلى الأعراض. لهذا فإن الأمر يتعلق، في عملية بلورة النصوص، بالخروج من دائرة المادة المضمونية المجردة إلى ما يَمْثُل، عبر العلاقات المتنوعة، كوجه مشخص لهذه المادة. وهذا التحقق نفسه ليس سوى نسخة ضمن نسخ أخرى ممكنة.
إن افتراض انتقال من أصل مولد مغرق في التجريد ( والأمر لا يتعلق بطبيعة الحال بمادة مضمونية سهلة التحديد والوصف، بل يتعلق بفرضية تأويلية كما سنرى لاحقا ) إلى وجه مشخص متحقق في واقعة محدودة من حيث الحجم ومن حيث الأبعاد الزمانية والفضائية، هو الأساس الذي نبني عليه مركزية التقابل بين النسق والإجراء، أي بين النموذج العام والمجرد وبين الواقعة الخاصة المحددة زمانا ومكانا ( مقولة الخير ككون مجرد يستعصي على الضبط والتحديد، وإدراج نفس المقولة داخل نص “يشخص” حدودها ضمن سياق خاص ). وهو أيضا الأساس الذي نستند إليه في الحديث عن “موضوعية” المعنى. وقد يكون هو أيضا نفس الأساس الذي يبرر ضرورة الفصل بين المضامين التي تشتمل عليها الواقعة وبين العمليات الذهنية المرافقة لكل فعل تأويلي.
وبما أن الوقائع الخاصة ( كيفما كانت طبيعة هذه الوقائع ) هي سبيلنا الوحيد للتعرف على المضامين القيمية المجردة، ( وهذا افتراض من طبيعة فلسفية، ذلك أننا لا نستطيع إدراك أي نشاط إلا عبر الأشكال المعبرة عنه )، فإن تحقق هذه الوقائع هو بالضرورة تحقق جزئي، أي لا يتعلق إلا بصياغة مشخصة وخاصة لقيمة مجردة. فالواقعة الواحدة لا تمتلك القدرة على استيعاب مجمل التحققات الدلالية.
لماذا إذن هذا القصور وهذه الجزئية في التحقق؟
إن التحقق في ذاته لا يمكن أن يكون إلا كذلك. فمحدودية الفعل الإنساني في الزمان وفي المكان تحيل على محدودية القيمة من حيث القدرة على استيعاب كل الحالات الوجدانية. وعلى هذا الأساس، فإن السيرورة التدليلية ( ونحن نفضل استعمال “السيرورة التدليلية” عوض “الدلالة” لأن ماهو قابل للوصف حقا هوالسيرورة وليس مضمونها ) المنبثقة من هذه الواقعة يجب النظر إليها باعتبارها اقتطاعا لجزئية معنوية معينة سيتم إدراجها ضمن مسير تأويلي ممكن ( أو مسيرات تأويلية ) يضمن لها الاستقلالية في الوجود، كما يضمن لها، في الآن نفسه، ارتباطها مع أصلها المولد، أي ما ينسج علاقتها بالوحدة التي تحتضنها. ذلك أن تنظيم المعنى عبر أشكال خطابية متنوعة يفترض التحول من التصور الاستبدالي للوحدات إلى وجهها التوزيعي.
وبناء على هذا، يمكن أن نقيس كل الوقائع على الكلمة، فإذا كانت الكلمة ( وكان يجب أن أستعمل اللكسيم أي الوحدة المعجمية ) هي بالتحديد سلسلة من الممكنات الدلالية القابلة للتحقق جزئيا أو كليا، فإن اندراجها ضمن خطاب خاص يقلص من هذه الممكنات عبر تحديد سقف دلالي موحد للخطاب وتناظراته.
والخلاصة أن كل وحدة من الوحدات التعبيرية تحتضن داخلها سلسلة من القيم المودعة في أشكال تدليلية ( أو مؤولات بتعبير بورس ) تقوم بتنظيم تجلياتها المتعددة. إن الأمر يخص وحدات مضمونية لا تتحقق إلا عبر مسير دلالي خاص، وكل مسير قد يولد آخر فرعيا وهكذا دواليك. وهذا معناه أن كل إمكان دلالي هو في واقع الأمر بناء خاص للواقعة. أو هو، بعبارة أخرى، استعمال خاص للكلمة.
إن الفضاء الفاصل بين المظهرين يحيل من جهة على أدوات التحقق ( النص الشعري – النص السردي -الصورة بأشكالها -اللغة الإيمائية وكذا مجمل المواد المشكلة للتوسط )، ويحيل من جهة ثانية على المنافذ التي يتسلل من خلالها القارئ إلى العوالم الدلالية للنص بكل أشكاله ومكوناته. ويشكل هذا الفضاء في الوقت ذاته لحظة الفعل الخصوصي، أو ما يأتي به التلوين الثقافي الحاضن للنسخ المتحققة. إننا ننطلق من وحدات مجردة سابقة علينا في الوجود ، إلا أن الممارسة الخاصة تغني وتعدل وتضيف وتعيد تنظيم حدود هذه القيم المجردة.
انطلاقا من هذا، وكما أشرنا إلى ذلك في الفقرة السابقة، فإن هذا الأساس (ولن تهم التسمية التي سنعطيها له سواء أطلقنا عليه “النسق” أو أطلقنا عليه “البنية الدلالية البسيطة “، أو ” النسق الدلالي الشامل ” ) هو ما يؤكد الطابع “الموضوعي للمعنى” . فما المقصود بالموضوعية في هذه الحالة ؟
لا تحيل الموضوعية، بالتأكيد، على مادة مضمونية قارة وكلية مودعة داخل النص بشكل سابق على القراءة وعلى فعل التأويل. كما لا تحيل، بالتأكيد أيضا، على معنى واحد ووحيد يمنح النص ما يضمن له هويته الخاصة؛ كما لا يتعلق الأمر بغايات دلالية سابقة على فعل القراءة. إن المقصود بالموضوعية في حالة المعنى هو الاعتراف بوجود قيود يستدعيها تحقق لا يمكن أن يتم إلا في ارتباطه بأصل مولد له. فما قلناه سابقا من أن المعنى لا يتجلى إلا في ارتباطه بنسق يعد ضمانة على وجوده وإدراكه، يفترض أن هذا النسق، إن كان لا يستطيع تحديد مجمل القراءات الممكنة للواقعة، فإنه يقوم على الأقل برسم جملة مسيرات للتأويل لا يمكن للذات المؤولة أن تتجاهلها.
إن المثال السابق : ” أكلت من ثمار هذه الشجرة” يوضح هذا الترابط بوضوح. فإذا كانت الجملة تحافظ على معناها الأول في كل السياقات، فإنها في الوقت ذاته منفتحة على تعدد دلالي بالغ الغنى والتنوع. إلا أن هذا التعدد الدلالي لا يلغي الحد الأدنى المعنوي الذي يشكل منطلقا لكل التحققات. من هنا، فإن الموضوعية لا تتعلق بالمادة المضمونية الموضوعة للتأويل، بل تعود إلى المسيرات التي يجب أن يسلكها فعل التأويل وطرق إنتاجه للمعاني الممكنة للنص الموضوع للتداول. فرغم وجود هذه الاحتمالات التأويلية المتعددة فإن المتلقي >لن يكون بإمكانه القول إن هذه الإرسالية قد تدل على كل شيء. إنها قد تدل على أشياء كثيرة، إلا أن هناك معاني لا يمكن أن تحيل عليها إلا من باب العبث< (8).
يمكن القول إذن إن الواقعة الدالة تشتمل على سلسلة من الإرغامات الداخلية المحددة لبنائها وللطرق التي عبرها تنتج معانيها، ومحددة في نفس الآن لكل المسيرات التأويلية الممكنة. وهذا ما يمكن كل قارئ – ضمن ما تسمح به ممكنات النص الدلالية – من سلك هذا السبيل التأويلي أو ذاك.
والخلاصة أن كل اختيار هو في الوقت نفسه حرية في الانتقاء وإذعان لإرغام : إن المحلل لا يستطيع الوصول إلى كل المعاني التي تحتضنها الواقعة، كما لا يمكنه – ضمن مسيرتأويلي واحد للقراءة- أن يصالح بين كل التأويلات الممكنة. وهذا يعود إلى طبيعة التأويل ذاته.
فبما أن التأويل هو دائما زحزحة للعلاقات، وتغيير للمواقع، وإعادة لترتيب عناصر العلامات، فإن ما يضمن سلامة التأويل ودوامه واستمراره في إنتاج الدلالات المتنوعة هو وجود هذا الحد الأدنى المعنوي المرتبط بتجربة حياتية لا تتجاوز حدود الاستجابة للبعد النفعي فيها. وهذا ما يمكن وصفه بالطابع الموضوعي للمعنى.
من هنا كان الاستناد – نظريا على الأقل- إلى معنى أولي يعد قراءة بدئية في معطيات ظاهرة ما في انتظار فتح آفاق متنوعة أمام مستوى آخر من مستويات التدليل. فلكي يأتي قراء عديدون بدلالات متعددة ومتنوعة لنفس الواقعة، يجب أن يتفقوا في البداية على أن هذه الواقعة تحيل، في بعدها الظاهري المباشر، على معنى أولي ” لا يطعن فيه أحد”. ولو لم يكن الأمر كذلك، لما أمكن الحديث عن تأويل وعن تعدد دلالي. فـ” الأكل” و”الثمار” و” الشجرة ” في المثال السابق، تشكل وحدات تحيل على فعل تعييني قبل أن يكون لها أي استعمال استعاري. فـ” الأكل” يحيل على التهام مادة تتسرب إلى الجسم، قبل أن يكون ” استمتاعا جنسيا”، و” الثمار هي الثمار” قبل أن تكون “أطرافا ومظاهر للإغراء”. وكذلك الأمر مع الشجرة.
إن هذا الحد الأدنى المعنوي يشكل القاسم المشترك لكل الدلالات التي يمكن أن تثيرها واقعة ما. والحد الأدنى المشترك مرتبط بعملية الإدراك ذاتها. فإذا كنا نقيم تعارضا بين ” التعرف ” وبين “التأويل”، أو على الأقل نفصل بينهما باعتبارهما عمليتين ذهنيتين مختلفتين، فذلك لأن التعرف ينبني انطلاقا من جذر ذي طبيعة تعيينية لا يستند في وجوده إلا إلى التجربة المشتركة، في حين يستدعي التأويل فتح الواقعة على محيطها، أي على ما يوجد خارجها، أو على ما كان يسميه بورس بـ “التجربة المفترضة أو الضمنية” ( expérience collatérale) (9). وهذه التجربة الضمنية متعددة بطبيعتها ولا يمكن حصرها في بعد واحد أو سياق بعينه.
وربما لهذا السبب، فإن العقلاء من الباحثين يستعملون عبارة ” تعدد القراءات والمعاني”، ويستهجنون عبارة ” لانهائية القراءات والدلالات “. فالتعددية تفترض نواة معنوية قارة، في حين تدمر مقولة “اللانهائية” كل أساس نقيس عليه اختلاف القراءات في المرحلة الواحدة وفي المراحل التاريخية المختلفة.
فإذا كان المعنى يتحدد في منطلقاته الأولى باعتبار أساسه” الموضوعي” فكيف يمكن الحديث إذن عن طبيعة إيديولوجية لهذا المعنى ؟ وما المقصود في هذه الحالة بالطبيعة الأيديولوجية للمعنى؟ وكيف تتحدد الأيديولوجيا انطلاقا من عمليات قلب مفترضة تخضع لها المادة المضمونية لكي تصبح معاني قابلة للاستهلاك ؟
III – الأيديولوجيا وإنتاج المعنى
لقد ألححنا، في الفقرات السابقة، على الطابع المبني والمركب للقيم الملقاة للتداول عبر الوقائع المحسوسة. وكانت خلاصتنا -الضمنية على الأقل – هي أن العالم الإنساني يمثل أمامنا من خلال واجهتين مختلفتين، تشير كل منهما إلى تنظيم خاص للقيم الدلالية وتحددان نمطا خاصا في تداولها. وضمن هذين النمطين تندرج كل الأحكام والمواقف والسلوكات والأفعال وردود الأفعال. ففي الحالة الأولى يتحدد وجود هذه القيم من خلال صيغ مجردة تتزاحم القيم داخلها على شكل كتل مضمونية عديمة الشكل، وغير قابلة للإمساك لأنها مستثمرة في كيانات غير مرئية ومستعصية على الضبط. ويتحدد الوجود الثاني من خلال أشكال التحقق المتعددة التي تخرج بالقيم من صيغة التجريد إلى ما يؤكد طابعها المجسد في وقائع بعينها.
وبناء عليه، يمكن القول إن ميلاد النص هو عملية تقود من مادة مضمونية عديمة الشكل إلى الوجود الفعلي للقيم. فالنص هو اختراق خاص لمتصل لا حدود له. إنه اختراق يصوغ القيم ويعدل ويحذف ويضيف مستندا في ذلك إلى أهلية المتلقي وأهلية الموسوعة الثقافية التي ينتج ضمنها النص. فماذا يعني “الحب” و”الخير” و”الصدق” و”الحقد” و”العدوانية” و”الحرية” وكافة القيم الأخرى خارج حدود النسخ التي تخبر عنها ؟. فهذه القيم لا يمكن أن تدل على أي شيء > فالكون الدلالي يتميز بكلية ” المادة الدلالية “، ولا يمكن أن يدل إلا من خلال شبكة التمفصلات التي يشتمل عليها <(10).
فما يتم تكثيفه عبر الفعل الخاص هو ما سيتحول إلى مادة، أي إلى كون قيمي، يغذي السلوك الخاص، وكل قيمة ليست سوى “حكم” خاص بالفعل المتحقق. من هنا، فإن التدليل لا يوجد خارج الفعل وخارج مداراته، إنه هو التدليل؛ وتصور مسير تدليلي يحتاج إلى تحويل ما يَمْثُل كعلاقات لازمنية وغير موجهة، إلى عمليات تُسَرِّب السياق كشرط أساس للإمساك بالدلالة. وتلك هي القاعدة الأساسية التي انطلق منها گريماص لتحويل عالم المعنى إلى سيرورة ” إنتاجية ” دائمة التحول : أصلها معلق في أشكال مجردة، ووجهها المحسوس يتحقق في سيرورات عبر نصوص بجميع الأحجام والأشكال والأنواع. فمن قلب “المجرد الساكن” ينبعث المتحرك الفعلي، ولن يقود المتحرك الفعلي إلا إلى إعادة صياغة المضامين وتنويعها وفق مستجدات الممارسة الإنسانية.
وتعد هذه الصيغة العامة استعادة مختصرة للتمييز الذي يقيمه گريماص بين كونيين مختلفين يغطيان نفس المادة المضمونية. ويتعلق الأمر بالحالة التي يطلق عليه “الأكسيولوجيا” وهي نشاط يقوم بتنظيم أو وصف القيم في مستوى تجريدي عام، وهذا المستوى يتميز بانفصاله التام عن أي سياق. إن الأكسيولوجيا، تبعا لهذا التحديد، عملية يتم فيها الإمساك بالكون الدلالي عبر حدود تنظيمية تلتقط الوجود الإنساني عبر مفاصله المضمونية الكبرى. وتشكل الأيديولوجيا (11)، في المقابل، الوجه المشخص لهذه القيم، أوالتجسيد الفعلي للمادة المضمونية داخل حدود زمنية/فضائية تمنح القيم لونا وطعما وخصوصية. إن التشخيص هنا هو إدراج القيم المجردة ضمن سياقات خاصة. فالفعل الخاص يحتاج إلى سياق خاص يميزه ويستمد منه فرادته.
وفي الحالتين معا يمكن، استنادا إلى تقسيم افتراضي للعالم الإنساني، أن نقدم هذا العالم :
1- إما على شكل قيم مجردة مثل : الصدق والأمانة والكذب والخيانة…
2- وإما على شكل صفات مثل : العامل الطبيب والفلاح والطالب والأستاذ …
3- وإما على شكل أفعال مثل : سافر وضرب وأكل…
وإذا كان النمط الأول من الوجود لا يثير اهتمامنا، أو على الأقل، لا يشكل موضوعا ملائما للدرس ( فنحن لا نسقط فرضيات تخص مواد مضمونية لا نعرف عنها أي شيء، وإنما نسائل أشكالا خاصة للتحقق )، فإن الطريقة التي تتحقق بها هذه القيم هو ما يشكل المدخل الرئيس نحو فهم ما أطلقنا عليه من قبل “الطبيعة الأيديولوجية للمعنى”، أو الميكانيزمات التي ينتج عبرها المعنى و”ينحاز” إلى جهة بعينها ويتحول إلى” حكم”و” تبرير” و”تصنيف”. فأي متلقي يستند، في تقييمه للكون الإنساني، إلى الماركسية لا يمكن أن يقبل بمقولة “الخير”، فهي في نظره ليست مقولة إجرائية قابلة للاستثمار في تحليل الفوارق الطبقية. فالخير في تصوره مقولة ذات حمولة دينية تقوم، رغم كل النوايا الحسنة، بالاعتراف بوجود تفاوت طبقي يجب قبوله باعتباره حالة معطاة خارج حدود الزمن الإنساني. وفي هذه الحالة، فإن ما هو مرفوض في تصور هذا الشخص، ليس مضمون المقولة في ذاتها ( الخير باعتباره مضمونا ساميا بالمطلق)، بل أحد أشكال تحققها، أي النسق الذي يمنحها خصوصية التحقق.
وعلى هذا الأساس، وبما أن السيرورة التدليلية ( ما يطلق عليه بورس السميوزيس ) لا يمكن حصرها ضمن حدود بعينها ( يعتقد إمبرتو إيكو أن السميوزيس لامتناهية نظريا ولكنها في الممارسة محدودة، فالخطاب -الذي هو من طبيعة المتحقق – يقلص من حجمها وامتدادها ويضع لها حدودا)، فإن أية عملية إنجازية تروم بناء كون مستقل سيُنظر إليها باعتبارها انتقاء خاصا لجزئية دلالية تمتلك دلالتها من سياقها الخاص، فهو الذي يحدد لها موقعها ضمن محيطها المباشر، وهو الذي يحفظ لها، في الآن نفسه، روابطها مع المادة المشتقة منها. إن هذا السياق الخاص هو ما يجعلها قادرة على خلق معرفة جديدة. > فعالم السميوزيس عالم دائم التطور. وافتراض بنيات لهذا العالم لا يعني القول إنه عالم قار وثابت. إن الأمر يتعلق فقط بالتعرف على الميكانيزمات البنيوية التي تحكم تحولاته<. (12)
إن هذه المعرفة الجديدة تتسلل خلسة إلى جميع مناحي الفعل الإنساني من خلال إحداث قطيعة مع الأسنن القديمة، أي التحققات السابقة وتقوم بزحزحتها من مواقعها لإرساء مواقع جديدة. والأمر يتعلق بطريقة أخرى للقول إن المبدع لا يخلق القيم ولكنه يخلق أشكالا جديدة للتحقق. إنه يضيف أبعادا ويقصي أخرى من خلال إعادة تنظيم هذه القيم وفق الاستراتيجية التي تمليها الأنساق التي يستند إليها في تحقيق هذه القيم. إن الأمر يتعلق باستراتيجية الإنتقاء القيمي الذي يقود إلى تحديد طبيعة الكون الدلالي للنص. وتتحدد استراتيجية الانتقاء هاته من خلال عمليتين :
– تناظر أو تناظرات دلالية تشتغل كضبط ذاتي للكون الذي تحيل عليه الواقعة. فالانتقاء ليس تحديدا ذاتيا، بل هو إجراء يتم وفق استراتيجية تهدف إلى بناء كون دلالي منسجم وقابل للاشتغال من خلال حدوده الخاصة.
– العناصر المستعملة لتسييج الوضعية الإنسانية التي يتم تمثيلها داخل النص. فالاستراتيجية ليست اختيارا دلاليا، أي تحديدا مضمونيا، بل هي نمط في البناء. ولهذا لا يمكن الفصل بين البناء وبين الأداة البانية.
ويجب النظر إلى هذه الاستراتيجية باعتبارها طريقة خاصة في تنظيم المعنى. وتنظيم المعنى في طبقات هو ما يحدد الطبيعة “الإديولوجية للمعنى” . وبناء عليه، فإن الأيديولوجيا، كما يوضح ذلك إليزيو فيرون ( Eliseo Veron) > ليست سجلا لمضامين ( “الإرادة ” و”المواقف” أو حتى ” التمثيلات” )، بل هي قواعد ( grammaire) لتوليد المعنى، أي استثمار للمعنى في مواد دالة. ولا يمكن تبعا لذلك تحديدها من خلال المضامين <. (13)
إن طريقة التوليد هاته تفترض أصلا أو مادة تشكل منطلق بناء النص. وبعبارة أخرى يجب التحول من النظام القيمي العام إلى التحقق الخاص. ذلك أن > علاقة الايديولوجيا بإنتاج المعنى هي من نفس طبيعة العلاقة الرابطة بين اللسان وإنتاج الكلام، كما يتصور ذلك تشومسكي على سبيل المثال : يجب التوفر على أدوات لوصف نسق تام ( قابل للضبط) من قواعد التوليد من أجل الإمساك بعملية إنتاج المعنى التي تعد من جهتها لا متناهية < (14)
إن الايديولوجيا على هذا الأساس هي سلسلة من القواعد التي تتحكم في الصيغة التي يتم بها تحيين القيم. فخارج السياق لا تشكل القيمة الدلالية سوى تعيين لحالة وجدانية عامة يغيب فيها أي تقويم ذاتي. وبما أن الوقائع ليست سوى وضعيات إنسانية متراكبة ومترابطة فيما بينها، وجب النظر إلى هذه الوقائع باعتبارها تجسيدا مشخصا للقيم.
إن اختراق المتصل – وهذا الاختراق هو الشرط الضروري لإنتاج العلامة وتداولها – مرتبط باستراتيجية ( معترف بها صراحة أو موجودة ضمنيا ). فكل كون نصي إنما هو اقتطاع لجزئية من نسق دلالي شامل يغطي الفضاء الإنساني المحلي أو الكوني، وتقديمها على أساس أنها تشكل كونا مصغرا يحتوي على جهة نظر تخص هذا النسق الدلالي. إن الأمر يتعلق بالتقليص، والتقليص هو انتقاء، والانتقاء هو اختيار إيديولوجي، أي انحياز إلى تحقق على حساب تحققات أخرى ممكنة. ذلك أن انتقاء واقعة ما من أجل تنظيم وتداول كون دلالي ما محدود في الوجود أمر محكوم بتصور مسبق يجعل من هذه الواقعة عنصرا داخل جهاز ثقافي يحدد، استقبالا، كل ممكنات التدليل داخلها. إن هذه العمليات المتتالية والمترابطة فيما بينها تقود إلى التصرف في المادة الممثلة (المادة الحكائية مثلا ) بما يضمن وجود بناء منسجم ومكتف بنفسه، وهذا يقتضي القيام باختيارات داخل هذه المادة الممثلة. وضمن هذه الاختيارات تتحدد الطبيعة الإيديولوجية للمعنى، أي الطريقة التي تنظم عبرها الوحدات الدلالية.
——————————————-
الهوامش
1- يسوق لالاند ( A . Lalande) في قاموسه جملة تعاريف لمفهوم المحايثة (immanence)، أهمها التعريف الذي يقدمه م . بلونديل حيث تعين “المحايثة لديه، من زاوية ستاتيكية، كل ما هو موجود في كيان ما بشكل ثابت وقار؛ وتعين، من زاوية ديناميكية، كل ما يصدر عن كائن ما تعبيرا عن طبيعته الأصلية”. فما هو محايث لكائن ما يعود إلى كل ما هو موجود داخل هذه الكائنات وليس حصيلة لشيء خارجها. وإلى هذا الأساس الفلسفي نستند في تحديدنا لميكانيزمات اشتغال الدلالة. فإذا كانت الدلالة لا تعبأ بالمادة الحاملة لها، فإن ذلك معناه أن هناك محورا دلاليا ( محايثا ) يتحدد من خلال ثنائيات توجد خارج التحقق، ويعد هذا المحور المادة المغذية لكل أشكال التحقق. من هنا كان الحديث عن المحايثة والتجلي باعتبارهما يغطيان نمطين للوجود في حياة الدلالة : المادة المضمونية العديمة الشكل والاشكال المتحققة الخاصة.
2- Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, Tome 2 p 59
3- نفسه ص 59
4- Henri Focillon : Vie des formes , P U F , 3 édition 1983 , p 2
5- نفسه ص 3
6- Eliseo Veron : Sémiosis de l’idéologie et du pouvoir , in Communications 28 , 1978 , p 12
7 – du sens, Seuil , 1970, p 140 Greimas:
8- Umberto Eco : Interprétation et surinterprétation, ed. P U F , 1996, p 39
9- يتحدث بورس، في معرض حديثه عن الموضوع ( ما يشكل طرف الإحالة المرجعية داخل العلامة )، عن “موضوع مباشر” معطى بطريقة مباشرة داخل العلامة، وعن “موضوع ديناميكي” يعد حصيلة سيرورة سميائية سابقة. ويطلق على هذه السيرورة “التجربة الضمنية” التي تحيل عليها العلامة بشكل غير مباشر.
10- Du Sens. p .161 Greimas:
11-انظر Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage , article Axiologie
12- Le signe, p .133 Umberto Eco:
13- Eliseo Veron : Sémiosis de l’idéologie et du pouvoir , in Communications 28 , 1978 , p .15
14- Eliseo Veron : Sémiosis de l’idéologie et du pouvoir , in Communications 28 , 1978 , p. 15